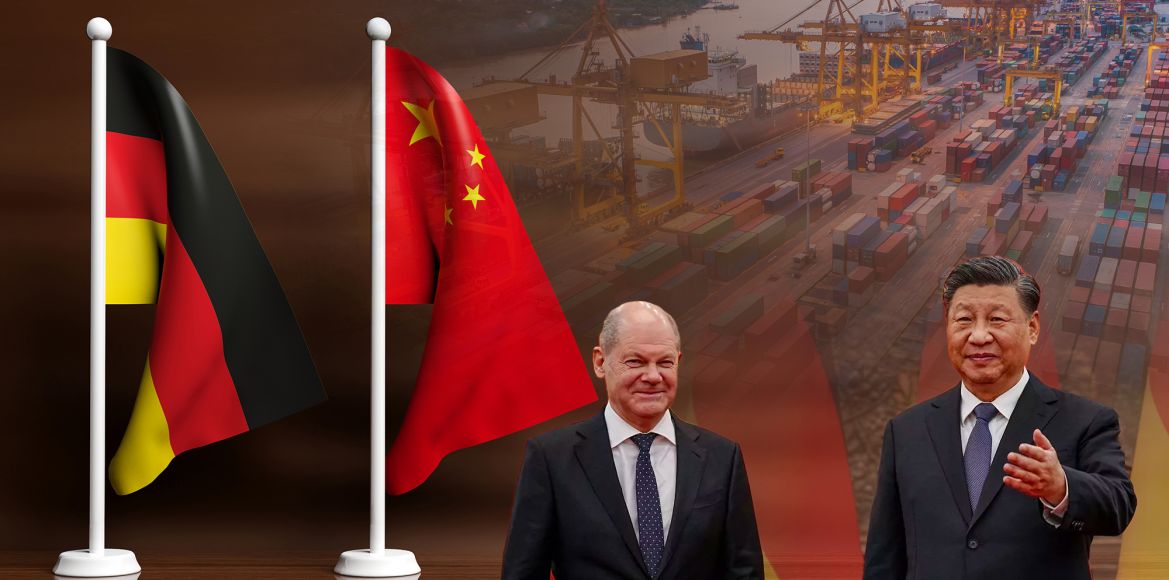مقدمة
تاريخيًا، تمتعت ألمانيا، مقارنة بسائر أعضاء الاتحاد الأوروبي، بالعلاقات القوية مع الصين، التي شكلت على مدى عقود سوقًا مربحًا للاقتصاد الألماني. وقد ارتقت العلاقات بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية؛ مما بوأ الصين مرتبة الشريك التجاري الأول لألمانيا منذ 2016 وللسنة السابعة على التوالي (إحصاءات 2022). وكانت السياسة الألمانية تجاه الصين، مثل السياسة الألمانية تجاه روسيا وتركيا، تستند بالأساس إلى مبدأ “التغيير من خلال التجارة” Wandel durch Handel، الذي تطور بداية في ألمانيا الغربية كاستراتيجية لإعادة التوحيد وسد الفجوة مع ألمانيا الشرقية، قبل أن يتطوّر إلى مقاربة تؤطر سياسة برلين الخارجية، من منطلق أن التبادل الاقتصادي لن يعزز مسارات التنمية فقط، وإنما سيؤدي إلى تعزيز القيم الديمقراطية وسيادة القانون.
بيد أن التوترات الجيوسياسية الحالية، وخاصة الحرب الروسية-الأوكرانية، التي شكلت نقطة التحول في السياسة الخارجية الألمانية، بحكم ما تطرحه من تحديات على كافة المستويات الأمنية والجيو-سياسية والاقتصادية، دفعت صناع القرار الألمان إلى إعادة التفكير في سياستهم الخارجية، بما في ذلك سياستهم الصينية. تعمد هذه الورقة إلى اختبار نمط التغير في السياسة الألمانية تجاه الصين في ضوء المتغيرات الجيوسياسية الجديدة.
ومن أجل معالجة هذه المشكلة البحثية، يتم توظيف مفهوم “المنافسة النظامية” Systemic Rivalry، الذّي أصبح مفهومًا شائع الاستعمال في السنوات الأخيرة في الخطاب السياسي الغربي لوصف صعود الصين وتأثيرها على السياسة العالمية ومستقبل النظام الدولي. ويُقصد بـ” المنافسة النظامية” أن الصين ليست مجرّد منافس اقتصادي وعسكري للغرب، وإنما تقدم نفسها أيضًا كنموذج بديل للمجتمع الدولي الذي نشأ بعد الحرب الباردة، والاقتصاد الرأسمالي والمجتمع الليبرالي.
1. إدارة ميركل (2005-2021) ونهج التغيير من خلال التجارة:
كانت السياسة الألمانية تجاه الصين محكومة بالأساس بنهج “السياسة الشرقية” Ostpolitik، التي اشتهرت في الأوساط الألمانية وتحديدًا مع الديمقراطيين الاشتراكيين، والتي تجد أصولها النظرية في مقاربة “التغيير من خلال التقارب” Wandel durch Annahurung، التي صاغها المستشار ويلي براندت في سبعينيات القرن الماضي، كآلية لإذابة الخلافات بين الألمانيتين الغربية والشرقية، ونسج الروابط الاقتصادية والثقافية فيما بينهما، كمقدمة لإعادة التوحيد السياسي، والذي تحقق فعليًا سنة 1990؛ ما خلق واقعًا جديدًا في السياسة الدولية، سمح لألمانيا أن تكون القوة الديمغرافية والاقتصادية رقم واحد داخل الاتحاد الأوروبي، وإمبراطورية الصادرات على المستوى العالمي. وفي أعقاب ذلك، عمل صناع القرار الألمان على تطوير نهج براندت وحولوه إلى استراتيجية “التغيير من خلال التجارة”.
على هذا النحو، بعد نهاية الحرب الباردة، ساد الاعتقاد بأن “الجيواقتصاد” قد حل محل “الجيوبوليتكس”، وأن الاعتماد الاقتصادي المتبادل سيجعل الحرب قد عفا عليها الزمن. وبناء عليه، رسمت ألمانيا منذ أيام غيرهارد شرودر (1998-2005) سياسة خاصة في علاقتها مع الصين، قائمة على التعاون بدلًا من المواجهة، وعمودها الفقري هو نهج التغيير عن طريق التجارة، حيث آمن شرودر بأهمية الترابط الاقتصادي كآلية للدفع نحو تغيير مجتمعي ناعم، وتصدير القيم الديمقراطية. طورت ألمانيا كذلك فكرة “مجتمع المسؤولية” في علاقاتها مع بكين؛ فالنمو الاقتصادي في الصين سيقود الأخيرة إلى “واحد من أصحاب المصلحة المسؤولين”. وبخصوص حقوق الإنسان، فقد آمنت ألمانيا بفضائل التغيير التدريجي والناعم عن طريق حلقات الحوار حول سيادة القانون التي دشنها شرودر عام 1999 كآلية تقوم على التواصل المستمر بدلًا من الإجراءات العقابية، والتركيز على قضايا مثل القانون التجاري الذي قد يكون الصينيون أكثر استعدادًا لمناقشته.
كانت هذه هي المقاربة العامة للسياسة الألمانية تجاه الصين، ولم تشكل إدارة المستشارة ميركل استثناءً أو خروجًا عن القاعدة، إذ ظلت المستشارة التي بصمت السياسة الألمانية والدبلوماسية الأوروبية لحوالي عقدين من الزمن تؤكد على أهمية الحفاظ على علاقات جيدة بين الغرب والشرق تحت تأثير تجاربها التكوينية (العيش في ألمانيا الشرقية). وعليه، اتخذت المستشارة ميركل (2005-2021) كسلفها شرودر نهجًا أساسيًا في علاقاتها مع الصين، قائمًا بالأساس على تعظيم المنفعة الاقتصادية كأولوية في سياستها الخارجية.
ومع ذلك، ثمة بعض الاختلاف من حيث البدايات. فبينما دافعت إدارة شرودر عن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية (2001)، ودافعت عن أهمية إنهاء اتفاقية حظر الأسلحة إلى الصين (وإن لم تنجح في تغيير موقف الاتحاد الأوروبي)، فقد شهدت سنوات ميركل الأولى في المستشارية تركيزًا أكبر على حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، جاءت دعوة ميركل للزعيم الروحي للتبت الديلي لاما (2007)، على الرغم من احتجاجات بكين التي استدعت السفير الألماني، حيث اعتبر المتحدث باسم الخارجية الصينية أن الديلي لاما متورط في أنشطة ضد الوحدة الداخلية؛ ما تسبب في توتر العلاقات بين الجانبين، ودفع الصين لتعليق اتصالاتها الدبلوماسية مع ألمانيا لمدة نصف عام. وفي الواقع، أثارت رد الفعل الصينية هذه مخاوف قطاع الأعمال في ألمانيا، الذي مارس ضغطًا على الحكومة لتخفيف لهجتها بخصوص ملف حقوق الإنسان، مما حدا بوزير الخارجية آنئذ فرانك شتاينماير للتحرّك دبلوماسيًا، بإرسال رسالة سرية إلى الصين يقر فيها بأن هضبة التبت أرض صينية، وقد جرى استقبال الرسالة في بكين باستحسان، مما سمح بإذابة جليد العلاقات وإعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية على نحو وثيق.
شكّلت التجربة الألمانية مصدر إلهام بالنسبة للصين، التي نظر قادتها إلى ألمانيا باعتبارها الدولة المؤهَلة أكثر للاستناد إليها بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتحديث الاقتصادي، والتي تعمل في مرحلتين مستقلتين، لكنهما مترابطتان. تقتضي المرحلة الأولى الترحيب بالشركات الأجنبية لتسهيل عملية تكوين الرأس مال الوطني، وأيضًا تعزيز التقدم التكنولوجي، والمساهمة في إصلاح السوق الصينية؛ فيما تتوخى المرحلة الثانية المكنية باستراتيجية الخروج، الوصول إلى الأسواق الخارجية وزيادة الاستثمارات الصينية في الخارج في المنشآت الحيوية والبنية التحتية والاتصالات، لزيادة النمو الاقتصادي والاستقرار. ولعبت أزمة منطقة اليورو (2009-2012) واستمرار الاقتصاد الصيني في النمو، الذي وفر دعمًا حيويًا لأكبر شركاتها الصناعية، دورًا كبيرًا في الدفع بهذا الاتجاه (تقارب ألماني-صيني) في إطار رابح – رابح. فبينما – والحالة هذه – وجدت ألمانيا في السوق الصينية الواسعة متنفسًا لحالة الركود الاقتصادي، فإن أزمة منطقة اليورو أدت كذلك إلى زيادة التركيز الصيني على ألمانيا. فمن وجهة نظر قادة بكين، كان هناك تطوران على المدى الطويل: زيادة الهيمنة الألمانية داخل الاتحاد الأوروبي، وزيادة اعتماد ألمانيا على الصين؛ ما حدا بالقادة الصينيين إلى العمل بقاعدة مفادها: إذا أردتَّ الوصول إلى بروكسل (الاتحاد الأوروبي) فاتجه إلى برلين أولًا.
عمومًا، على الرغم من اختلاف الثقافة السياسية بين الدولتين، تشترك ألمانيا والصين فيما يتعلق بإصلاح الأسواق المالية والحوكمة الاقتصادية؛ ما حدا بالاقتصادي مارتن وولف إلى إطلاق لفظة “Chermany” لوصف الانصهار المفترض بين الاقتصادين الألماني والصيني، قائلًا: “إن الصين وألمانيا تختلفان تمامًا عن بعضهما البعض، لكن برغم كل الاختلافات فإنهما يشتركان في بعض الخصائص: إنهما أكبر مُصدَّري المصنوعات، ولهما فوائض هائلة في الادخار على الاستثمار، ولديهما فوائض تجارية مهمة… وكلتاهما -ألمانيا الصين- تتفقان أن على عملائهما الاستمرار في الشراء، لكن التوقف عن الاقتراض غير المسؤول”. ومع ذلك، فمن مصلحة صناع القرار الألمان تبديد فكرة أن برلين تسير بمفردها في سياستها الصينية؛ مما جعل برلين حريصة على تطوير نهج استراتيجي أوروبي تجاه الصين، لكن جهودها لتطوير شراكة استراتيجية أوروبية مع الصين باءت بالفشل، وهو ما دفع المسؤولين الألمان من منطلق المصلحة الخاصة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الأحادية الجانب، ومنها إطلاق “الشراكة الاستراتيجية” الصينية -الألمانية سنة 2011، والتي فتحت آفاقًا جديدة ازدهرت خلالها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وبجانب المنفعة الاقتصادية للعلاقات مع الصين، ترى برلين أنّ التحديات العالمية المطروحة اليوم (كتغير المناخ، والسِّلم، والأمن الغذائي، …) لا يمكن التغلب عليها إلا بالعمل معًا.
وهكذا، جرى إنشاء اللجنة الاستشارية الصينية-الألمانية للاقتصاد (2014)، والذي تلاه اجتماع وزاري ألماني صيني رفيع المستوى بالعاصمة برلين في أكتوبر من السنة ذاتها، وبجانب نمو التبادل التجاري بين ألمانيا والصين بمعدل سنوي يقدر بين 6 و7%، فقد تم تحديد العام 2015 “عام الابتكار” الصيني-الألماني. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بضغط الصين لانتزاع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، لموازنتها باتفاق التبادل التجاري عبر الأطلسي Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP)، اختارت ألمانيا المماطلة ثم رفض طلب بكين. في الواقع، لا ينفي بعض المراقبين أن يكون هذا الامتناع تحت تأثير القوة المهيمنة (الولايات المتحدة)، التي بدأت ترى في تحركات الصين جنوب شرقي آسيا وبحر الصين الجنوبي تهديدًا لمصالحها الحيوية، كما أوضحت ذلك استراتيجية الأمن القومي لإدارة الرئيس باراك أوباما، التي بدأت تحوّل أنظارها بعيدًا عن أوروبا والشرق الأوسط، وتركز أكثر على جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي. غير أن ألمانيا، التي عانت ويلات الانقسام أثناء الحرب الباردة، أبعد من الانجرار وراء أي تدافعات قطبية جديدة تذكي الصراع بين القوتين، وبدلًا من ذلك فإن البحث عن تفاهمات ثنائية وإبقاء منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي بعيدة عن الصراعات، ومفتوحة أمام المشاركة والتجارة الأوروبية، يشكل أولوية لسياستها الخارجية.
وبرغم سنوات ميركل الأولى التي أعطت لملف حقوق الإنسان اهتمامًا أكبر، فإن سياسة برلين تجاه بكين تحت إدارتها إجمالًا كانت محكومة بالدرجة الأولى بتقاليد الواقعية الاقتصادية، أي تعظيم الربح ومراكمة الثروة، والتغاضي عن القيم في علاقاتها بالصين (على سبيل المثال: حقوق الإنسان لا يتم التطرق لها إلا بشكل عابر)، حيث ترى ميركل أن العلاقة مع الصين يجب أن تكون وظيفية، ومفتاحًا للحفاظ على صوت الاتحاد الأوروبي مسموعًا وأكثر قوة واستقلالية عن السياسة الأمريكية، خاصة في ظل إدارة ترامب. صحيح أن ألمانيا تدين لعقود للهيمنة الأمريكية والنظام الدولي الليبرالي القائم على القواعد. ومع ذلك، فإن ازدهارها الاقتصادي اليوم يعتمد أكثر على الصين، التي ساعدت ألمانيا على تجاوز الأزمة المالية العالمية، وإعادة تأكيد هيمنتها الاقتصادية في منطقة اليورو. وفي هذا الصدد، تساعد إحصائيات التجارة الألمانية-الصينية على تأكيد هذا الاتجاه، فمنذ العام 2016 فصعودًا، أخذت الصين مكان الولايات المتحدة، وأصبحت أهم شريك تجاري لألمانيا ولا تزال؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وألمانيا أكثر من 298 مليار يورو عام 2022.
وعلى الرغم من قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، فإن المخاوف في ألمانيا بخصوص هذه الشراكة الاستراتيجية بدأت تتصاعد حتى في ظل إدارة ميركل، وتحديدًا مع إحكام الرئيس شي جين بينغ قبضته على السلطة في الصين، والذي دفع باتجاه سيطرة أكبر للدولة على الاقتصاد، خاصة مع إطلاق استراتيجية شي “صنع في الصين 2025″، الهادفة إلى تحويل الصين إلى “مصنع للعالم” وجعل سلاسل التوريد ترتكز على الصين، بتحقيق الريادة في عشرة قطاعات صناعية مهمة، من ضمنها تكنولوجيا المعلومات (الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، …) وصناعة الروبوتات، والطاقات المتجددة، والطيران، والطب والمعدات الطبية، …إلخ.
وعليه، فبعد أن تغاضت ألمانيا لسنوات عن انتقاد الصين، سحبت الخارجية الألمانية موافقتها السابقة على استحواذ الصين على الشركة الألمانية Aixtron SE من قبل شركة صينية مملوكة للدولة، وهو ما بعث برسالة شديدة اللهجة إلى بكين. كما أن نبرة اتحاد الصناعات الألمانية، كمجموعة ضغط مؤثرة هي الأخرى قد تغيرت، واصفة الصين لأول مرة في تقرير خاص (يناير 2019)، بأنها “منافس نظامي” Systemic Rival، وحثت بروكسل على تنسيق الجهود ووضع مقاربة جديدة لمواجهة رأسمالية الدولة التي تقودها بكين. هذا الموقف تجاه الصين اتسع ليشمل المفوضية الأوروبية، أيضًا، والتي وصفت الصين في مارس من ذات السنة بأنها “منافس نظامي”، بيد أن ألمانيا التي كانت تستعد لرئاسة المفوضية الأوروبية (2020) وفي ظل استمرار ميركل في المستشارية، أرادت تحويل التركيز من مواجهة الصين إلى التعاون معها، كما يؤشر على ذلك تحركات إدارة ميركل التي وضعت خططًا للجمع بين الرئيس الصيني شي والقادة الأوروبيين بلايبزيج، بيد أن الجائحة وسياسات شي أحبطت محاولات ميركل (إلغاء قمة لايبزيج).
صفوة القول، اتسم نهج ميركل بكثير من البراغماتية، واختارت السير في “طريق وسط” وتجنب تصادم المصالح مع الصين ما أمكن، حتى في ذروة المنافسة بين حليفتها التقليدية الولايات المتحدة والصين، خصوصًا مع عودة الديمقراطيين إلى السلطة في البيت الأبيض بقيادة جو بايدن، الذي ارتكزت استراتيجيته للأمن القومي على احتواء الصين. هكذا، ومع عدم وجود أي بدائل واقعية حافظت ميركل على وفائها لنهج “التغيير من خلال التجارة”، مما حدا بعض المراقبين إلى وصف سياستها الخارجية أنها مدفوعة تجاريًا، ولا أدل على ذلك من سعيها الحثيث لتوقيع اتفاقية استثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، على الرغم من محاولات الصين الهيمنة اقتصاديًا، وتسترها على أزمة كوفيد-19، وسِجل الصين بخصوص حقوق الإنسان.
2. الصين كـ “منافس نظامي”: مدى التغير في سياسة ألمانيا الصينية
على مدى عقود، في ألمانيا، وبغض النظر عن الحزب الممسك بالسلطة: الاشتراكيون الديمقراطيون أو الديمقراطيون المسيحيون، فقد سعى قادة كلا الحزبين (شرودر وميركل) باستمرار إلى تأسيس علاقات وثيقة مع الصين في إطار السياسة الشرقية Ostpolitik، مسترشدة باعتقاد ليبرالي كلاسيكي مفاده أن الاندماج في الاقتصاد العالمي سيجعل الحرب عفا عليها الزمن، وسيؤدي تدريجيًا إلى الازدهار والسلام، وسيادة الليبرالية السياسية ومجتمع القانون. وضمن هذا المدار، تشكلت العلاقات الألمانية-الصينية، ونمت الشراكة الاقتصادية بينهما بشكل كبير في العقد الماضي، ولا أدل على ذلك من كون الصين تعتبر للسنة السابعة على التوالي أكبر شريك تجاري لألمانيا، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بينهما 298 مليار يورو، بحسب بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء (Destatis)، تليها الولايات المتحدة، وهولندا. ومع ذلك، فبعد ما كان يُنظر إلى هذه العلاقة كشراكة استراتيجية في إطار رابح – رابح لعشرات السنين، بدأت المخاوف تساور صنّاع القرار في برلين بحكم العجز التجاري المتزايد مع الصين، والذي وصل إلى أعلى مستوياته في عام 2021 (39.4 مليار يورو)؛ ما يفرض على القادة الألمان إعادة التفكير في سياستهم الخارجية إزاء الصين.
وبناءً عليه، شكل إعادة صياغة السياسة الصينية إحدى أولويات برلين الخارجية مع تشكيل الحكومة الجديدة، أو ما يعرف بـ “ائتلاف إشارات المرور” في أواخر عام 2021، بقيادة المستشار أولاف شولتس. وفي الواقع، من شأن أي تغيير في الاستراتيجية الألمانية أن يعود بالفائدة على كل ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وأن يدفع باتجاه صياغة استراتيجية أوروبية موحدة. وعلى الجانب الآخر، كان الرئيس الصيني شي حريصًا على تهنئة المستشار الجديد، معلّقا أهمية كبيرة على تنمية العلاقات الصينية الألمانية. وإذا علمنا أن بكين نادرًا ما تهتم بانتخاب الزعماء الغربيين، فإنّه على عكس ذلك كان انتقال السلطة في برلين في طليعة اهتمام قادة الصين؛ لثلاثة أسباب رئيسية: أولًا، تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا. ثانيًا، لتحقيق استراتيجية “صنع في الصين” تحتاج الصين إلى ألمانيا لمساعدتها في تسريع وتوطين التجديد التكنولوجي وفي الصناعات التحويلية. ثالثًا، تحتاج بكين إلى برلين أيضًا من الناحية الدبلوماسية؛ فلطالما شكلت سياسة ألمانيا تجاه الصين سياسة الاتحاد الأوروبي أو أثرت فيها على أقل تقدير.
تعد اتفاقية الائتلاف الحكومي (ديسمبر 2021) في ألمانيا بمثابة خريطة طريق ومخطط مركزي للعمل الحكومي خلال السنوات الأربع القادمة، وتؤشر على بداية سياسة جديدة إزاء الصين، تَعِدُ بالتغيير من حيث المقاربة، إذ نصّ الميثاق على تبني سياسة خارجية قائمة على القيم؛ ما يفيد الالتزام بالتعددية والعمل سويًا مع الشركاء الديمقراطيين لرعاية السلام، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والاستدامة، والتي تشكل ثوابت لسياسة خارجية ذات مصداقية، في عالم يتسم بانعدام الأمن وتنامي التوترات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، نصّ الاتفاق الحكومي على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه بكين، على الرغم من أن الاتفاق دعم استمرار التعاون والتجارة مع الصين، ولكن جعله فقط “حيثما أمكن”، واصفًا الصين لا باعتبارها فقط “شريكًا”، ولكن أيضًا “منافسًا” و”منافسًا نظاميًا” بالأساس؛ ما يقتضي تطوير استراتيجية شاملة للتعامل معها، وسَنّ مزيد من التشريعات التي تشدّد على السيادة الاستراتيجية الأوروبية فيما يتصل بأمن التكنولوجيا، والمنشآت الحيوية. والواقع أن تأكيد اتفاقية الائتلاف الحكومي على تبنِّي سياسة خارجية قائمة على “القيم” يبعث بمؤشرات على أن مسألة حقوق الإنسان ستتخذ حيزًا أكبر كمبادئ مؤطِّرة لسلوكها الخارجي إزاء الصين، والشيء نفسه بخصوص احترام القانون الدولي وتسوية النزاعات، حيث أشارت الوثيقة إلى أن التوتر المتصاعد في بحر الصين الجنوبي، ومضيق تايوان لا يمكن تغييره إلا بالوسائل السلمية وبموافقة الطرفين.
إجمالًا، هناك تباين في وجهات النظر داخل الائتلاف الحكومي، وتحديدًا بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) المؤيد للخط العملي لسلفه ميركل بخصوص دعم اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين، وبين حزب الخضر (GP) والليبراليين الديمقراطيين (LPD) الذين أكدوا تبنّي سياسة خارجية قائمة على القيم، وانتقادًا أكبر لسياسات الصين، وعلى الجانب الآخر، ثمة اختلاف تقديرات بين الوزارات بخصوص الصين: فبينما ترى وزارة الشؤون الاقتصادية والمناخ في التعاون مع الصين مصلحة لمواجهة تحديات كتعزيز النمو والتغير المناخي…؛ تنظر وزارة التعاون والتنمية إلى الصين كمنافس فيما يتعلق بالمشاريع الإنمائية في بلدان ثالثة، أما وزارة الداخلية فتنظر بشكل متزايد إلى الصين عبر عدسة التهديد الهجين (الهجمات السيبرانية).
بيد أن الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة في الآونة الأخيرة، سواء في بحر الصين الجنوبي أو في أوكرانيا، ولاسيما الحرب الروسية-الأوكرانية، أدت إلى نقطة تحول Zeitenwende في سياسة برلين الخارجية، بحسب المستشار أولاف شولتس، بعد أن بدّدت الحرب أوهام برلين للتغيير عن طريق التجارة، حيث كان لها انعكاس غير مباشر ليس فقط على علاقات برلين مع موسكو، ولكن إزاء علاقتها مع بكين أيضًا. وفيما يُعزى هذا بالأساس، بحسب الخبير الاقتصادي زهو ينغ، إلى الربط الغربي في السنوات الأخيرة بين الصين وروسيا معًا في مناقشة الشؤون الدولية، إذ تنظر الدول الغربية على نحو متزايد إلى استراتيجية الصين للانفتاح (الحزام والطريق، ومنظمة شنغهاي للتعاون…) على أنها تشكل تحديًا للنظام الدولي القائم على القواعد. كما أن أزمة الطاقة الأوروبية، وتحديدًا الغاز، كشفت عن ضرورة التنويع الذكي لسلاسل التوريد لتفادي مزالق التبعية الاقتصادية الأحادية الجانب؛ ما يفرض على القادة الألمان في سياستهم الصينية تقليل التبعية “القاتلة” فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية والضرورية لصناعة التقنيات المتطورة، وأشباه الموصِّلات، بسنّ استراتيجية قوامها تنويع سلاسل التوريد وتوسيع قائمة الموردين المحتملين في آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا وأمريكا الجنوبية… وهي حقيقة تكاد تكون بادية يؤشر عليها بوضوح عجز الميزان التجاري الألماني أمام الصين.
وعلى هذا النحو، يعكس تصريح وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، روبرت هابيك، اتجاه السياسة الجديدة التي تنبني على القيم كمبادئ مؤطِّرة لسلوك برلين الخارجي إزاء الصين، إذ اعتبر هابيك قضية حقوق الإنسان، التي تم تجاهلها لسنوات تحت إدارتي شرودر وميركل، نقطة سوداء تعيق علاقات ألمانيا مع أكبر شركائها التجاريين؛ الصين، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي بخصوص الانتهاكات الصينية لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور. كما أشار هابيك إلى أهمية تنويع الشركاء التجاريين، ونهج مزيد من الحمائية في وجه استراتيجية الانفتاح الصينية، عبر فحص الاستثمارات وعروض الاستحواذ الصينية في ألمانيا عن كثب، منوّها بمنع الحكومة الاتحادية محاولات الصين الاستحواذ على بعض شركات الرعاية الصحية وأشباه الموصِّلات.
وفيما أثبتت الاستجابة الألمانية للغزو الروسي لأوكرانيا تماسك حلف الناتو، ومتانة الروابط عبر الأطلسي، فالتساؤل يظلّ قائمًا حول ما إذا كان تغير السياسة الألمانية إزاء الصين مقدمة لما هو أبعد أم لا؛ أي الاستجابة الألمانية لمخططات إدارة جو بايدن لاحتواء الصين، “الدولة الوحيدة التي لها نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، والقدرة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك”، بحسب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مايو 2022. ومن ثَمّ فقد أثارت حدود قدرة ألمانيا على اتخاذ إجراءات أكثر تشدّدًا في سياستها تجاه الصين جدلًا واسعًا، وقد حاجج نوربرت روتغن، عضو لجنة الخارجية في البرلمان، بأن دور ألمانيا أكبر من أن يتم تجاهله على الساحة الدولية، بما في ذلك الوضع في بحر الصين الجنوبي. لكن ألمانيا لا تريد حربًا باردة جديدة، ومن مصلحتها تذكير واشنطن بهذه الحقيقة بانتظام، وهو ما يظهر في إدانته لزيارة نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان، الذي اعتبره سلوكًا استفزازيًا غير مسؤول. في مقابل ذلك، وتحت تأثير دروس الحرب الأوكرانية، أدان روتغن سياسات ألمانيا التي لاتزال تعتمد على الصين اقتصاديًا بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه لم يعد ممكنًا إدارة السياسة التجارية دون اعتبارات جيواستراتيجية.
عطفًا على ذلك، فبينما كانت موافقة حكومة أولاف شولتس (أكتوبر 2022) على منح صفقة لشركة كوسكو (Cosco) الصينية المملوكة للدولة لامتلاك حصة جزئية في ميناء هامبورغ – قد أثارت مخاوف الشركاء الغربيين الذين اعتبروا القرار خطوة ألمانية إلى الوراء. بيد أن المعارضة القوية التي أبداها حزب الخضر، والديمقراطيون الأحرار، والذين قيدوا الصفقة في حدود 24% بعدما كانت محددة في 35%، بدّدت نسبيا هذه المخاوف، وبعثت بإشارات على أن برلين ماضية في استراتيجية أوسع تهدف إلى تقييد الاستثمارات الصينية، بحيث لا تتجاوز الربع مستقبلًا في البنية التحتية والمنشآت الحيوية الألمانية. والحالة هذه، على عكس ما قد توحي به حادثة تلك الصفقة، جادل ميلان بابيتش وآدم ديكسون، أن هذا لا ينفي تحولًا واضحًا في السياسة الألمانية نحو الحمائية ضد الاستثمارات التي تقودها الدولة في إطار استراتيجية الخروج الصينية.
لم تكد هذه المخاوف تهدأ بخصوص أيّ تراجع ألماني محتمل ضد تنسيق الاستراتيجية الغربية لاحتواء الصين، حتى عاودت الظهور، وتحديدًا مع الجولة الصينية التي قام بها المستشار أولاف شولتس إلى بكين (استغرقت 11 ساعة فقط يوم 4 نوفمبر 2022). وكانت هذه الجولة الأولى التي يقوم بها زعيم غربي، وأحد قادة مجموعة السبعة (G7) إلى الصين منذ تفشي جائحة كوفيد-19؛ ما أثار جدلًا واسعًا، حتى أن برينهارد بوتيكوفر (Reinhard Butikofer) عضو البرلمان الأوروبي وصف إيّاها بـ “الزيارة الأكثر إثارة للجدل على المستوى الداخلي خلال السنوات الخمسين الماضية”، في وقت تدعو فيه واشنطن والعديد من حلفائها الغربيين إلى استراتيجية أكثر تشدّدًا ضد محاولات الصين لإعادة تشكيل النظام الدولي؛ مما يطرح أكثر من سؤال بخصوص وقت الزيارة ودوافعها، وما إذا كانت جولة شولتس تؤشر على بلورة اتجاه جديد في سياسة برلين الخارجية تجاه الصين، أم هي عودة إلى نهج ميركل (الذي تعرض للانتقاد من قِبل الائتلاف الحكومي)، وماذا عن تداعيات هذه الزيارة على السياسة الأوروبية المشتركة والعلاقات عبر الأطلسي؟
جاءت زيارة المستشار شولتس في سياق خاص شهد إعادة انتخاب شي جين بينغ أمينًا عاما للحزب الشيوعي لولاية ثالثة (في المؤتمر العشرين للحزب)؛ ما يفيد ضمنيًا بقاءه في منصب الرئاسة لخمس سنوات أخرى قادمة. كما تؤشر مخرجات المؤتمر على تغير سياسة بكين الخارجية، على سبيل المثال، الالتزام بالماركسية اللينينية الذي احتل مساحة أكبر مما كان عليه في المؤتمرات السابقة، علاوة على سعي شي لجعل الابتكار والتصنيع العالمي وسلاسل التوريد متمركزة حول الصين، وبالتالي توظيف هذا الاعتماد لفرض تفضيلاتها في السياسة الدولية. وعلى الجانب الآخر، ثمة سياق دولي يتسم بزيادة التحديات في عالم يتغير على نحو جذري، بفعل الحرب الروسية-الأوكرانية وتداعياتها الإقليمية والدولية، والتي شكلت نقطة التحول الرئيسية. هكذا، وعلى غرار قادة الغرب الآخرين، الذين اختاروا قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإندونيسية بالي (أكتوبر 2022) للاجتماع مع قادة الصين، اختار أولاف شولتس التوجه إلى بكين للتحدث مباشرة مع شي بعد توقف دام ثلاث سنوات، موضّحًا في مقال رأي على بوليتيكو، أن رحلته تأتي بناء على عدة اعتبارات: أولًا، كون الصين اليوم ليست هي الصين قبل خمس أو عشر سنوات، ومع تغير الصين يجب أن تتغير الطريقة الألمانية للتعامل معها كذلك. ثانيًا، لم تتغير الصين وحدها ولكن العالم ككل تغير مع الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي جعل الأمن والسلام العالمي مهددًا، وبالتالي فمن مصلحة ألمانيا التي عانت تجربة الانقسام المؤلمة خلال الحرب الباردة العمل على عدم عودة تكتلات جديدة؛ ما يقتضي تعزيز الحوار والتعاون مع الصين، حيثما أمكن لا المواجهة. ثالثًا، تظلّ الصين بسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة وقوتها الاقتصادية شريكًا تجاريًا مهما لألمانيا والاتحاد الأوروبي، وليس من مصلحة الاقتصاد الألماني الانفصال عنها، لكن هذا لا يبرّر الهيمنة الصينية بتشديد اعتماد سلاسل الإنتاج الدولية على الصين، وبالتالي العمل لتعزيز المنافسة وتفكيك التبعيات الأحادية الجانب لصالح التنويع الذكي بوضع سلاسل التوريد على أساس أوسع. أخيرًا، الإقرار بأن العالم يتطور من خلال حركية الأضداد، وبالتالي الاعتراف ضمنيًا بأهمية المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، وأن الخلافات بينهما يجب أن تتم عبر الطرق السلمية وفي إطار القانون الدولي.
وعلى الرغم من تأكيد الائتلاف الحكومي أكثر من مرة أن القيم، وتحديدًا حقوق الإنسان ستكون شرطًا أساسيًا للتعامل مع الصين، فإن جولة شولتس الصينية ظلت نسبيًا وفية للنهج القديم، لكونها مدفوعة بالمصلحة الاقتصادية في تعاملها مع الصين. وهو ما يمكن تأكيده ببساطة من خلال طبيعة الوفد المرافق له، الذين وصفتهم مجلة الإيكونيميست بـ “12 مديرًا تنفيذيًا لشركات ألمانية كبرى، بما في ذلك رؤساء شركة Merck لصناعة الأدوية، وعملاق الهندسة Siemens، وفولكس فاجن، أكبر شركة عالمية لتصنيع السيارات…”، ممّا يؤشر حقيقة على الوفاء لشعار “الاقتصاد أولا”. وفي هذا السياق، صرّح شولتس بأن الصين قوة اقتصادية مندمجة في الاقتصاد العالمي، وتفكيكها أو فصلها عن هذا النظام سيكون مهمة معقدة وضارة للغاية، (على سبيل المثال، تستمد فولكس فاجن نصف أرباحها من السوق الصينية)؛ وبالتالي، فالهدف من الزيارة ليس فصل الشركات الألمانية عن الصين أو توقيف الروابط التجارية المهمة بينهما، ولكن إعادة التوازن إليها والبحث عن تكافؤ الفرص والمعاملة بالمثل. من ناحية أخرى، لم تُغفل إدارة شولتس، بعد اعتمادٍ استراتيجي كارثي على الغاز الروسي، المخاطرَ التي قد تترتب عن استراتيجية (صنع في الصين 2025) ومساعي الرئيس شي لتركيز اعتماد سلاسل الإنتاج الدولية في أحدث الصناعات على الصين. هكذا، حث شولتس في مقال منشور على صفحات مجلة فورين آفيرز Foreign AFFAIRS الشركات الألمانية على اتخاذ خطوات فعّالة لتقليل التبعيات المحفوفة بالمخاطر، ولاسيما في أحدث التقنيات، والاتجاه نحو التنويع الذكي في الأسواق وسلاسل التوريد.
من زاوية أخرى، فبرغم الانسجام بين الصيغتين الألمانية والأمريكية، حيث يستخدم صنّاع القرار في برلين وواشنطن اللغة نفسها لوصف الصين كـ “منافس نظامي”، فإن هذا لا ينفي وجود الاختلاف بينهما من حيث الجوهر. فبينما تنظر الولايات المتحدة إلى التنافس مع الصين على أنه تنافس على الهيمنة العالمية، وصراع بين مجتمعات الديمقراطية والدكتاتوريات، فإنّ ألمانيا التي عانت من جراء الانقسام تنبذ من منطلق تاريخي عقلية الحرب الباردة، وتتجنب الانجرار إلى الصراع، وعليه، فإنها لا تنظر إلى الصعود الصيني على أنه “تهديد” وإنما تعتبره “منافسة”، فالارتقاء الصيني لمرتبة القوة العظمى ليس شذوذًا، وإنما هو فقط عودة لوضع سابق، وألمانيا لا تعترض على ذلك بحسب المستشار شولتس، كما لا ترى في صعود الصين مبررًا لعزلها أو استعدائها.
ختامًا، واستنادًا إلى ما سبق، يمكن الإقرار بأن السياسة الألمانية تجاه الصين، قد عرفت تغيرًا نسبيًا، فبينما ظلت برلين وفية لسياستها المدفوعة تجاريًا في محاولة للحفاظ على علاقات اقتصادية وثيقة مع أكبر شركائها التجاريين: الصين، فإنها تعمل على تشكيل هذه العلاقات على أساس المناصفة والتكافؤ، وتجتهد للحيلولة دون قيام تبعية اقتصادية للصين، من خلال تشديد إجراءات الاستثمار الخارجي، وسنّ تدابير للحد منها، ومن ضمنها آلية فحص الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، والتي تعمل بشكل أكثر حزمًا في مجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمنشآت الحيوية. وعلى الجانب الآخر، ثمة حضور أكبر لمسألة حقوق الإنسان كعامل مؤثر في سلوك برلين إزاء بكين، خاصة مع إقرار ميثاق الائتلاف الحكومي تبني ألمانيا الاتحادية سياسة خارجية قائمة على القيم، حيث يأمل القادة الألمان في أن تتحلى بكين بروح المسؤولية، باعتبارها فاعلًا دوليًا له مسؤولية في رعاية الأمن والاستقرار الدولي، والعمل معًا لمعالجة القضايا الملحَّة؛ كتعزيز النمو، وتغير المناخ، وتسوية النزاعات. وعلى سبيل المثال، حث شولتس في زيارته إلى الصين الرئيس شي على استخدام نفوذ الصين كعضو دائم في مجلس الأمن لوضع حد للحرب الروسية – الأوكرانية.
وعلى الرغم من أن هدف السياسة الألمانية يكمن في الحد من الانجرار نحو الصراع العسكري مع الصين والالتزام بسياسة “صين واحدة”، فإن شولتس قد أشار إلى أن القوة المتنامية للصين “لا تبرّر مزاعم الهيمنة”. لكن، إذا أرادت الصين ترجمة هذا الازدهار الاقتصادي إلى هيمنة ومناطق نفوذ، في انتهاك للقانون الدولي، وتحديدًا انتهاك الوضع القائم في مضيق تايوان الحيوي للتجارة الدولية، الذي لا يجوز تغييره إلا بوسائل سلمية وتوافقية – إذا حدث ما سبق، فإن مسؤولية ألمانيا تقتضي التصرف بحزم لحماية للديمقراطية الليبرالية. وفي هذا الصدد، كان ميثاق الائتلاف الحكومي قد نصّ على أهمية التنسيق الوثيق بين ألمانيا وشركائها الأوروبيين وعبر الأطلسي (الولايات المتحدة وكندا، …) والدول ذات التفكير المماثل (أستراليا واليابان والهند، …) لصياغة استراتيجية فعّالة إزاء الصين.
خاتمة:
شكلت العقود الثلاثة لنظام ما بعد الحرب الباردة فترة سلام واستقرار وازدهار نسبي، وأدى مسار العولمة والتطور التكنولوجي إلى مستويات غير مسبوقة من الاتصال والاعتماد الاقتصادي المتبادل والتعاون الدولي. واستمدت ألمانيا – لكونها أكبر اقتصاد أوروبي – قوتها من هذا النسق، الذي أسهم أيضًا في توجيه بوصلة سياستها تجاه بكين في إطار السياسة الشرقية Ostpolitik، حيث شكلت أسواق الكتلة الشرقية سابقًا والصين سوقًا مربحة للتجارة الألمانية؛ ما سمح للعلاقات بينهما أن تتطور إلى “شراكة استراتيجية”.
وتحت إدارة ميركل، التي انتهجت سياسة خارجية تقودها الصادرات، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا منذ عام 2016. وعندما تم انتخاب أولاف شولتس مستشارًا لألمانيا الاتحادية – الذي وضع نهاية للحقبة “الميركلية” – وقفت الإدارة الجديدة، خاصة في ظلّ اتجاه أوروبي عام يميل إلى اعتبار الصين من وجهة نظر استراتيجية “منافسًا نظاميًا”، أمام خيارين: مواصلة سياسة المشاركة مع الصين في إطار “التغيير من خلال التجارة”، أو سياسة الدبلوماسية والردع التي صاغها حزب الخضر خلال الحملة الانتخابية. وفيما تكشف مفاوضات الائتلاف الحكومي عن شد الحبل خاصة بين الديمقراطيين الاشتراكيين من جهة والخضر والديمقراطيين الليبراليين من جهة أخرى، فإن تصاعد حدة الصراعات الجيوسياسية، وتحديدًا الحرب الروسية-الأوكرانية التي شكلت تهديدًا لنظام الأمن الأوروبي بجانب انعكاساتها السلبية (مثال: أزمة الطاقة)، بددت أوهام برلين بشأن النتائج المأمولة من استراتيجية “التغيير من خلال التجارة”، وأيقظت المخاوف بشأن سياسة ألمانيا الصينية التي كانت تؤسس لتبعية جديدة خاصة أمام عجز الميزان التجاري الألماني مع الصين.
إجمالاً، أصبحت لهجة برلين تجاه بكين أكثر حدة في أعقاب حرب أوكرانيا، فيما يؤشر على تغير في السياسة الألمانية تجاه الصين. بيد أنه تغير محدود أو جزئي. فعلى عكس الإدارة الأمريكية التي تنظر إلى روسيا والصين من منظور جيو-سياسي شامل كقوتين مُراجِعتين تشكلان تهديدًا للنظام الدولي، تتعامل ألمانيا مع روسيا والصين كحالتين منفصلتين. فبينما شكلت الاستجابة الألمانية للعدوان الروسي نقطة التحول، حيث تصرفت ألمانيا كجهة فاعلة أمنية ملوِّحة بورقة القوة الصلبة لأول مرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تظلّ ألمانيا مترددة في النظر إلى الصين من منظور جيو-سياسي. وفي هذا الصدد، تؤشر زيارة شولتس إلى الصين، ويؤكد مقاله في فورين آفيرز، على أن ألمانيا حريصة على إزالة “المخاطر” في علاقاتها مع الصين والتوجه نحو التنويع الذكي والمعاملة بالمثل والتعاون حيث أمكن، لا الانفصال عن الصين، أو الاستجابة الحرفية لاستراتيجية واشنطن “للفصل” وعزل الصين، فذلك لن يكون مجديًا للازدهار الاقتصادي الألماني والأوروبي. وفي هذا السياق، وفيما لا توجد حتمية تفيد بتكرار سيناريو روسيا مع الصين، أو عودة الحرب الباردة، فإن مصلحة برلين تقتضي إصلاح وموازنة العلاقة الاقتصادية مع الصين للتقليل من خطورة التبعيات الاستراتيجية، ومن مصلحة ألمانيا – التي عانت الانقسام أيضًا – مقاومة إغراء تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل متصارعة، والتحرك دبلوماسيًا لحث الصين على الالتزام بقواعد النظام الدولي القائم، والعمل معًا على تعزيز هذا النظام الذي استفادت منه لعقود. ومن المرجح أن تكشف الاستراتيجية الشاملة للأمن القومي الألماني التي طال انتظارها، عن اتجاهات السياسة الألمانية تجاه الصين، وكيف تنوي ألمانيا موازنة علاقتها مع الصين بين المصلحة الاقتصادية والمخاوف الجيوسياسية.