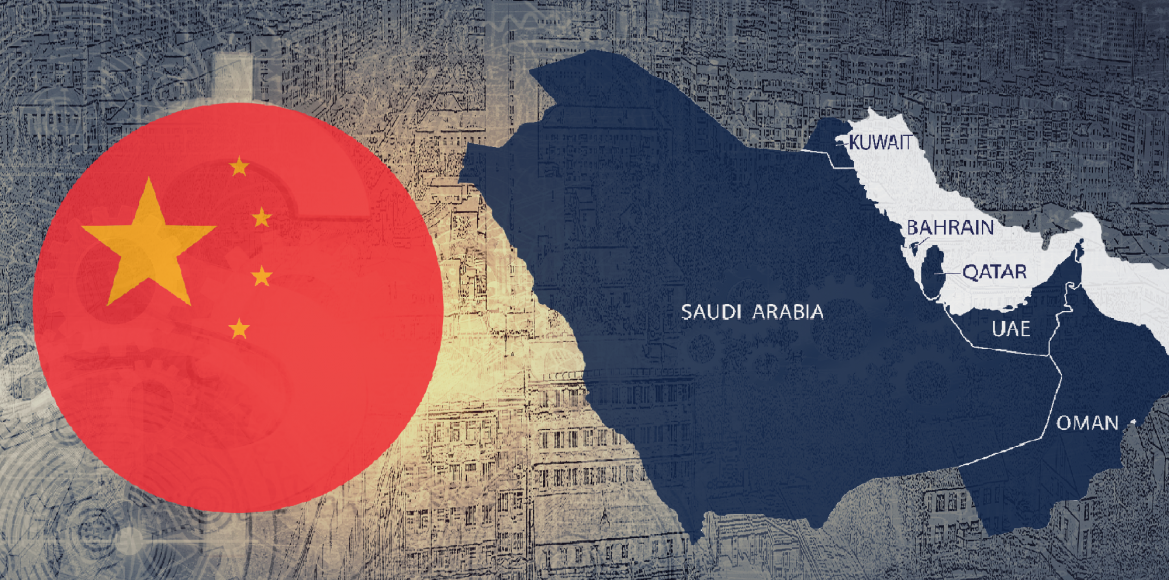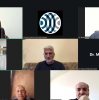بعد القمة الخليجية-الصينية، التي عُقدت في الرياض في ديسمبر من العام الماضي، اكتسبت العلاقات بين الصين ودول الخليج العربية زخمًا جديدًا، وازدادت التساؤلات عمّا إذا كان هناك تَوَجُّهٌ خليجيٌّ يدفع نحو التخلي عن الولايات المتحدة، أو على الأقل تحديد العلاقة معها. ومن ثَمَّ يدفع باتجاه الاعتماد على الصين – بدلًا من الولايات المتحدة – كحليف جديد للحفاظ على استقرار المنطقة. أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مناورة خليجية لخلق شيء من التوازن في علاقات دول الخليج مع القوى الكبرى في العالم، لا سيّما بعد أن بات هذا العالم يشهد تنافسًا شديدًًا على النفوذ في المناطق الإقليمية المهمة، وعلى رأسها الشرق الأوسط. وتسعى هذه الورقة إلى تحليل دوافع دول الخليج نحو توطيد العلاقة مع جمهورية الصين الشعبية، وتحديد دلالات ذلك التَّوَجُّه بالنسبة لمستقبل العلاقة مع حليفها التقليدي، الولايات المتحدة الأمريكية.
بعد انعقاد القمة الخليجية-الصينية في الرياض (ديسمبر 2022) بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، لم يختلف نشاط الدبلوماسية الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عمّا كان عليه قبل هذه القمة، إذْ استمرت كُلٌّ من الدولتين في اتباع استراتيجيتهما القائمة على تصفير المشاكل وتحجيم الأزمات مع دول الجوار، وأيضًا مع غيرها من دول العالم. فالسعودية مثلًا – بعد التصالح مع إيران – استقبلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كما حافظت في الوقت نفسه على استقلالية قراراتها السيادية، وعدم الزج بنفسها في قضايا الآخرين، لا سيّما من خلال اتباع السياسات النفطية التي تراها مناسبةً لها ومُحَقِّقَةً لمصالحها.
في الوقت نفسه، استقبلت الرياض مسؤولين أمريكيين، وأجرتْ معهم بعض النقاشات – التي قد تصل أحيانًا إلى حَدّ التنسيق – حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما تجسَّد مؤخرًا على هيئة وساطة سعودية أمريكية مشتركة بشأن الصراع في السودان. كما قام وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بزيارة الرياض مؤخرًا، واجتمع مع وزراء الخارجية الخليجيين للتحاور معهم حول ملفات المنطقة.
لكن هذا التواصل لم يَعُدْ يجري بأسلوب ومنطق ما قبل عام 2013، بعد أن شهد ذلك العام أكبر انعطافة في العلاقات الخليجية-الأمريكية، حين كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، حقيقة الموقف الأمريكي تجاه ما كان يُسمى بثورات “الربيع العربي”، ومُفاد هذه الحقيقة أن الولايات المتحدة حليفٌ لا يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل. وجديرٌ بالذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد أشار في مذكراته إلى أن الشيخ محمد بن زايد حذره من أن سقوط الرئيس المصري آنذاك، حسني مبارك، سوف تمتد آثاره إلى دول أخرى في المنطقة.
في المقابل، تقوم الصين – إلى أقصى درجة – باستغلال هذا الخلاف الخليجي الأمريكي، حيث أخذت تُوَسّع وتُنَوّع علاقاتها مع كل مغامرة أمريكية جديدة، بحيث تُرَسّخ تواجدها وتُعَمّق علاقاتها في المنطقة، إلى نجحت وساطتها أخيرًا في حلحلة الخلاف بين السعودية وإيران، والذي كان يُعَدُّ من أعقد الأزمات التي مرت على منطقة الشرق الأوسط – وليس منطقة الخليج فحسب – لا سيّما في السنوات الأخيرة، على اعتبار أن التنافس على النفوذ في هذه المنطقة قد أدَّى إلى حدوث صداع مزمن فيها، وكان له تداعيات مختلفة على الوضع في الإقليم ككل. أمّا بعد الوساطة الصينية فقد أصبح هناك لغة دبلوماسية جديدة، تغلب عليها الرغبة في حلحلة الأزمات، والحرص على تجاوز كل الخلافات، وسادتْ لغة تبادل الاستثمارات والتفاهمات، وهذا – في جزء منه – يُحسب للدبلوماسية الصينية.
واليوم، ترغب الدول الخليجية في إقامة علاقات متوازنة، وتحاول أن تحقّق هذه الرغبة، ولكنها تفعل ذلك بطريقة من يمشي على حبل مشدود. ومن المعروف أن هناك حالة من التنافس الشديد تسود أجواء المنطقة، فهناك رغبة صينية جامحة في لعب أدوار نشطة في المنطقة، وإن كانت وفق أسلوب الدبلوماسية الهادئة. وفي المقابل لا يمكن إنكار عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط دول الخليج بالولايات المتحدة، والتي تتغلغل في تفاصيل كثيرة، وتسود في سياقها مصالح كبيرة ومتنوعة.
ما زال هناك أيضًا قناعة لدى الدول الخليجية بأن بعض السياسيين الأمريكيين – وليس كلهم – هم الذين يهددون قوة ومتانة العلاقة بين الجانبين، وهذه المجموعة من السياسيين ينتمي أغلبها إلى الحزب الديمقراطي. ومن هذا المنطلق نجد أن السياسيين الأمريكيين أصبحوا يترددون ويتناوبون على زيارة الدول الخليجية بين الفترة والأخرى، ويؤكدون في تصريحاتهم على أهمية الحفاظ على العلاقة مع هذه الدول وتعزيزها، في دلالة واضحة على أن الإدارة الأمريكية الحالية بدأت تراجع سياساتها، لا سيّما بعد أن اكتشفت أن هذه السياسات كانت سببًا في حدوث بعض التوترات. ولكن ينبغي أن يُوضع في الحُسبان أن هذه المراجعات – حتى الآن – لم تبلغ المرحلة التي تَبُثُّ الطمأنينة في نفوس الدول الخليجية، فعلى سبيل المثال نجد الولايات المتحدة تُجري مفاوضات نووية سرية مع إيران، وفي الوقت نفسه تتعمد تجاهل وجهة النظر الخليجية في هذا الملف حتى هذه اللحظة.
لا شك أن قدرة الدول الخليجية في التعامل مع كل من الولايات المتحدة والصين في آنٍ واحد تُعتبر ميزة سياسية واستراتيجية كبيرة. ومن البديهي كذلك أن التعامل المتوازن مع أكثر من قوة كبرى يَصُبُّ في مصلحة المنطقة بشكل عام، كما أن الانفتاح على أكثر من قوة في النظام الدولي من شأنه أن يوفر مساحة للمرونة في المواقف، بدلًا من الاقتصار على خيار وحيد، مثلما حدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1989. أمّا اليوم، فإن تحرك الدول الخليجية تجاه الصين لم يَعُدْ يعني بالضرورة معاداةً للولايات المتحدة، بقدر ما صار يعكس ويؤكد تقديرات دول الخليج واهتمامها بمصالح شعوبها. ولم يَعُدْ من المُسَلَّمَات أن يتبع الخليج تلقائيًا أي موقف أمريكي؛ لمجرد أن واشنطن ترى هذا الموقف مطلوبًا أو مناسبًا، في حين أنه لا يخدم مصالح دول الخليج وشعوبها، فكلمة “التبعية” – التي كان يُطلقها المراقبون دائمًا على العلاقة بين دول الخليج وواشنطن – هذه الكلمة قد انمحتْ من القاموس الخليجي، ولم يعد لها مكان في العلاقات بين الجانبين.
تكلفة الاستهانة
من المؤكد أن سياسات ومواقف دول الخليج قد تغيرت، انطلاقًا من تغيُّر طريقة إدراكها لمصالحها، وتقديراتها لكيفية تحقيق تلك المصالح، فضلًا عن مواجهة التحديات ومصادر التهديد القائمة والمحتملة. غير أن هذا التَّحَوُّل لم يأتِ من فراغ، ولم يحدث فجأة، أو بشكل غير مبرر. بل على العكس؛ فقد كانت دول الخليج حريصة – إلى أبعد مدى – على استمرار علاقاتها الاستراتيجية الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإبقائها على ما كانت عليه دائمًا من وثوق وترابط وتنسيق. وبالرغم من كل ذلك فإن شعوب وحكومات الخليج اكتشفت أن هذا الرهان – الذي كان دائمًا الأول والوحيد – هو رهان في غير محله، لا سيّما بعد أن أثبتت واشنطن مرارًا وتكرارًا أن الترابط والتنسيق والوشائج العميقة التي تجمعها بدول الخليج كانت دائمًا تأتي انعكاسًا لوجهة النظر الأمريكية، ولم تكن قَطُّ نابعةً من وجهة نظر مشتركة أو متبادلة مثلما ينبغي لها أن تكون.
لقد كانت هناك مشاهد كثيرة ومتكررة من الخذلان الأمريكي، ليس لدول الخليج فحسب وإنما لكل الدول العربية، إذْ بدأتْ الولايات المتحدة الأمريكية تُقْصِي الشرق الأوسط عمّا يستحقه في استراتيجياتها الإقليمية الجديدة، ليس فقط من حيث الحياد والعدالة والموضوعية، بل أيضًا من حيث الاهتمام والمتابعة. بل إنها أيضًا بدأت تستبعد دول الشرق الأوسط عن أي تنسيق حقيقي، حتى في الملفات التي كانت تمثل قمة أولويات دول الخليج، مثل الاتفاق النووي الإيراني؛ ومن ثَمَّ انتقل الاهتمام والتنسيق بالطبع لصالح مناطق إقليمية أخرى، مثل شرق آسيا ومنطقة الإندوباسيفيك عمومًا. وقد انعكس هذا الأمر في عدة مظاهر، أهمها التحركات الأمريكية التي تركت فراغات أمنية، ومنها الانسحاب من العراق، الذي كان سببًا مباشرًا في خروج تنظيم “داعش” إلى العلن، وهو أخطر تنظيم إرهابي مَرَّ على هذه المنطقة على مدار التاريخ. ثم تبنتْ واشنطن مواقف ضعيفة ومتخاذلة إزاء الفوضى الأمنية التي بدأت تنتشر في كل المنطقة العربية بين عامي 2011 و2012، بسبب إطلاق يد تنظيم “الإخوان المسلمين” الإرهابي، بل ودعمه وتشجيعه، وتوفير الغطاء السياسي له. ثم بادرتْ إلى التقارب مع إيران، وتبنَّتْ مواقف متساهلة تجاهها، وأجرتْ مفاوضات مباشرة معها – كانت أقرب إلى الاستجداء – والتي أسفرت عام 2015 عن اتفاق نووي تشوبه كثير من النواقص، ويتضمن حزمة من الألغام سياسيًا وتقنيًا واقتصاديًا، حتى اضطرت هي نفسها إلى الانسحاب منه لاحقًا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وهكذا راحتْ واشنطن تُراكم سلسلة تراجعاتها وانتكاساتها في المنطقة، بالانسحاب غير المبرر استراتيجيًا من أفغانستان – وفقًا لمعظم الآراء – وإفساح المجال طوعًا وبكل سهولة أمام حركة طالبان لتعود إلى الحكم، بعد أن استمرت الحرب بينهما عقدين من الزمن.
منذ استهلَّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما ولايته، بدأ ظهور النوايا الأمريكية الساعية إلى التخلي عن المنطقة لأسباب مختلفة، بعضها يعود إلى محاولة احتواء التوسع الصيني في جنوب شرق آسيا، في حين يعود بعضها الآخر إلى ترتيبات سياسية مع إيران، وهو ما تمخضت عنه الاتفاقية النووية. ثم استمرت هذه السياسات في عهد الرئيس جو بايدن – الذي كان نائبًا لأوباما – من خلال اتباع سياسات تقلل من مكانة المنطقة ومن بعض قادتها، وقد تَمَثَّل هذا الأمر في مقولته الشهيرة بأنه “سيجعل السعودية دولة منبوذة”. هذا وقد حاولت الدول الخليجية أن تعمل على عدم تصعيد الخلاف مع مؤسسات الدولة الأمريكية؛ باعتبار أن الإدارة الديمقراطية – خلال هاتين الفترتين – لم تكن تُعَبِّر عن السياسة الأمريكية عمومًا، بقدر ما كانت تُعَبِّر عمَّا أصاب سياستها الخارجية من تَرَهُّل وضعف في مواقفها.
ولكن، في ظل استمرار تلك المواقف المتجاهلة للعلاقات التاريخية التي تربط الدول الخليجية بالحليف الأمريكي، فقد بات من الضروري والمُعلن أن تتحرك دول الخليج نحو البحث عن بدائل من الحلفاء الدوليين، وتنويعهم، والاعتماد على الكفاءات الوطنية للدول الخليجية، وأصبح هذا المسعى علنيًا – بل وشرعيًا – إذْ رفضت هذه الدول أن تتحيَّز ضد روسيا في حربها مع أوكرانيا، وبدلًا من ذلك فقد وقفتْ موقفًا محايدًا من الحرب، في الوقت الذي تورطت فيه الدول الأوروبية في انحياز صريح. ووصل الأمر بدول الخليج إلى حَدّ أنها رفضت أن يتم تسييس نفطها في الحرب الروسية الأوكرانية، وتجسّد ذلك في موقفها حين رفضت سد النقص في النفط الروسي بعد فرض العقوبات عليها. بل إن الموقف الخليجي تصاعد أكثر من ذلك حين عبَّرتْ دول الخليج عن رفضها للزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، واعتبرتها زيارة استفزازية؛ بمعنى أنها بدأت تحدد اتجاه استراتيجيتها للحفاظ على مكتسباتها وأمنها الوطني وفق ما تراه مناسبًا لها، وبدون التشاور مع الحليف الأمريكي، لدرجة أنه – أي الحليف الأمريكي – فوجئ بصدور إعلان التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن عام 2015.
إن تكلفة تجاهل المنطقة كانت شديدة الوطأة على الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سَعَتْ دول الخليج، لا سيّما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى توسيع شراكاتها مع مختلف دول العالم، واستحدثتْ استراتيجية تنويع الحلفاء الدوليين الذين يمكن الثقة بهم، في عالم يغلب عليه الحراك والتغير بصورة لافتة.
وقد استلزم هذا الأمر – بلا ريب – تفكيرًا استراتيجيًا من دول الخليج، ومراجعة متأنية ودقيقة للحسابات الخاصة بالتكلفة والعائد. وكانت النتيجة هي ضرورة الجمع في موازنة العلاقات مع القوى الكبرى بين مسارين: الأول هو توسعة نطاق الحلفاء الاستراتيجيين في العالم من الدول المؤثرة في كل إقليم، مثل فرنسا في أوروبا، ومثل الهند في قارة آسيا، وغيرها من مناطق العالم.
أمّا المسار الثاني فهو التخفيف من الارتباط بالولايات المتحدة، وتخصيص جزء من مساحة ذلك الارتباط للتقارب مع منافِسَيْها التقليديَّيْن في العالم، وهما الصين وروسيا. وقد وصل قادة دول الخليج إلى قناعة بأن كُلًا من موسكو وبكين لديهما حرص على الحفاظ على سيادة الدول وعلى استقرار حكوماتها وأنظمتها السياسية والاقتصادية والمجتمعية، باعتبارها الأساس والمحرك الكفيل بتنفيذ ورعاية التنمية الاقتصادية، مع الاستمرار بتطويرها في الوقت ذاته، في حين أن التوجه الغربي يُصِرُّ على دعم بعض القوى الداخلية ذات الأهداف الخاصة والأجندات الضيقة، تحت شعارات سياسية دفعت القوى الغربية لأن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت تلك المسميات والشعارات غير الحقيقية مثل: دعم الحريات وحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد اكتسبت العلاقات الخليجية-الصينية زخمًا كبيرًا، لا سيّما بعد تلك الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جي بينغ إلى الرياض خلال الفترة من 7 – 9 من ديسمبر 2022؛ حيث كشفت هذه الزيارة عن اهتمام متبادل بين الطرفين – الخليجي والصيني – لتنويع علاقاتهما وتوسعتها، بحيث تتعدى الجانب التجاري والاستثماري الذي كانت تقتصر عليه من قبل مثل تلك الزيارات، ليشمل مجالات سياسية واستراتيجية. وقد تم تتويج كل ذلك بنجاح الوساطة الصينية بين السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث استطاعت إحداث اختراق دبلوماسي لجمود العلاقة الأكثر تعقيدًا في المنطقة.
تنويع الحلفاء
حتى مارس عام 2023، كان المأخذ الكبير على مضمون العلاقات الخليجية- الصينية أنها تفتقر إلى ما ينبغي أن تكون عليه من تفاعل وحضور على الجانب السياسي والأمني. وهو مأخذ منطقي؛ حيث ظلت هذه المنطقة تعاني من عدم الاستقرار على مدى أكثر من أربعة عقود. ولكن مع النجاح الصيني اللافت في تطبيع العلاقات السعودية- الإيرانية تغيرت نظرة المراقبين تجاه هذه العلاقة، خاصة وأن الرهان على نجاح أي قوة دولية في الدخول إلى المنطقة يعتمد على مدى قدرتها في تحقيق التوازن بين كُلٍّ من إيران وباقي الدول الخليجية. ولهذا يبدو أن مستقبل العلاقة بين الصين ودول الخليج العربي بات مفتوحًا، وستجد الطريق ممهدًا لتوطيدها وترسيخها.
من الطبيعي أن تبحث دول الخليج عن التوازن في علاقاتها الدولية، غير أن ذلك – في المقابل – لن يكون على حساب التضحية بعلاقاتها مع الولايات المتحدة. وكذلك الأمر بالنسبة لواشنطن التي بدأت المؤسسات التقليدية فيها تراجع حساباتها الاستراتيجية تجاه المنطقة. ومن جانبها، بدأت تحركات دول الخليج ومواقفها تتسم بجرأة سياسية محسوبة، فأعطت إشارات رمزية وفعلية بأن لديها أوراقًا اقتصادية ودبلوماسية كافية لتنبيه الإدارة الأمريكية، بل وتكفي أيضًا لإزعاجها. وقد تَجَلَّتْ أبرز هذه الإشارات – عمليًا – من خلال تمسك دول الخليج بإجراءات خفض إنتاج النفط، في الوقت الذي كان فيه الغرب يشتكي من أزمة الطاقة العالمية، حيث ترسخ الاعتقاد بأن الدول الخليجية تتجه نحو “التخلي” عن الولايات المتحدة، لا سيّما في ضوء الرفض الخليجي للانحياز إلى جانب واشنطن في الحرب الروسية الأوكرانية. ثم أعلنت دول الخليج مؤخرًا دعمها للسيادة الصينية على وحدة أراضيها وفق مبدأ “الصين الواحدة” في أغسطس 2022، وذلك على أثر الزيارة المستفزة التي قامت بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايبيه.
والحقيقة أن الإدارة الأمريكية الحالية لديها مشكلة كبرى في فهم متغيرات المنطقة والعالم، والتي لا يمكن حلها بالوسائل التقليدية التي كانت تتبعها قبل عام 2013، لا سيّما بعد أن أصبحت الدول الخليجية لاعبًا مؤثرًا نسبيًا في السياسة الدولية، وباتت تجيد لعبة العلاقات الدولية. وخلاصة الأمر أنه إذا لم تتقاطع مصالح الإدارة الأمريكية مع مصالح دول الخليج فلن يكون بإمكانها أن تمنع دول الخليج، أو تطالبها بعدم ترسيخ علاقاتها مع الصين الصاعدة.
وفي الوقت ذاته، دائمًا ما تؤكد الحكومات الخليجية على أن واشنطن حليف استراتيجي لا ترغب في التخلي عنه. لكنها فقط تؤكد – من خلال هذه الواقعية السياسية – أن التطورات الاستراتيجية الأخيرة في المنطقة والعالم تفرض عدم الاعتماد على حليف واحد.
صحيحٌ أن الولايات المتحدة لديها شيء من التفهم لأبعاد الموقف الخليجي في مسألة ترسيخ العلاقات مع الصين، باعتبارها ردة فعل على أخطاء واشنطن الاستراتيجية الكبيرة في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تشعر بالقلق من أن تعزيز هذه العلاقات قد يُمَكِّن الصين من تحقيق استراتيجيتها الكبرى – مبادرة “الحزام والطريق” – أو ما يُعرف بطريق الحرير، والذي سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد الصيني بشكل كبير، ويفتح أمامها منافذ استراتيجية كثيرة على العديد من البحار والمضائق العالمية التي تطل عليها الدول الخليجية وإيران، والأهم من ذلك احتمال التواجد العسكري الصيني. وكل هذا – في مجمله – يعني انحسارًا حقيقيًا للدور الأمريكي في العديد من مناطق العالم، وليس من الخليج أو الشرق الأوسط فحسب.
الطريق نحو الصين
هناك خمس محددات تفسر التفاهم بين الدول الخليجية والصين. وهي محددات تختلف عن المقاييس الغربية، وتختلف بالأخصّ عن المقاييس الأمريكية. وأول هذه المحددات هو الإرادة السياسية نحو تطوير العلاقات من منطلق أن “الكل رابح”. فالتجربة الصينية في مجال التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة تُعَدُّ نموذجًا يُحتذى به. فهي الدولة الوحيدة في العالم تقريبًا التي قضت على الفقر، وهذا وحده يكفي للاقتداء بها والتعاون معها كعامل جذب مهم، في إطار بحث دول الخليج عن شركاء في التنمية والتعاون والمكاسب المشتركة.
وهنا يظهر المحدد الاقتصادي كمدخل لبناء علاقات قوية من المصالح، ومن ثم الانطلاق نحو العلاقات الأخرى. وهكذا كان مبدأ الصين في التقارب مع الدول الخليجية. صحيحٌ أن الصين قد أظهرتْ منذ البداية أنها لا تُعَوِّل كثيرًا على العلاقات السياسية، إلَّا أن كثيرًا من التحليلات ترى أن السياسة والأمن سيأتيان لاحقًا، وأن تركيز بكين على الاقتصاد والتجارة في هذه المرحلة هو فقط سِتارٌ لكسب ثقة العالم، ورسالةٌ إلى الدول المترددة في التقارب مع الصين. ويبدو بالفعل أن نجاحها في الوساطة بين إيران والسعودية قد أعطى بُعْدًا آخر لطبيعة ومضمون العلاقات بين الصين ودول منطقة الخليج. ويتبع هذا محددٌ آخر يصلح لأن يكون مستقلًا، كما يصلح لأن يكون تابعًا للمحدد السابق، ألا وهو ضخامة المشروعات التنموية التي باتت تربط الصين ببعض دول المنطقة، إذْ أصبح لديها علاقة استراتيجية مع دولة الإمارات، واستثمارات ضخمة في سلطنة عمان، وكذلك في السعودية، وهو ما يستوجب أن تكتسب العلاقات بينها سِمَة الاستمرارية والتعامل المكثف بشكل ثنائي وجماعي.
ثمة عامل آخر له أهمية خاصة، وهو التشابه والاتساق حول التصور المُفترض للنظام الدولي، فبجانب احترام سيادة الدول، ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك أهمية التعاون بين أطراف المجتمع الدولي باعتباره أسرة واحدة، إلى جانب كل هذا تطرح الصين مفهوم الشراكات الاستراتيجية في إطار تعددي؛ أي التعاون مع الجميع بدون تمييز، حيث الغاية هي تحقيق المصالح وليس توجيه سياسات الدول.
لا تَخَلِّيَ عن الولايات المتحدة
ما تعكسه المواقف السياسية الخليجية، سواءً في استقبال مسؤولين أمريكيين، أو من خلال زيارات قادة دول الخليج إلى واشنطن، كل ذلك يمثل جانبًا من الصورة الكبيرة عن العلاقة التي تربط بين الحليفيْن الاستراتيجييْن. بل إن الصين – ورغم حالة الاندفاع والحماسة في توطيد علاقاتها مع الدول الخليجية – إلَّا أنها تدرك صعوبة الحديث عن إحلالها مكان الولايات المتحدة في المنطقة؛ وذلك لأسباب متنوعة، يتعلق بعضها بطبيعة المنطقة المليئة بالاختلافات والأزمات، بينما يتعلق بعضها الآخر برغبة الصين في ألَّا يُفسد عليها أحد مشروعها العالمي – مبادرة الحزام والطريق – لذلك فهي تفضل البقاء بعيدًًا لتحافظ على مصالحها.
هناك العديد من مشاهد السياسة الأمريكية التي اضطرت دول الخليج إلى التحرك لإظهار بعض صور الاستعداد للتخلي عن الاستعانة بالولايات المتحدة، لا سيّما بعد أن أصبحت الإدارة الديمقراطية – في عهديْ أوباما وبايدن – تتجاهل الجانب الوظيفي لها في علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الخليجية. وهذا يعني أن تحرك دول الخليج لتوسعة تحالفاتها الدولية لا يمكن اعتباره دليلًا على التخلي عن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو تقليل الاستثمار فيها على الأقل في المدى المنظور. فكل ما هنالك أن هذه الدول توازن الكفة بين تحقيق المتاح من الفرص في العلاقات مع القوى الدولية، للحفاظ على مكاسبها، باستخدام أوراق لا تضر ولا تؤثر في عمق العلاقة مع الحليف الأمريكي، الذي ظل يراقب تحركات الدول الخليجية دون أن يحاول عرقلتها ما دامتْ لم تصل إلى المساس بجذور هذه العلاقات، كما أن هذه التحركات الخليجية لم تَعْمَدْ إلى استفزاز الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن المعروف أن هناك قناعات بأن بعض هذه التحركات لا تتم إلَّا بعد استشارة من الولايات المتحدة، على الأقل في دوائر صنع القرار الحقيقية.
إن كل ما تفعله الدول الخليجية من خلال توطيد علاقتها بالصين هو أنها توائم بين أيهما الأقدر على تحقيق مصالحها في اللحظة الآنية، ولكن دون الاعتماد الكامل عليه، من منطلق أنه لا يوجد صديق دائم ولا عدو دائم، ولكن هناك مصالح دائمة. بل إن الدول الخليجية قد باتت تُحسن اختيار التوقيت في ممارسة الضغط على الحليف الدولي من أجل استمرار العلاقة معه وفق منطق “شعرة معاوية”. وهاتان السياستان هما اللتان تحققان الربح والفائدة للدول الخليجية. ومن أجل الوصول إلى هذه النقطة من التوازن الاستراتيجي بين القوى الدولية، قد يبدو للمراقبين أن الحضور الصيني بارز ومسيطر على المشهد الخليجي، ومع ذلك فإنه من غير المرجح أن تتخلى الدول الخليجية عن علاقاتها العميقة مع الولايات المتحدة، وإنما كُلُّ ما في الأمر أنه سيكون لديها شيء من المرونة في الاتفاق والاختلاف أكثر مما كان عليه الأمر في السابق، بعد أن كان يُنْظَر إلى هذه العلاقة فيما مضى على أنها علاقة تابع بمتبوع.
الخلاصة
لقد تأخرت الولايات المتحدة الأمريكية في فهم مغزى السياسة الخارجية الخليجية، فلم تدرك أن دول الخليج العربية قد صار لديها محددات وقواعد لسياساتها، تنطلق من مصالحها أولًا، وبما لا يتعارض مع مصالح أي أطراف أخرى، بل قد تتوافق معها، وتخدم الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة والعالم. ولهذا باتت لا تزج بنفسها في أزمات أو مشكلات قد تعود عليها بنتائج سلبية. وفي أقصى الأحوال، حين تبلغ الأزمات ذروتها، فإن دول الخليج تنتهج مبدأ الحياد، فلا تنحاز مع طرف ضد آخر، وهذا ما جعل هذه الدول محل تقدير واحترام دولييْن.
وفق هذا الطرح، يمكن إدراك أن ما تأمله الدول الخليجية في علاقاتها مع القوى العظمى – سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين – ليس هو إقامة علاقة وثيقة بدولة على حساب الأخرى، أو أن تصبح الصين بديلة للولايات المتحدة. فالعلاقات الخليجية الأمريكية أعمق من ذلك بكثير، وتتجاوز حدود الأمن والسلاح، كما أنها – أي دول الخليج – لا تريد أن تسيطر دولة بعينها على المنطقة، أو أن تكون اللاعب الدولي الوحيد فيها. كُلُّ ما هُنالك أن دول الخليج تريد فحسب إيجاد مستوى متوازن من التكافؤ الاستراتيجي؛ كي تضمن الحفاظ على مكتسباتها التنموية، وتُشارك دول العالم المتحضرة في السعي إلى رفاهة شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار والأمن لكل شعوب الأرض، وذلك من خلال التفاهم والتنسيق مع كل القوى الكبرى والإقليمية، دون انغلاق على دولة بعينها، أو إقصاء لأخرى.