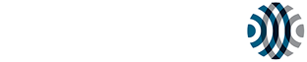أصبح الحديث عن العيش في "عالم ما بعد الغرب" أمرًا شائعًا. عادةً ما يستشهد المعلقون بهذه العبارة للتنبؤ بظهور قوى غير غربية - أبرزها الصين، بالإضافة إلى البرازيل والهند وإندونيسيا وتركيا ودول الخليج، من بين دول أخرى. ولكن إلى جانب "صعود البقية"، يحدث أمرٌ بالغ الأهمية: زوال "الغرب" نفسه ككيان جيوسياسي متماسك وذو معنى. فالغرب، كما يُفهم كمجتمع سياسي واقتصادي وأمني موحد، على حافة الانهيار منذ فترة. وقد تُوجه ولاية دونالد ترامب الثانية كرئيس للولايات المتحدة الضربة القاضية.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، رسّخ نادٍ متماسك من الديمقراطيات المتقدمة اقتصاديًا النظام الدولي الليبرالي القائم على القواعد. ولم يكن تضامن هذه المجموعة متجذرًا في تصورات التهديد المشتركة فحسب، بل أيضًا في التزام مشترك بعالم مفتوح قائم على مجتمعات حرة وتجارة حرة - والاستعداد الجماعي للدفاع عن هذا النظام. ضمّت هذه المجموعة الدول الأساسية الولايات المتحدة وكندا، والمملكة المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، وعددًا من الحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل المستعمرات البريطانية السابقة أستراليا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين اندمجتا في نظام التحالف الأمريكي لما بعد الحرب، وتبنّتا المبادئ الليبرالية للحكم الديمقراطي واقتصاد السوق. شكّل الغرب جوهر ما يُسمى بالعالم الحر خلال الحرب الباردة. لكن الغرب صمد أمام ذلك الصراع ثنائي القطب، بل ووسّع حدوده ليشمل عددًا من دول الكتلة السوفيتية السابقة وبعض جمهورياتها من خلال توسع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.
على مدى الثمانين عامًا الماضية، أنشأت الدول الغربية العديد من المؤسسات لتحقيق أهدافها المشتركة، أبرزها حلف الناتو، ومجموعة الدول السبع، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبنفس القدر من الأهمية، نسّقت هذه الدول مواقفها السياسية ضمن أطر متعددة الأطراف أكثر شمولًا، مثل الأمم المتحدة ووكالاتها، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ومجموعة العشرين. لا شك أن الانقسامات والتوترات الدورية قد شددت من تضامن الغرب. ومن الأمثلة البارزة على ذلك أزمة السويس عام 1956، وتحدي الرئيس الفرنسي شارل ديغول لهيكل القيادة المتكامل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ستينيات القرن الماضي، والتعليق المفاجئ للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون لقابلية تحويل الدولار إلى ذهب عام ١٩٧١، وأزمة الصواريخ الأوروبية في ثمانينيات القرن الماضي، والتوترات عبر الأطلسي إزاء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
لكن لم تختبر أي من هذه الأحداث تماسك الغرب بقدر ما اختبرته عودة ترامب إلى البيت الأبيض. فمنذ يناير، تبنى الرئيس توجهًا صارخًا "أميركا أولاً" في السياسة الخارجية والاقتصادية والأمن القومي. وتتسم رؤيته لدور الولايات المتحدة في العالم بالقومية المفرطة، والسيادة، والأحادية، والحمائية، والمعاملاتية. وعلى النقيض من أسلافه من الرؤساء، نادرًا ما يتحدث عن القيادة الأمريكية العالمية، ناهيك عن المسؤولية. فهو يحتقر التحالفات والتعددية والقانون الدولي. ولا يكترث كثيرًا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية - وقد فكك قدرة الولايات المتحدة على تعزيزها في الخارج. كما أنه ينكر دور بلاده في المساهمة في المنافع العامة العالمية، بما في ذلك التجارة المفتوحة، والاستقرار المالي، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والأمن الصحي العالمي، ومنع الانتشار النووي. وهو أبرز مناصري القوى السياسية اليمينية القومية الصاعدة في أوروبا وأمريكا الشمالية، مستغلاً مفهوماً حضارياً غامضاً عن الغرب، ومُشككاً في الأهمية الراسخة للغرب الجيوسياسي.
أذهلت تحولات ترامب أقرب شركاء الولايات المتحدة. أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بحزن في أبريل: "لم يعد الغرب كما عرفناه موجوداً". سعى القادة الغربيون إلى التستر على هذه الحقائق المزعجة، بما في ذلك في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في يونيو، بجهودٍ مُذلّة لإطراء ترامب وفكاهته وإقناعه.
لكن ملاحظة فون دير لاين لا تزال تتردد لأنها تتوافق مع ما يعتقده ويقوله قادة آخرون، وإن كان ذلك غالبًا بصوت خافت: هذه المرة الأمر مختلف تمامًا. إن زوال الغرب ككيان ذي معنى سيجلب خسارة فادحة. سيترك النظام الدولي المنفتح والمقيد بالقواعد هائمًا، بلا مرساة تاريخية ومحرك تقدم رئيس. كانت المفاهيم الليبرالية التي قامت عليها الغرب الجيوسياسي عالمية في جوهرها؛ أما المفاهيم القومية التي تُعلي من شأن الغرب الحضاري، فهي مُركزة بدلًا من ذلك على الدفاع عن الحدود والخوف من الآخرين. وإلى جانب تعريض المبادئ الليبرالية للخطر على الصعيد المحلي، من المرجح أن تُسرّع هذه الاتجاهات من صعود التعددية غير الليبرالية، وهو نظام دولي بدائي تُشكله، بل وتُهيمن عليه، قوى عظمى استبدادية. من المؤكد أن زوال الغرب يُتيح فرصةً للقوى المتوسطة البنّاءة لبناء شبكات جديدة من التعاون الدولي مُصممة خصيصًا للقرن الحادي والعشرين. ولكنه يُنذر أيضًا بعالم أقل سلامًا وأقل تعاونًا من العالم الذي ساهم الغرب في بنائه.
خلال الحرب الباردة، برز الغرب كفاعل جيوسياسي متماسك وموحد، يضم كتلة من الدول الديمقراطية (في معظمها) المعارضة للاتحاد السوفيتي وأقماره التابعة - "الشرق" كما يُطلق عليه - والمتميزة عن دول "الجنوب العالمي" - وهي منطقة ما بعد الاستعمار التي شهدت صراعًا دمويًا كبيرًا بين الشرق والغرب.
لم يكن هذا النظام ثنائي القطب هو النظام الدولي الذي تصورته الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما وضع المخططون الأميركيون لما بعد الحرب مخططات لنظام دولي مفتوح قائم على العضوية العالمية، والمبادئ متعددة الأطراف، والتوافق والتعاون بين القوى العظمى، وخاصةً ما تجسده الأمم المتحدة حديثة التأسيس. أحبطت المواجهة مع الاتحاد السوفيتي هذه الخطط المدروسة جيدًا، ودفعت الولايات المتحدة إلى تبني سياسة الاحتواء. إذا كان هناك بالفعل "عالمان بدل عالم واحد"، كما خلص الدبلوماسي الأميركي تشارلز بوهلين عام 1947، عندما فرضت موسكو سيطرتها الكاملة على أوروبا الشرقية، فلم يكن أمام الولايات المتحدة خيار سوى توحيد "العالم غير السوفيتي... سياسيًا واقتصاديًا، وفي التحليل الأخير عسكريًا".
وهكذا، ولّد مبدأ احتواء الشيوعية غربًا أكثر واقعية جيوسياسيًا – بخلاف الغرب الحضاري الغامض - سرعان ما تجسد في مؤسسات جديدة مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأوروبا المتكاملة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أصبح الغرب نظامًا داخل نظام، نادٍ لديمقراطيات السوق المتداخلة ضمن نظام عالمي أكثر شمولًا يضم منظمات عضوية كبيرة مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة. بمرور الوقت، أصبح هذا النظام الداخلي يشمل مجموعة أكثر تنوعًا من ديمقراطيات السوق، وأبرزها اليابان، التي لم تكن غربية بأي معنى ثقافي تقليدي، لكنها تبنت مبادئ سياسية واقتصادية ليبرالية. عندما يشير بعض المحللين اليوم إلى "الشمال العالمي"، فإنهم يتحدثون عن ذلك النظام الداخلي.
لقد شكّل التمسك المشترك بالديمقراطية، وكذلك الرأسمالية، أساس التضامن الغربي. وتتعهد ديباجة معاهدة واشنطن (1949)، التي أسست حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أعضاء الحلف بـ"حماية حرية شعوبهم وتراثهم المشترك وحضارتهم، على أساس مبادئ الديمقراطية والحرية الفردية وسيادة القانون". قد يعتبر المتشككون هذه اللغة مجرد ذريعة عاطفية، لكنهم مخطئون. فقد أثرت هذه الالتزامات بشكل ملموس على سلوك الحلفاء، وشكّلت كيفية فهم الدول الغربية لمصالحها الوطنية، وتواصلها فيما بينها، وتسوية النزاعات العرضية، بحيث أصبح مفهوم الحرب بين أعضاء النظام الداخلي، على سبيل المثال، أمرًا لا يُصدق. ومن المؤكد أن هذه الفئة غالبًا ما كانت تُقدّر الديمقراطية بين زملائها من الدول الغربية أكثر مما تُقدّرها بين دول العالم النامي وما بعد الاستعماري، وخاصة تلك التي كانت شعوبها تميل نحو اليسار.
إلى جانب المُثُل العليا المشتركة، كان بإمكان الحلفاء الغربيين أن يطمئنوا إلى أسلوب القيادة التوافقي لواشنطن، الذي خفف من وطأة واقع الهيمنة الأمريكية. أيد الرئيس دوايت أيزنهاور هذا التوجه في خطاب تنصيبه الأول، في يناير/كانون الثاني 1953، بلغة تبدو اليوم وكأنها من عصرٍ غابر: "لمواجهة تحديات عصرنا، وضع القدر على عاتق بلدنا مسؤولية قيادة العالم الحر. لذا، من المناسب أن نؤكد لأصدقائنا مرة أخرى أنه في أداء هذه المسؤولية، نعرف نحن الأميركيون ونلاحظ الفرق بين القيادة العالمية والإمبريالية؛ بين الحزم والعنف؛ بين هدف محسوب بعناية ورد فعل متقطع لمحفزات الطوارئ". وبقدر ما تمتعت الولايات المتحدة بإمبراطورية داخل الغرب، فقد كانت، على حد تعبير المؤرخ غير لوندستاد "إمبراطورية بالدعوة".
استمر الغرب كمفهوم وكيان جيوسياسي ذي معنى حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وشرقه. كان من الطبيعي أن يفقد نادٍ تشكّل في معارضة الاتحاد السوفيتي هويته بعد زوال ذلك المنافس. ولكن على الأقل خلال تسعينيات القرن الماضي، لم يتفتت هذا الفصيل إلى كتل متنافسة ومنافسات، ولم تُنتج جهودًا لتقويض الأحادية القطبية الأميركية. في الواقع، كان هناك توقع واسع الانتشار، وإن كان ساذجًا، بأن مجتمع ديمقراطيات السوق العالمي - الغرب، بعبارة أخرى - سيتوسع لا محالة ليشمل المزيد من العالم، مع تبني دول أخرى للقيم الليبرالية العالمية والبنية المعيارية للنظام الدولي المنفتح والقائم على القواعد.
لم تتحقق هذه الآمال. فبدل عولمة الغرب، شهد العالم صعود بقية القوى، وهي مجموعة متنوعة من القوى الكبرى والإقليمية العازمة ليس فقط على رفع أصواتها في المؤسسات الدولية، ولكن أيضًا، في بعض الحالات، على تحدي المبادئ المنظمة لتلك المؤسسات. تدريجيًا وببراعة، بدأ الغرب يتخذ بُعدًا حضاريًا أكثر، وهي عملية تسارعت بفعل هجمات الحادي عشر من سبتمبر وما تلاها من "حرب على الإرهاب" وأزمات الهجرة الجماعية وما تلاها من غضب قومي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
على الرغم من هذه التحديات، صمد التضامن الغربي، حتى بعد فترة ولاية ترامب الأولى المضطربة. انتعش مجتمع ديمقراطيات السوق المتقدمة خلال إدارة الرئيس جو بايدن، واثقًا ليس فقط بضمانات الأمن الأمريكية، بل أيضًا بالتزام واشنطن الأوسع بالمبادئ الليبرالية ورؤية نظام دولي منفتح قائم على القواعد. بشكل عام، واصلت الحكومات الغربية اتباع نهج واشنطن، لأنها اعتبرت الولايات المتحدة استثمارًا مستقرًا، وكانت واثقة من أنه إذا ساءت الأمور، فإن الولايات المتحدة ستدعمها وستنقذها. لقد كان ترتيبًا مبنيًا على الثقة، مدعومًا بالتزام بالقيم المشتركة، والقواعد المشتركة، والالتزامات المتبادلة.
بيت منقسم
بعد ثمانية أشهر من ولاية ترامب الثانية، تحطمت تلك الثقة الآن. في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في يونيو/حزيران، حاول شركاء الولايات المتحدة بشجاعة التستر على الخلافات المتزايدة، بما في ذلك بشأن فرض ترامب رسومًا جمركية باهظة، وتهديده الحلفاء لزيادة الإنفاق الدفاعي، والضربة الأحادية الجانب على المنشآت النووية الإيرانية. انحنى القادة المجتمعون، وأشادوا بالرئيس لجرأته، متجاهلين حقيقة أن تنمره المستمر يمثل انحرافًا جذريًا عن الأسلوب التشاوري الذي لطالما ميز العلاقات بين الدول الغربية عن الدبلوماسية التقليدية.
لم يعد بإمكان أقرب حلفاء الولايات المتحدة اعتبار ضمانات واشنطن الأمنية أمرًا مفروغًا منه. لقد دفعت تصريحات الرئيس المتبجحة وتقلباته العديد من الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري - وهي نتيجة إيجابية بلا شك، ولا تتعارض بطبيعتها مع فكرة الغرب الموحد الجيوسياسي. لكن ترامب أبعد أيضًا الحلفاء وأعاد إحياء جهود الاتحاد الأوروبي المتعثرة منذ فترة طويلة للسعي إلى الاستقلال الاستراتيجي، ما سيسمح للكتلة ليس فقط بفرض نفوذها العسكري، بل أيضًا باتباع مسار جيوسياسي مستقل. في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضًا، يخشى الحلفاء من إلغاء الولايات المتحدة فجأةً تغطيتهم التأمينية. وبينما يهاجم ترامب نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على القواعد بفرض تعريفات جمركية شاملة، يتجه حلفاء الولايات المتحدة بالمثل إلى تنويع خياراتهم التجارية والتعامل مع شركاء أكثر موثوقية، وإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي في هذه العملية.
يتماشى هذا السلوك التحوطي مع الرأي العام. تكشف استطلاعات الرأي في أوروبا عن تراجع في التأييد للولايات المتحدة وتراجع الثقة في التحالف عبر الأطلسي. في ربيع العام 2025، اعتبر 28% فقط من المشاركين الولايات المتحدة "حليفًا موثوقًا به إلى حد ما" - بانخفاض عن أكثر من 75% في العام السابق.
إحدى الضحايا المؤسسية لانفصال ترامب عن الغرب هي مجموعة السبع. منذ نشأتها في السبعينيات، كانت مجموعة السبع رمزًا للتضامن الغربي وركيزة للحوكمة الاقتصادية العالمية، حيث وحدت أهم ديمقراطيات السوق المتقدمة: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن الكثيرين كتبوا نعيًا لها خلال الأزمة المالية العالمية، عندما خاطرت مجموعة العشرين بتجاوزها، إلا أنها عادت إلى الحياة بقوة عام 2014، عندما طرد الأعضاء الغربيون في مجموعة الثماني آنذاك روسيا لدعمها الانفصال في شرق أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم. ومع ذلك، فقد انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا طرد روسيا ولم يخف ازدرائه لمجموعة السبع - حتى أنه انسحب من قمتها عام 2018 في غضب. ويشير العديد من المراقبين الآن إلى الجسم باسم "مجموعة الستة زائد واحد".
إن هذا التباعد الأميركي عن مجموعة السبع يُهدد بحرمان أعضائها من أمرٍ لا تستطيع مجموعة العشرين الأكثر تنوعًا توفيره: نادٍ متشابه الأفكار، تُمكّن ديمقراطيات السوق الرائدة في العالم من مواءمة مواقفها السياسية بما يتوافق مع التزامها بعالم منفتح، مُقيّد بالقواعد، قائم على مبادئ ليبرالية مشتركة.
بينما تجد القوى الغربية المتوسطة نفسها عالقةً بين أحادية ترامب وشكوكها بشأن الصين، بدأت تستكشف شراكات جديدة ومرنة مع القوى المتوسطة الصاعدة في العالم النامي، كجزء من توجه أوسع نحو نظام دولي يُعرّف بـ"الانحياز المتعدد"، حيث تسعى الدول إلى أقصى قدر من المرونة في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية بدل الانحياز بشكل مُتسق مع قوى أو كتل عظمى مُحددة. في الواقع، هذا هو بالضبط ما يحدث، حيث يُحاول الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه بناء علاقات تجارية أوثق وروابط دبلوماسية أوثق مع دول مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا.
تلاشي الغرب
خلال ولايته الأولى، عندما كان مُقيّدًا بالمؤسسات، استحضر ترامب أحيانًا مفهوم الغرب. في خطابه في وارسو في يوليو 2017، أعلن الرئيس أن "السؤال الجوهري في عصرنا هو ما إذا كان الغرب يمتلك إرادة البقاء". وبالنظر إلى سلوكه الفعلي في منصبه، وتضمن التقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من الحكام المستبدين، يتضح أن ترامب لا يفهم الغرب ككيان جيوسياسي من حقبة الحرب الباردة، قائم على تقييمات مشتركة للتهديدات والتزام بالقيم الليبرالية، بل يفهمه بمفهومه القديم، القومي الإثني، والغامض، كحضارة مشتركة لا تقوم على مبادئ سياسية ليبرالية، بل على جذور جغرافية وتاريخية مشتركة.
يشهد الغرب الآن انقسامًا، إذ ينحرف معناه من مفهوم التضامن الجيوسياسي والأيديولوجي إلى مفهوم أكثر حضارية، لاسيما في الولايات المتحدة، وتتآكل الثقة في التحالفات عبر الأطلسي وغيرها. ومع بروز انقساماته الداخلية، يبدو من الإنصاف التشكيك في تماسك وجدوى هذه الفئة نفسها. وثمة مفارقة في هذا المأزق. لسنوات، شكك النقاد في الولايات المتحدة وأوروبا في مفهوم "الجنوب العالمي" الشامل، معتبرين أنه تسمية واسعة للغاية لا يمكن تطبيقها على مجموعة متنوعة تضم أكثر من 100 دولة ما بعد الاستعمار والدول النامية.
فما الدلالة التفسيرية التي يمكن أن يوفرها هذا المصطلح، بالنظر إلى تنوع التواريخ والإرث الثقافي والمؤسسات السياسية والظروف الاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية والطموحات الإقليمية للمجموعة التي يزعم أنه يشملها؟
السؤال اليوم هو ما إذا كان الغرب الجيوسياسي، كفئة، يستحق تشكيكًا مماثلًا. لقد تآكل التضامن الاستراتيجي والأيديولوجي الذي كان يُعد أمرًا مسلمًا به، بين الولايات المتحدة وديمقراطيات السوق الكبرى الأخرى. لم يكن تفكيك الغرب من صنع ترامب وحده، كما أنه ليس مجرد انقسام، حيث تتجه الولايات المتحدة في اتجاه بينما يتجه شركاؤها السابقون في اتجاه آخر. في معظم الديمقراطيات المتقدمة، يزداد استقطاب الناخبين، ما يؤدي إلى تضاؤل دعم الوسط السياسي ونزع الشرعية عن الأحزاب والحكومات المعتدلة. يتخاصم التقدميون الكوزموبوليتانيون والقوميون المحافظون، بما في ذلك حول معنى الغرب ذاته.
بلغت هذه التوترات ذروتها علنًا وبشكل بارز في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير. هناك، أثار نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، غضب جمهوره، الذي غلب عليه الطابع الأوروبي، بتصويره القيود "المُتيقّظة" على حرية التعبير التي تفرضها الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة في القارة، على أنها تهديدٌ أكبر لحرية الغرب وأمنه من غزو روسيا لأوكرانيا. تمحور نقده حول مفهومٍ للغرب قائم على الدم والأرض، مفهومٌ متجذر - كمفهوم فانس للأمة الأمريكية نفسها - لا في التفاني للمبادئ السياسية المشتركة لعصر التنوير، بل في هوية حضارية وشعور عضوي بالمكان.
لعقود، وقفت ديمقراطيات السوق المتقدمة في العالم متحدةً في الأزمات، ودافعت عن حقوق الإنسان وغيرها من القيم الليبرالية، وسعت عمومًا إلى مواءمة سياساتها وتنسيقها داخل كلٍّ من النوادي الصغيرة والمنظمات الدولية الأكثر شمولًا، بما في ذلك الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز.
إن زوال الغرب كوحدة جيوسياسية موثوقة سيشهد بشكل متزايد تعارض مصالح الولايات المتحدة وشركائها السابقين، وسيجدون أنفسهم على طرفي نقيض في النقاشات. وهذا ليس مجرد نتيجة حتمية لتراجع الهيمنة الأمريكية في النظام الدولي. بل يمكن للمرء أن يتصور إعادة تفاوض تدريجية على القيادة وتقاسم الأعباء داخل الغرب، مع، على سبيل المثال، مسؤولية أكبر للحلفاء في الدفاع الجماعي. إن تخلّي واشنطن عن الأممية، وأي اهتمام بالمعايير الليبرالية ووضع الأجندات، يؤدي إلى تباين في القيم وإدراك التهديدات بين الدول الغربية، مما سيُزعزع بشكل جذري تضامن الغرب الجيوسياسي.
هذا التمزق عميق لأنه يحدث في القلب الداخلي للنظام العالمي القائم منذ أربعينيات القرن الماضي. كما أنه يخلق خيارًا للقوى المتوسطة في العالم، ليس فقط في الغرب، ولكن أيضًا بين الاقتصادات الناشئة التي لا ترغب في استبدال الولايات المتحدة بالهيمنة الصينية. لطالما اشتكت القوى الناشئة من استبعادها من الساحة العالمية. تُتيح اللحظة الراهنة المتقلبة فرصةً لدولٍ مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا للتعاون مع نظرائها من دول ديمقراطية السوق المتقدمة، مثل أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة، والتي قد تبحث عن شركاء جدد في عالم ما بعد الغرب.
لكنّ هذا الكمّ الهائل من الترتيبات التي قد تنشأ لتحل محلّ يقينيات النظام القديم التي تلاشت، لن يكون قادرًا على تكرار أعظم نتائج ذلك النظام. لقد كان الغرب، ذلك النظام الداخلي الذي نشأ في بوتقة الحرب الباردة، منطقة سلام. لن يخوض أعضاؤه حربًا فيما بينهم أبدًا. وفي غيابه، سيترك الغرب وراءه عالمًا أكثر عرضة للشك والعداء والصراع.