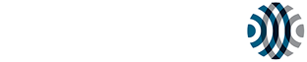تُعدُّ الأغوار الفلسطينية والبادية الممتدة على طول السفح الشرقي للضفة الغربية الفضاء الأوسع للزراعة والرعي والتنقل الموسمي للتجمعات البدوية. منذ سنوات طويلة، اعتمدت دولة الاحتلال مقاربة القضم الهادئ لهذه المنطقة: إعلان مساحات شاسعة كأراضي دولة، أو تحويلها إلى مناطق مغلقة لأغراض التدريب العسكري أو ما يصطلح عليه بمناطق إطلاق النار وإعلانات المحميات طبيعية، وتسييجها بشبكة طرق وحواجز وبؤر رعوية وزراعية حديثة، بحيث يجري تفتيت الحيز الفلسطيني إلى جيوب محاصَرة، مقابل وصلٍ متدرج بين المستوطنات ومعسكرات الجيش والبؤر.
بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تسارعت هذه العملية بصورة غير مسبوقة على مستويين متوازيين: تصعيد العنف المنهجي من قبل المستوطنين، وتوسيع منظومة القرارات والإجراءات الحكومية والإدارية التي تحول الوقائع الميدانية إلى هندسة جيوسياسية جديدة. يقارب هذا المقال الوقائع الجديدة التي فرضتها دولة الاحتلال من خلال التهجير القسري للتجمعات وما ينطوي على ذلك من وقائع جغرافية، وما الذي يعنيه على صعيد الوصل والفصل الجيوسياسي في الأغوار خصوصاً، وفي الضفة عموماً.
كيف تحول العنف إلى أداة إدارية؟
وصلت هجمات وتهديدات من مستوطنين، بحراسة أو مشاركة لقوات الجيش، وتقييد متزايد للوصول إلى المراعي والموارد المائية، إلى مستويات غير مسبوقة في المرحلة التي تلت السابع من أكتوبر. كل هذه الإجراءات تتواءم مع التعريف الدولي للبيئة الطاردة التي تؤدي في طبيعة الأمر إلى تتالٍ سريع لحالات نزوح جماعي لهذه التجمعات. وسجلت منظمات أممية أن عام 2024 كان من أعلى الأعوام في إرهاب وعنف المستعمرين المستوطنين الذين لم يكتفوا بإيقاع الإصابات والأضرار في صفوف المواطنين، بل خلقوا نموذجاً مستحيلاً للحياة في هذه المناطق، وأن وتيرة عام 2025 حافظت على المستوى المرتفع ذاته، مع مئات الاعتداءات التي طالت أكثر من 200 تجمع، وخصوصاً في الأغوار ومحافظات رام الله ونابلس والخليل (على امتداد ما يطلق عليه بشارع ألون الاستيطاني). كما وثقت في تقارير متعاقبة نزوحاً متكرراً لعشرات الأسر في أسبوع واحد تحت وطأة اعتداءات بؤر رعوية أُنشئت حديثاً بمحاذاة هذه التجمعات.
بعد 7 أكتوبر، غدت البؤر الرعوية، التي وصل عدد المُنشأ منها بعد السابع من أكتوبر وحتى منتصف عام 2025 إلى ما يزيد على 70 بؤرة جديدة، أداةً مركزية للتوسع: قافلة أو حظيرة تتحول بسرعة إلى قاعدة سيطرة على مساحات رعي واسعة حولها، مع تفعيل عنف يومي لطرد الرعاة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى الماء والمراعي، بمعنى أن هذه البؤر أصبحت بشكل أو بآخر منطلقاً لتنفيذ الاعتداءات والهجمات الكبيرة الممنهجة، ما يدفع الأسر إلى الرحيل حفاظاً على سلامتهم ومواشيهم. هذا النمط وثقته تقارير بحثية وصحافية باعتباره تكتيكاً تسارعت وتيرته كجزء من استراتيجية أوسع للضم الفعلي عبر الزراعة/الرعي.
وإذ تفيد تقارير منظمات رسمية وحقوقية بتهجير أكثر من 33 تجمعاً فلسطينياً بدوياً منذ السابع من أكتوبر، تتوزع هذه التجمعات على 66 موقعاً في الضفة، وأدى ذلك إلى ترحيل 2373 مواطناً من هذه التجمعات. وقد أتاح هذا التهجير، بحسب هذه المؤسسات، للمستوطنين إغلاق مئات آلاف من الدونمات كانت تتواجد عليها هذه التجمعات. ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال عام 2024 ما يقارب 3000 اعتداء نفذها المستوطنون، استهدفت ممتلكات وأراضي ومواطنين بشكل مباشر. وقد أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد عدد من المواطنين (منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير استُشهد 32 مواطناً على يد المستوطنين). كما أشارت تقارير الهيئة إلى أن المستوطنين أشعلوا ما يقارب 450 حريقاً، طالت في 70% من الحالات تجمعات بدوية أو قرى محاذية لها.
شملت أمثلة حديثة بارزة إجبار أسر من المعرجات الشرقية على النزوح تحت وطأة هجمات متكررة، وتهجير تجمع عين أيوب قسراً بعد سلسلة اعتداءات، بالإضافة إلى موجات نزوح جماعي في برية كيسان شرقي بيت لحم. وتوثق هذه الحالات تسارع وتيرة التهجير من أطراف الأغوار شمالاً وجنوباً إلى مناطق وسطى، بما يؤدي إلى إغلاق الممرات الرعوية التقليدية ومحاصرة التجمعات الفلسطينية في جيوب أصغر.
الأغوار كحيز حاسم للـوصل الاستعماري
منذ العام 1967، وبالتحديد عقب المصادقة على ما عُرف آنذاك بـ"خطة يغآل ألون" الاستيطانية، التي نصت في جملة بنودها على السيطرة المطلقة على الأغوار ــ أي الشريط الممتد على طول السفح الشرقي للضفة الغربية ــ خضعت هذه المنطقة لمنظور استعماري إسرائيلي خاص. فالأغوار تشكل في هذا السياق حزاماً أمنياً/استيطانياً يربط شمال الضفة بجنوبها على طول الخط الشرقي الملاصق للحدود الأردنية، ويتيح وصل المستوطنات بالطرق العسكرية والمعسكرات مع تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين إلى أدنى حد. ولتحقيق هذا الوصل، تستخدم سلطات الاحتلال أدوات متكاملة:
-إعلانات غير مسبوقة لأراضي دولة تحول الملكيات الجماعية/الخاصة إلى نطاق سيادة إسرائيلية فعلية.
-إغراق فضاء الأغوار بالبؤر الرعوية والزراعية، عبر تمكينها من قبل الجيش بفرض الوقائع في مناطق تخضع لإجراءات عسكرية.
-تسوية أوضاع (شرعنة) البؤر وترقيتها إلى أحياء/مستوطنات مع شبكات طرق وخدمات.
-الطرق والحواجز التي تُغلق محاور فلسطينية وتفتح ممرات سريعة للمستوطنين.
فعلى صعيد إعلانات "أراضي الدولة"، أقدمت دولة الاحتلال مع نهاية عام 2023 على إعلان 501 دونم كأراضٍ للدولة، وفي مجمل عام 2024 على إعلان أكثر من 24 ألف دونم، وفي النصف الأول من عام 2025 على إعلان 744 دونماً إضافياً، جرى تسجيلها رسمياً ضمن هذه الفئة. وبذلك سُجِّل رقم قياسي في إعلانات "أراضي الدولة" التي حولت عشرات آلاف الدونمات إلى سيطرة إسرائيلية مباشرة. وجاء ذلك متزامناً مع استكمال سياسات "تبييض" البؤر الاستيطانية، إذ تتابعت الإعلانات الحكومية بشأنها: من قائمة تضمنت 68 بؤرة يجري العمل على تسويتها منتصف عام 2024 إلى إعلان شرعنة أوضاع خمس بؤر في مناطق معزولة، كردّ مباشر على موجة الاعترافات بدولة فلسطين. وتطور الأمر إلى إصدار قرارين يقضيان بفصل 13 حياً استيطانياً، وإنشاء 22 مستوطنة جديدة، فضلاً عن إضافة حواجز وبوابات خاصة في جنوب ووسط الضفة الغربية. وتُترجم هذه التدابير ميدانياً إلى سياسة واضحة تقوم على "وصل" استيطاني مقابل "فصل" فلسطيني، بما يؤدي إلى تفتيت النسيج الجغرافي الفلسطيني وإضعاف التواصل بين التجمعات السكانية.
كيف يعيد التهجير رسم خريطة "الوصل والفصل"؟
في الأغوار، تعتمد مجتمعات البدو تاريخياً على ممرات عرضية بين الأودية للوصول إلى موارد الماء والمراعي. عندما تُقام بؤرة رعوية في عقدة جغرافية (قريباً من نبع، أو على كتف وادٍ)، فإنها لا تطرد العائلة المقيمة فحسب، بل تُغلق عملياً ممراً كاملاً بنطاق حماية غير رسمي (دراجات نارية، ودوريات مسلحة، وكلاب، وكاميرات)، ما يعيد رسم حركة القرى المحيطة؛ سلسلة من البؤر على مسافات متقاربة تعني "شريط فصل" يمنع التواصل العرضي بين قرى السفوح الشرقية والوسطى، ويجبر الرعاة على مسارات أطول وأكثر تكلفة وخطورة. وهذا ما تُظهره وقائع الأشهر الأخيرة، حين أدى ضغط متزامن من أكثر من بؤرة إلى نزوح جماعي من برية كيسان والعيزرية وأطراف الأغوار الوسطى.
من الجيوب إلى الغيتوهات الرعوية
يُكرس الاحتلال سياسة تحويل التجمعات الفلسطينية إلى جيوب محاصرة، عبر شبكة من الشوارع الالتفافية والحواجز والبوابات الحديدية. ففي الأغوار وشرقي رام الله ونابلس، يؤدي توسيع شارع 90، وإعلانات "أراضي دولة"، وتطوير طرق زراعية مخصصة للبؤر الاستيطانية، إلى دفع القرى نحو غيتوهات ريفية تفقد قدرتها على التوسع العمراني والزراعي. وتوثق تقارير فلسطينية أن قرارات الإغلاق والحواجز الجديدة مكنت المستوطنين من السيطرة على مساحات بيئية وزراعية كاملة في محيط بيت لحم والخليل وصولاً إلى الأغوار الجنوبية.
سياسة الحصار المائي كرافعة للترحيل
الهجمات على البنى المائية ومصادر الينابيع تشكل "رافعة ترحيل" حاسمة؛ فمجتمع رعوي بلا ماء سيضطر إلى مغادرة المكان خلال أيام. وقد وثقت "أوتشا" أعمال تخريب متكررة لمحطات الضخ والبنى الملحقة بعين سامية التي تغذي عشرات القرى بمياه الشرب، فضلاً عن هجمات على خزانات وأنابيب في تجمعات رعوية، بما يعمق البيئة القسرية التي تدفع الأسر إلى الرحيل. وتحول هذه الممارسات الماءَ من مورد حياة إلى أداة هندسة سكانية ومساحة للسيطرة.
حالات ميدانية ذات دلالة
تُظهر الحالات الميدانية المتعاقبة منذ صيف عام 2023 نمطاً متدرجاً من الدفع نحو الفراغ في مناطق رعوية وحساسة استراتيجياً. فالتهجير الذي طال تجمعات رأس التين ووادي السيق والقَبون وعين سامية، قبل أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لم يكن مجرد وقائع منفصلة، بل كان جزءاً من آلية أوسع لإنتاج تخوم استعمارية زاحفة (creeping frontiers) تُعيد رسم الحدود المتحركة بين مجال فلسطيني آخذ في الانكماش ومجال استيطاني آخذ في الاتساع. استؤنف هذا النمط بزخم أكبر بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ليشمل تجمعات إضافية على محور الأغوار الوسطى وصولاً إلى مسافر يطا، موثقاً حالات نزوح جديدة في المعرجات الشرقية وعين أيوب بين نهاية عام 2023 ومنتصف عام 2025. وبهذا، يتحول الحيّز تدريجياً إلى نطاقات شبه خالية من الوجود الفلسطيني المتواصل، ما يخلق فضاءً استيطانياً مفتوحاً للتوسع. إن هذا "الدفع المتدرج" يرسم نطاقاً شبه خالٍ من الوجود الفلسطيني المتصل على طول كتل رعوية حساسة، ضمن ما يُعرف في أدبيات الاستعمار الاستيطاني بمفهوم حراسة التخوم (frontiers)، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم ديناميات التوسع على الأرض. وتشير التخوم هنا إلى الحدود الزاحفة (creeping boundaries) التي تفصل بين الأراضي التي "تدخل" في مشروع الاستيطان، وتلك التي تبقى خارجَه في الوقت الراهن.
هذه التخوم التي يرسمها الاستيطان الرعوي ليست ثابتة، إذ يتحرك المستوطنون الرعاة باستمرار مع توسيع نطاق المراعي، ما يؤدي إلى تقليص أراضي السكان الأصليين وحصرها، وغالباً ما يحولها إلى جيوب مغلقة ومحاصَرة. وفي المقابل، يظل "الخارج" ــ أي المنطقة المصنفة "ج" تحديداً ــ فضاءً مفتوحاً للتوسع الاستيطاني المستمر.
ويتقاطع هذا الدفع التدريجي مع ما يمكن وصفه بتأثير الدومينو في مناطق مثل برية كيسان شرقي بيت لحم، حيث أدى اعتداء المستوطنين وتمركزهم في بؤر رعوية إلى نزوح أكثر من 23 عائلة (128 فرداً) خلال تموز/يوليو 2025. مثل هذه الديناميات لا تقتصر على طرد مباشر للعائلات، بل تساهم في بناء "قوس وصل" استيطاني يمتد من جنوب بيت لحم حتى الأغوار الجنوبية والبحر الميت، ما يعزز سلسلة فصل طرفية تحاصر القرى الفلسطينية وتكرس التلاصق بين الشريط العسكري–الاستيطاني على امتداد الأطراف الشرقية للضفة الغربية.
أمّا في عين سامية شرقي رام الله، فيظهر نموذج مغاير هو الضم البيئي - الأثري، حيث يتجاور التهجير البدوي (2023)، مع ممارسات تخريب للبنية التحتية المائية (2024–2025)، مع سياسات حكومية مؤسسة على "إنقاذ وتطوير" مواقع أثرية وفق القرار الحكومي 786/2023. ولا تقتصر هذه السياسة على حماية التراث، بل تُستخدم كأداة لإعادة تشكيل الحيز، عبر تحويله إلى "حدائق أثرية" ومناطق محمية تقيد وصول الفلسطينيين، ما يدمج بين العنف اليومي المباشر وأثرنة المكان كوسيلة ضم ممأسسة.
وبذلك، تبين الحالات الثلاث كيف تتكامل أشكال العنف المادي والرمزي ضمن بنية استعمارية واحدة: فمن الدفع التدريجي الذي يعيد رسم التخوم، إلى دينامية الدومينو التي تحول النزوح إلى حلقات متواصلة من التوسع، وصولاً إلى الأثرنة التي تشرعن السيطرة بوصفها "حماية للتراث". هذه التداخلات تؤكد أن الاستيطان لا يعمل عبر أداة واحدة، بل من خلال مصفوفة مركبة تمزج بين العنف الميداني والسياسات المؤسسية، ما يجعل التهجير وإعادة إنتاج الحيز الفلسطيني عملية مستمرة ومتعددة الأبعاد.
الإطار المؤسسي – من "تسوية البؤر" إلى "الإدارة الاستيطانية"
لا ينفصل التهجير عن القرارات الحكومية التي أسست لإدارة استيطانية أكثر مركزية داخل وزارة جيش الاحتلال، وعن موجة تسوية (شرعنة) البؤر وتحويل الأحياء إلى مستوطنات مستقلة وتمويل البنى التحتية والطرق، فضلاً عن قرارات مصادرة موسعة وإعلانات أراضي دولة. وقد وثقت مؤسسة السلام الآن في تقارير متتابعة أن فترة ما بعد 7 أكتوبر شهدت قفزة في إقامة طرق ترابية وبؤر جديدة على أراضٍ فلسطينية خاصة، واستثمار ظرف الحرب لفرض وقائع ميدانية بسرعة. هذا الإطار يخلق شرعية تنظيمية لبؤر رعوية كانت بالأمس غير قانونية، ويُدخلها في شبكة تمويل وخدمات رسمية، ما يعمق قدرة هذه البؤر على الضغط والتمدد. وفي هذا الإطار يمكن تلخيص التحول الجيوسياسي في ثلاث دوائر مترابطة:
الدائرة الشرقية (الكماشة على المناطق بين شارعي 60 وألون): تُعدّ التجمعات البدوية الواقعة بين شارعي 60 وألون الأكثر تعرضاً في الأشهر الأخيرة لاعتداءات ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض عبر ترحيل سكانها، يسبقها تقدم سريع للبؤر الرعوية الممتدة بين شمال شرق محافظة أريحا وأحواض العوجا وفصايل والجفتلك وصولاً إلى طوباس شمالاً وجنوباً. وقد ترافق ذلك مع ارتفاع وتيرة الهجمات الموثقة، ما أدى إلى إغلاق ممرات رعوية تقليدية، ودفع عدداً من التجمعات إلى النزوح. وبذلك تزايد الفراغ الفلسطيني بمحاذاة الشريط الشرقي، الأمر الذي يساهم في تدعيم وصل المستوطنات والطرق العسكرية على امتداد غور الأردن.
الدائرة الوسطى (هضاب رام الله - نابلس الشرقية): تفريغ عين سامية/القَبون/رأس التين منذ عام 2023، مروراً بتهجير أسر من المعرجات الشرقية بعد 7 أكتوبر، ما قطع جسور الرعي والحركة بين قرى شرقي رام الله والأغوار الوسطى، وحوّل السفوح الشرقية إلى مسارب مقطوعة تتخللها بؤر رعوية. النتيجة: فصل عرضي يضغط القرى إلى الغرب ويسهّل وصل البؤر شرقاً.
الدائرة الجنوبية (برية بيت لحم - الخليل حتى الأغوار): حواجز وبوابات جديدة وإعلانات أراضي دولة قياسية الحجم، بالتوازي مع بؤر رعوية نشطة، أدت إلى نزوح سريع لعشرات الأسر من برية كيسان خلال أسبوع واحد في تموز/ يوليو 2025، مع تقارير عن تخريب مساكنهم بعد مغادرتهم. النتيجة: إحكام قوس الفصل حول الأطراف الشرقية لبيت لحم وصولاً إلى مسافر يطا، وفتح ممرات استيطانية/عسكرية ممتدة شرقاً..
الاقتصاد السياسي للتهجير: من الأمن إلى الزراعة إلى الموقع الأثري
لا يبرَّر التهجير الفلسطيني دائماً بمسوغ "الأمن" فحسب، بل يستند كذلك إلى ثلاثة محركات مترابطة تكشف عمق النهج الاستيطاني:
*الرعي/الزراعة كمحرك للضم:* تلجأ سلطات الاحتلال إلى إنشاء بؤر رعوية استيطانية تُقام عبر توفير الغطاء القانوني والدعم المالي لفرض السيطرة على مساحات واسعة من الأرض، بتكاليف أقل بكثير من بناء المستوطنات التقليدية، وبوتيرة أسرع تكرس واقعاً جديداً على الأرض. وقد وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هذه الظاهرة، مسجلة توسعاً ملحوظاً في عدد البؤر الرعوية خلال الأعوام الأخيرة.
الماء كمحرك تحكم: اعتمد الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الماضية على المياه كأداة استعمارية مباشرة للتحكم بالفلسطينيين، إذ صادر الآبار والينابيع، ومنع مشاريع البنية التحتية المائية، في مقابل تخصيص الحصة الأكبر للمستوطنات. ووفق تقرير مؤسسة الحق، فإن الفلسطينيين يحصلون على أقل من ثلث حصتهم الطبيعية من المياه، ما يجعل استمرار وجودهم في التجمعات المهددة أمراً شبه مستحيل. كما رصدت "أوتشا" 64 اعتداءً على مصادر مياه في الضفة عام 2024 وحده.
المواقع الأثرية كمحرك سيادي: تُستخدم المواقع الأثرية الفلسطينية تحت ذرائع "الحماية والترميم" لتغطية عمليات استغلالها وإعادة تعريفها ضمن سلطة أمنية - مدنية إسرائيلية، بما يبرر إقامة السياجات والطرق ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها. وقد كُشف مؤخراً، عبر مجموعة من الوثائق الصادرة عن "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، أن الاحتلال أدرج أكثر من 63 موقعاً أثرياً في الضفة الغربية ضمن ما يُسمى "المواقع الأثرية الإسرائيلية"، في خطوة اعتُبرت جزءاً من استراتيجية التهويد والضم الناعم. ولا تقتصر السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية على الاستيطان المباشر أو الطرد القسري، بل تمتد كذلك إلى المجال الرمزي - الثقافي، حيث يُستثمر التراث الأثري الفلسطيني كأداة سيادية.
ومن تداعيات ضم هذه المواقع إلى المستوطنات مصادرة الأراضي المحيطة بهذه المواقع، وحظر دخول الفلسطينيين إليها، وهو ما يعني فصل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية عن الاتصال المباشر بالمواقع التاريخية والتراثية التي تشكل جزءاً من هويته الثقافية.
ما دلالة الوصل والفصل الآن؟
تمثل عمليات التهجير القسري للتجمعات البدوية، وما يسبقها من إجراءات لفرض البيئة القسرية الطاردة، حالة من حالات فقدان سبل العيش التاريخية المعتمدة على المواشي والمراعي، وتفكك شبكات القرابة والاقتصاد المحلي، والاضطرار إلى الانتقال إلى أطراف مدن أو قرى لا تتوفر فيها بدائل رزق مناسبة. وتُظهر تقارير الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسات حكومية فلسطينية ومنظمات دولية، أن كثيراً من الأسر اضطرت إلى المغادرة من دون أملاكها، وأن مستوطنين قاموا بتخريب المساكن والحظائر بعد مغادرتهم، ما يقطع طريق العودة، ويحول النزوح الموقت إلى ترحيل دائم فعلي. هذه الوقائع تُصنف قانونياً كنقل قسري محظور في القانون الدولي الإنساني عندما يتم تحت سلطة القوة القائمة بالاحتلال، أو بفعل مجموعات تعمل بحمايتها أو بتنسيق معها.
ومن منظور أي تسوية مستقبلية، يحتاج المجتمع الفلسطيني إلى تواصل جغرافي - وظيفي بين المدن والقرى والمراعي والموارد. لكن الوصل الاستيطاني الممتد شرقاً عبر الأغوار وحوافها يقابله فصل فلسطيني داخلي يجعل من الحياة اليومية شبكة متاهات من الحواجز والطرق الالتفافية والمناطق المحظورة. بذلك، يتقلص النطاق المعيشي الفلسطيني إلى رقع صغيرة منفصلة، ويجري تدوير الاقتصاد المحلي إلى مسارات هشة تعتمد على العمل بعيداً عن الأرض، بينما تتوسع الكتلة الاستيطانية الشرقية غير المعلنة ككيان واحد متصل فعلياً. كما أن الإعلانات القياسية لأراضي الدول والقرارات بتسوية (شرعنة) البؤر وتوسيع الطرق تغلق نافذة إمكان قيام ممرات فلسطينية عرضية حيوية، وهو ما تبينه تقارير وتوثيقات مهنية تغطي الأعوام 2023- 2024–2025 بوضوح.
أدوات المواجهة
أولاً: توثيق قانوني ممنهج مفتوح المصدر وجهد دبلوماسي موازٍ
تتطلب طبيعة الضم الزاحف توثيقاً مكانياً/جغرافياً زمنياً دقيقاً، يشمل أرشفة الاعتداءات، ورصد تطور البؤر الرعوية، ومسارات الطرق الزراعية، وتغيرات الوصول إلى الينابيع والمراعي. وتعتمد منظمات دولية ومحلية على هذه الأدوات اليوم لإثبات نمطية الانتهاكات وتبعاتها على الترحيل القسري وسبل العيش. ومع قيام الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتوثيق حالات نقل قسري، تتوفر مادة قانونية صلبة لمساءلة القوة القائمة بالاحتلال والأفراد الضالعين في هذه الانتهاكات، بما في ذلك المتورطون في العنف الاستيطاني المنهجي، وخصوصاً في الحالات التي تتوفر فيها أدلة على حماية رسمية أو اشتراك فعلي في الجريمة.
ثانياً: حماية فورية للتجمعات المعرضة للخطر
يبرز مفهوم دعم صمود المواطنين في هذا النوع من التجمعات كشعار رئيسي للمرحلة، ضمن الجهود المؤسساتية الفلسطينية، الرسمية منها والأهلية. غير أن هذا المفهوم يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات والتنسيق والتكامل، بما يضمن الوصول إلى أوسع تغطية ممكنة ورفع مستوى الكفاءة، الأمر الذي يعني عملياً إفشال المزيد من مخططات الاحتلال الرامية إلى الفصل والوصل. ويُضاف إلى ذلك تفعيل جهود لجان الحماية الليلية المدعومة بالنشطاء الأجانب، مع توفير أدوات حماية تمكّنها من أداء دورها بفاعلية. وتؤكد تحديثات أممية أن عشرات التجمعات لا تزال ضمن دائرة الخطر المباشر. وهنا تأخذ الحماية أشكالاً متعددة، تشمل: المرافقة الرعوية، وتوفير معدات الاتصالات والإنذار، وتقديم دعم قانوني فوري، وتثبيت وجود خدمات أساسية (مياه وكهرباء متنقلة) تقلل من هشاشة البقاء. ويتم ذلك بالتوازي مع الرصد الميداني اليومي للهجمات وتوثيقها.
خاتمة
ما بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر لا يمثل مجرد مرحلة أشد عنفاً، بل لحظة تسارع في مشروع الوصل الاستيطاني الموازي للفصل الفلسطيني. فقد لجأت دولة الاحتلال إلى حزمة من الأدوات المتكاملة: من البؤر الرعوية السريعة، والحواجز والبوابات، وإعلانات "أراضي الدولة"، وتسوية أوضاع (شرعنة) البؤر، وصولاً إلى مأسسة "الأثر والتراث". هذه الأدوات أعادت إنتاج جغرافيا وظيفية جديدة في الأغوار وأطرافها، جغرافيا لم تُفرغ الشريط الشرقي من سكانه الأصليين عبر دفع التجمعات الرعوية والبدوية إلى النزوح الجماعي فحسب، بل حولته أيضاً إلى كتلة استيطانية - عسكرية متصلة، مرتبطة ببنية تحتية إسرائيلية واسعة.
وبهذا، يتجلى التناقض الجوهري: ففي حين تُفرض على الفلسطينيين سياسات الفصل والانقطاع (إغلاق الطرق، ومنع الوصول إلى المراعي والمياه، وتقطيع أوصال القرى والتجمعات)، يُبنى في المقابل مشروع الوصل الإسرائيلي (ربط البؤر بالمستوطنات الكبرى، ووصل الأغوار بالقدس ومراكز الداخل، وإحكام الطوق على الشريط الشرقي). وهكذا، لا تعكس الخرائط إعادة توزيع الأرض فحسب، بل أيضاً إعادة توزيع شروط الحياة والإمكانات السياسية: للفلسطينيين جغرافيا مجزأة بلا أفق، وللمستوطنين فضاء متصل وقابل للتوسع.
وعليه، يصبح الدفاع عن بقاء التجمعات البدوية والرعوية في أماكنها أكثر من مجرد نضال محلي ضد التهجير، بل هو نضال استراتيجي لحماية المساحة الفلسطينية الأخيرة الواصلة بين السفح/الجبل والغور، وبين القرية ومورد الماء، وبين الأرض ومن يرعاها. إن الحفاظ على هذه المساحات يعني صون إمكانية التواصل الجغرافي والاجتماعي الفلسطيني، وهو الشرط الضروري لأي أفق سياسي مستقبلي ممكن، في مواجهة منظومة استعمارية تسعى إلى تحويل المساحات المفرَّغة قسراً إلى جسور توسع استيطاني بلا حدود.