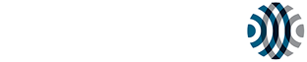كانت العقود الثمانية الماضية أطول فترة بلا حرب بين القوى العظمى منذ الإمبراطورية الرومانية. جاءت هذه الحقبة الاستثنائية من السلام الممتد بعد حربين كارثيتين، كانت كل منهما أكثر تدميرًا بكثير من الصراعات السابقة، لدرجة أن المؤرخين وجدوا من الضروري إنشاء فئة جديدة تمامًا لوصفها: الحروب العالمية. لو كان ما تبقى من القرن العشرين بنفس عنف الألفي عام السابقة، لكانت حياة كل من يعيش اليوم تقريبًا مختلفة جذريًا.
لم يكن غياب حروب القوى العظمى منذ العام 1945 محض صدفة. إن قدرًا كبيرًا من النعمة والحظ السعيد جزء من القصة. لكن تجربة الحرب الكارثية أجبرت أيضًا مهندسي نظام ما بعد الحرب على محاولة ثني مسار التاريخ. منحتهم التجارب الشخصية للقادة الأميركيين في الانتصار في الحرب الثقة للتفكير في ما لا يُصدق، ولفعل ما اعتبرته الأجيال السابقة مستحيلاً، وذلك ببناء نظام دولي قادر على إحلال السلام. ولضمان استمرار هذا السلام الطويل، يتعين على القادة الأميركيين والمواطنين على حد سواء إدراك مدى روعة هذا الإنجاز، وإدراك مدى هشاشته، وبدء نقاش جاد حول ما سيتطلبه استدامته لجيل قادم.
إنجازٌ خارق
ثلاثة أرقام تُلخص السمات المميزة - والنجاحات - لنظام الأمن الدولي: 80، 80، وتسعة. لقد مرّ 80 عامًا منذ آخر حرب ساخنة بين القوى العظمى. وقد مكّن هذا من تضاعف عدد سكان العالم ثلاث مرات، ومضاعفة متوسط العمر المتوقع، ونمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 15 ضعفًا. لو اكتفى رجال الدولة بعد الحرب العالمية الثانية بالتاريخ كالمعتاد، لكانت حرب عالمية ثالثة قد اندلعت. ولكن لخُوضت بالأسلحة النووية. لكانت الحرب التي أنهت كل الحروب.
مرّ 80 عامًا أيضًا على آخر استخدام للأسلحة النووية في الحرب. نجا العالم من عدة أزمات كاد أن تنتهي، أخطرها أزمة الصواريخ الكوبية، عندما واجهت الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي بشأن الصواريخ النووية في كوبا، والتي قدّر خلالها الرئيس جون كينيدي احتمالات نشوب حرب نووية بين واحد من ثلاثة وواحد من اثنين. ومؤخرًا، في العام الأول من حرب روسيا الشاملة على أوكرانيا التي بدأت عام 2022، هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جديًا بشن ضربات نووية تكتيكية. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، قدّرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية احتمالات توجيه ضربة نووية روسية بنسبة 50-50 إذا كان الهجوم المضاد لأوكرانيا على وشك اجتياح القوات الروسية المنسحبة. ردًا على ذلك، أُرسل مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى موسكو لنقل المخاوف الأيمركية. لحسن الحظ، ثبط التعاون المبتكر بين الولايات المتحدة والصين عزم بوتين، لكنه ذكّر بهشاشة المحظور النووي - وهو المعيار العالمي غير المعلن الذي يقضي باستبعاد استخدام الأسلحة النووية. اشترك في مجلة الشؤون الخارجية هذا الأسبوع.
في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، توقع قادة العالم أن تُصنّع الدول أسلحة نووية بمجرد اكتسابها القدرة التقنية اللازمة لذلك. تنبأ كينيدي بوجود ما بين 25 و30 دولة مسلحة نوويًا بحلول سبعينيات القرن الماضي، مما دفعه إلى الترويج لإحدى أكثر مبادرات السياسة الخارجية الأمريكية جرأة. اليوم، وقّعت 185 دولة على معاهدة حظر الانتشار النووي، متخليةً بذلك عن الأسلحة النووية. ومن اللافت للنظر أن تسع دول فقط تمتلك ترسانات نووية.
ومثل 80 عامًا من السلام وغياب الحروب النووية، فإن نظام حظر الانتشار - الذي أصبحت المعاهدة محوره - يُعدّ أيضًا إنجازًا هشًا. تمتلك أكثر من 100 دولة الآن القاعدة الاقتصادية والتقنية اللازمة لبناء أسلحة نووية. إن اختيارهم الاعتماد على الضمانات الأمنية من الآخرين أمرٌ غير طبيعي من الناحيتين الجيوستراتيجية والتاريخية. في الواقع، أظهر استطلاع رأي أجراه معهد آسان عام 2025 أن ثلاثة أرباع الكوريين الجنوبيين يُفضلون الآن امتلاك ترسانة نووية خاصة بهم للحماية من تهديدات كوريا الشمالية. وإذا تمكن بوتين من تحقيق أهدافه الحربية بإصدار أمر بشن ضربة نووية تكتيكية على أوكرانيا، فمن المرجح أن تستنتج الحكومات الأخرى أنها بحاجة إلى درع نووي خاص بها.
نهاية حقبة
نشر المؤرخ جون لويس غاديس عام 1987 مقالًا بارزًا بعنوان "السلام الطويل". لقد مرّ 42 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي حقبة من الاستقرار تُضاهي تلك التي امتدت بين مؤتمر فيينا عام 1815 والحرب الفرنسية البروسية عام 1870، والعقود التي تلت ذلك حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914. جادل غاديس بأن أساس هذا السلام الطويل الحديث هو الحرب الباردة. في ظل ظروف هيكلية كانت ستؤدي في العصور السابقة إلى حرب عالمية ثالثة على الأرجح، واجهت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بعضهما البعض بترسانات كافية لتحمل ضربة نووية والرد عليها بحزم. وصف الاستراتيجيون النوويون هذا الأمر بأنه دمار مؤكد متبادل، أو ما يُعرف اختصارًا بـ MAD.
بالإضافة إلى إنشاء الأمم المتحدة، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والترتيبات المتعددة الأطراف التي تطورت في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي، والبعد الأيديولوجي الشرس للتنافس الأميركي السوفيتي، جادل غاديس بأن العامل الرئيس للسلام هو الحكم المتبادل بأن المصالح النظامية تتفوق على المصالح الأيديولوجية. كره السوفييت الرأسمالية ورفض الأميركيون الشيوعية. لكن رغبتهم في منع الدمار المتبادل كانت أكثر أهمية. وكما أوضح، "يجب اعتبار اعتدال الأيديولوجيات، إلى جانب الردع والاستطلاع النوويين، آلية رئيسة للتنظيم الذاتي في سياسات ما بعد الحرب".
كما أدرك غاديس، انقسم العالم إلى معسكرين، سعت كل قوة عظمى فيهما إلى جذب الحلفاء وتحالف الدول حول العالم. أطلقت الولايات المتحدة خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا الغربية، وأنشأت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز التنمية العالمية، وسعت إلى إبرام الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لتحديد قواعد التبادل الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي. حتى أن الولايات المتحدة تخلت عن استراتيجيتها السابقة المتمثلة في تجنب التحالفات المتشابكة - وهي فكرة تعود إلى رئاسة جورج واشنطن - من خلال تبني منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والالتزام بمعاهدة مع اليابان. وواصلت السعي وراء أي خيار متاح لبناء نظام أمني دولي قادر على مواجهة تهديد الشيوعية السوفيتية. وكما أوضح أحدنا (أليسون) في مجلة الشؤون الخارجية: "لو لم يكن هناك تهديد سوفيتي، لما كان هناك خطة مارشال ولا حلف شمال الأطلسي".
كانت الحرب الباردة أساس السلام الطويل الحديث.
بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، أوائل التسعينيات، رحّب المنتصرون بعصر أحادي القطب جديد بقيت فيه الولايات المتحدة وحدها قوة عظمى. من شأن هذا النظام الجديد أن يجلب ثمار السلام، حيث يمكن للدول أن تزدهر دون القلق بشأن صراع القوى العظمى. حتى أن الروايات السائدة في العقدين الأولين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أعلنت "نهاية التاريخ". على حد تعبير عالم السياسة فرانسيس فوكوياما، كان العالم يشهد "نهاية التطور الأيديولوجي للبشرية وعولمة الديمقراطية الليبرالية الغربية كأحدث أشكال الحكم البشري". وباستخدام مطاعم ماكدونالدز كمثال، جادل توماس فريدمان في "نظرية الأقواس الذهبية لمنع النزاعات" بأن التنمية الاقتصادية والعولمة ستضمنان عصرًا من السلام. وقد ألهمت هذه الأفكار غزو الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق، مما ترك الولايات المتحدة غارقة في حروب لا نهاية لها بلا انتصارات لعقدين من الزمن.
وكانت الدبلوماسية الإبداعية أيضًا ركيزة أساسية في هذا الفصل من القصة. كان من المفترض أن يؤدي تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور روسيا و14 دولة مستقلة حديثًا في أوروبا الشرقية إلى زيادة في عدد الدول المسلحة نوويًا. فقد تُرك أكثر من 12,600 سلاح نووي خارج روسيا عند انهيار الاتحاد السوفيتي. تطلب الأمر شراكة استثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا الديمقراطية بقيادة الرئيس الروسي بوريس يلتسين، بتمويل من برنامج تعاوني لنزع السلاح النووي بقيادة السيناتورين الأميركيين سام نان وريتشارد لوغار، لضمان عدم وقوع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ. بحلول العام 1996، كانت الفرق قد أزالت الأسلحة النووية من الأراضي السوفيتية السابقة، وأعادتها إلى روسيا أو فككتها.
أعادت التغيرات الجيوسياسية التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفيتي ضبط علاقات الولايات المتحدة مع كل من خصومها السابقين ومنافسيها المتزايدين. عام 2009، عندما تولى باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة، وُصفت روسيا والصين بأنهما "شريكان استراتيجيان". وظل هذا الرأي سائدًا. ولكن بحلول الوقت الذي أصبح فيه دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة عام 2017، أدى واقع الصين الطموحة والصاعدة بسرعة، وروسيا الساخطة والانتقامية، إلى الاعتراف بأن الولايات المتحدة قد دخلت حقبة جديدة من التنافس بين القوى العظمى.
المخاطر القادمة
قبل وفاته عام 2023، ذكّر هنري كيسنجر زملاءه مرارًا وتكرارًا بأنه يعتقد أن هذه العقود الثمانية من السلام بين القوى العظمى من غير المرجح أن تصل إلى قرن كامل. من بين العوامل التي يُظهرها التاريخ وتُسهم في النهاية العنيفة لدورة جيوسياسية كبرى، تبرز خمسة عوامل قد تُنهي هذا السلام الطويل المستمر.
يتصدر القائمة فقدان الذاكرة. فالأجيال المتعاقبة من البالغين الأمريكيين، بمن فيهم كل ضابط عسكري في الخدمة، لا تملك ذاكرة شخصية عن التكاليف الباهظة لحرب القوى العظمى. قليلون هم من يدركون أنه قبل هذه الحقبة الاستثنائية من السلام، كانت الحرب في كل جيل أو جيلين هي القاعدة. يعتقد الكثيرون اليوم أن حرب القوى العظمى أمرٌ لا يُصدق - مُغفلين أن هذا ليس انعكاسًا لما هو مُمكن في العالم، بل هو انعكاس لحدود ما يُمكن أن تتخيله عقولهم.
إن وجود منافسين صاعدين يُهدد السلام أيضًا. فالصعود الصاروخي للصين يُشكل تحديًا للهيمنة الأمريكية، مُحاكيًا ذلك التنافس الشرس بين قوة راسخة وأخرى صاعدة، والذي حذّر المؤرخ اليوناني القديم ثوسيديديس من أنه سيؤدي إلى صراع. في بداية القرن الحادي والعشرين، لم تُفكّر الولايات المتحدة كثيرًا في منافسة الصين، التي كانت متأخرة عنها اقتصاديًا وعسكريًا وتكنولوجيًا. أما الآن، فقد لحقت الصين بالولايات المتحدة، بل وتجاوزتها، في مجالات عديدة، بما في ذلك التجارة والتصنيع والتقنيات الخضراء، وتتقدم بسرعة في مجالات أخرى. في الوقت نفسه، أظهر بوتين، الذي يترأس دولةً مُنهكة، لكنه لا يزال يمتلك ترسانة نووية قادرة على تدمير الولايات المتحدة، استعداده لاستخدام الحرب لاستعادة قدر من عظمة روسيا. مع تصاعد التهديدات الروسية وتراجع دعم إدارة ترامب لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تُكافح أوروبا لمواجهة التحديات الأمنية الحادة في العقود القادمة.
يُزيد التفاوت الاقتصادي العالمي من احتمالية نشوب حرب. تراجعت الهيمنة الاقتصادية الأمريكية مع تعافي دول أخرى من دمار الحربين العالميتين. في نهاية الحرب العالمية الثانية، وبعد تدمير معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى، كانت الولايات المتحدة تمتلك نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ ومع انتهاء الحرب الباردة، انخفضت حصتها إلى الربع. أما اليوم، فلا تمتلك الولايات المتحدة سوى سُبع الناتج المحلي الإجمالي. ومع هذا التحول في ميزان القوة الاقتصادية الوطنية، يبرز عالم متعدد الأقطاب، حيث يمكن لدول مستقلة متعددة أن تتصرف ضمن نطاق نفوذها دون طلب إذن أو خوف من عقاب. ويتسارع هذا التآكل عندما تُفرط القوة المهيمنة في توسعها المالي، كما يجادل مدير صندوق التحوط الشهير راي داليو بأن الولايات المتحدة تفعل اليوم.
عندما تُفرط قوة راسخة في توسعها العسكري - خاصة في صراعات تُصنف في مرتبة منخفضة ضمن قائمة مصالحها الحيوية - تضعف قدرتها على ردع القوى الصاعدة أو الدفاع عنها. كتب الفيلسوف الصيني القديم سون تزو: "عندما ينخرط الجيش في صراعات مطولة، تتقلص موارد الدولة"، وهو ما قد يصف التوسع المكلف لمهام القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، وعجز الجيش عن التركيز على تحديات أكثر إلحاحًا. وقد أدى تركيز الموارد بشكل ضيق على هذه الصراعات المطولة إلى صرف انتباه الولايات المتحدة عن تحسين قدراتها الدفاعية ضد خصوم متزايدي التطور والخطورة. ومما يثير القلق بشكل أكبر مدى انزلاق مؤسسة الأمن القومي الأميركية في حلقة مفرغة، بدعم من الكونغرس وصناعة الدفاع، حيث تطالب بمزيد من الموارد - زيادة التمويل - بدلًا من البحث عن طرق أكثر استراتيجية لمواجهة التهديدات الخطيرة لمصالحها الوطنية.
وأخيرًا، والأكثر إثارة للقلق، أن ميل قوة راسخة إلى الانزلاق إلى انقسامات سياسية مريرة في الداخل يُشل قدرتها على العمل بشكل متماسك على الساحة العالمية. ويزداد هذا الأمر صعوبةً عندما يتأرجح القادة بين مواقف متعارضة حول ما إذا كان ينبغي للبلاد الحفاظ على نظام عالمي ناجح، وكيفية تحقيق ذلك. هذا ما يتكشف اليوم: إدارة في واشنطن، تبدو حسنة النية ظاهريًا، تُقلب كل علاقة دولية قائمة، ومؤسسة، وعملية، رأسًا على عقب، لفرض رؤيتها حول كيفية تغيير النظام الدولي.
الدورات الجيوسياسية طويلة الأمد لا تدوم إلى الأبد.
السؤال الأهم الذي يواجه الأميركيين والنظام السياسي الأميركي المنقسم هو ما إذا كانت الأمة قادرة على استجماع قواها لإدراك مخاطر اللحظة الراهنة، واستنباط الحكمة اللازمة لتجاوزها، واتخاذ إجراءات جماعية لمنع - أو بالأحرى تأجيل - الأزمة العالمية القادمة.
للأسف، وكما لاحظ هيغل، نتعلم من التاريخ أننا في كثير من الأحيان لا نتعلم منه. عندما صاغ الاستراتيجيون الأميركيون استراتيجية الحرب الباردة التي شكلت أساس السلام، كانت رؤيتهم تتجاوز بكثير الحكمة التقليدية للعصور السابقة. إن الحفاظ على هذا الاستثناء الذي سمح للعالم بتجربة فترة غير مسبوقة دون حرب بين القوى العظمى يتطلب اندفاعًا مماثلًا من الخيال الاستراتيجي والتصميم الوطني.