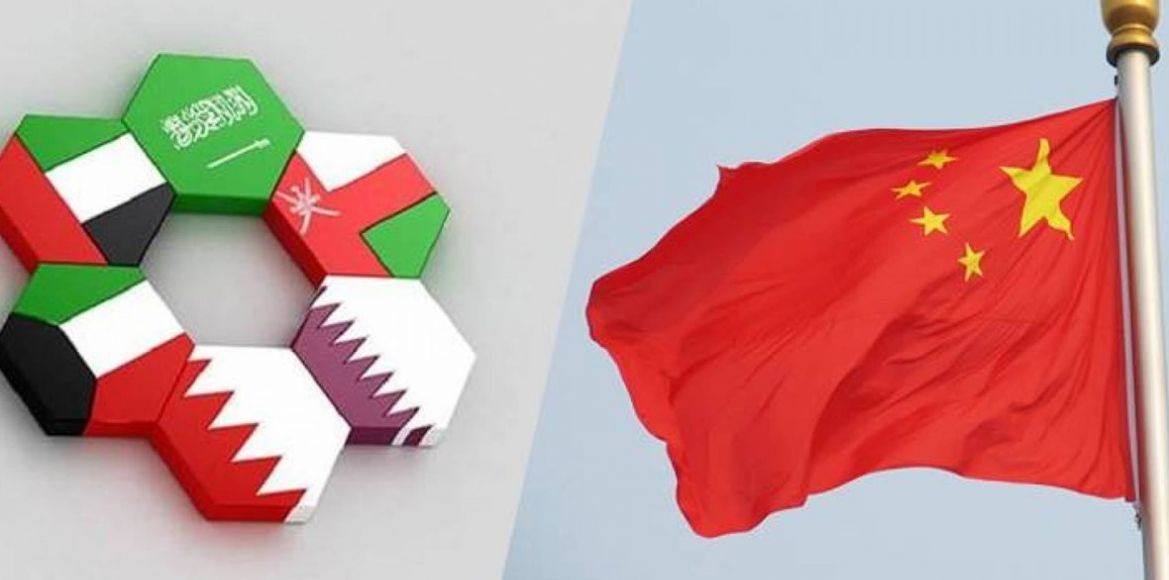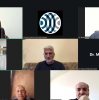لم تشهد العلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي تطورات نوعية كما شهدت هذه العلاقات مع الصين. جاءت هذه التحولات محصلة لتوافق كبير في مصالح الجانبين، كما جاءت محصلة لتحولات ضخمة على مستوى النظام العالمي، والتي كان لها انعكاساتها على إقليم الشرق الأوسط، وعلى مستوى توجهات السياسة الخارجية الصينية، والتي جاءت هي الأخرى- في بعض جوانبها- امتداداً لتحولات صينية داخلية تعمقت خلال السنوات الأخيرة. بمعنى أدق، فإن هذه التحولات النوعية في العلاقات الخليجية-الصينية جاءت محصلة لحزمة من التحولات التي تزامنت وتداخلت مع بعضها بشكل مكثف خلال السنوات الأخيرة.
وقد أبدت دول مجلس التعاون الخليجي درجة كبيرة من القدرة على التأقلم مع هذه التحولات، من خلال تعظيم أوراقها المختلفة، وتنويع شراكاتها الخارجية، ومحاولة تخفيف حالة الاعتمادية على الخارج. وقد احتلت الصين موقعاً مهماً في هذا السياق، حيث شهدت العلاقات بين الجانبين تعميق مساحات التعاون التقليدية، بالتوازي مع خلق “مساحات جديدة”. صحيح أن هذه “المساحات” الجديدة” لم تصل بعد إلى شكلها النهائي، ولم تُخْتَبَرْ درجة صلابتها واستقرارها بعد، لكنها تمتلك فرصاً كبيرة للنجاح، دون أن ينفي ذلك وجود بعض التحديات.
وتناقش الدراسة مجالين رئيسيين في العلاقات الخليجية-الصينية، الأول هو ما يمكن أن نطلق عليه “المجالات التقليدية” التاريخية، وتنصرف بالأساس إلى العلاقات الاقتصادية والمالية. برغم أن هذه العلاقات تركزت لفترة طويلة في تجارة النفط، لكنها شهدت تحولات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، في اتجاه توسيع هذه العلاقات وتعميقها؛ لتشمل مجالات نوعية مثل التصنيع، والموانئ البحرية، والتعاون المصرفي والمالي. وفي السياق ذاته، هناك إعادة اهتمام ملحوظ بموضوع منطقة التجارة الحرة، الذي قد يشهد نقلة خلال الفترة المقبلة. المجال الثاني الذي توليه الدراسة اهتماماً نسبياً هو قضية الأمن الإقليمي باعتباره أحد الملفات المهمة التي برزت في أجندة العلاقات بين الجانبين خلال العامين الأخيرين تحت تأثير مجموعة من التحولات التي تناقشها الدراسة، إلى جانب التحديات التي تواجه هذه المساحة الجديدة في علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع الصين.
أولاً: العلاقات الاقتصادية والتجارية
فيما يتعلق بالنفط، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية، تمثل المصدر الأهم للواردات الصينية من النفط، وذلك برغم تحديين مهمين يواجهان هذا الواقع المستقر منذ فترة. الأول، هو التوجه العالمي نحو الاعتماد على مصادر الطاقة غير الأحفورية بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص. وينطبق ذلك على الصين. التحدي الثاني هو انفتاح الصين على أقاليم واقتصادات أخرى مُصَدِّرة للنفط من خارج منطقة الخليج العربي، خاصة دول وسط آسيا وميانمار وأفريقيا. وهذا التوجه الصيني مدفوع بالاستراتيجية الصينية لضمان أمن الطاقة، والتي تقوم على تنويع مصادر الواردات الصينية من النفط والغاز. لكن برغم هذين التحديين فإن اقتصادات المجلس لا تزال تحظى بترتيب متقدم في سد الطلب الصيني على النفط. ويرجع ذلك إلى عوامل عدة، أهمها النمو المتزايد في حجم استهلاك الصين من الطاقة، ما يعني أن الانفتاح على مصدر لا يعني التحول عن مصادر أخرى. أضف إلى ذلك استمرار الوزن النسبي الكبير لمصادر الطاقة الأحفورية بالمقارنة بالمصادر الأخرى. كما أثبتت الاحتجاجات التي شهدتها كازخستان خلال شهر يناير 2022، والتي أدت إلى تراجع إنتاجها من النفط بسبب دعم المقاولين المحليين للاحتجاجات، إلى تزايد الأهمية النسبية لدول مجلس التعاون باعتبارها مصدراً يمكن الاعتماد عليه خلال الأزمات التي تواجه بعض الدول المُصَدِّرة للنفط.
من ناحية أخرى، أظهرت الحرب الروسية-الأوكرانية قدرة واضحة لدى دول مجلس التعاون الخليجي على السيطرة على السوق العالمي للنفط، وذلك برغم الضغوط الأمريكية لزيادة حجم المعروض من النفط -بهدف خفض الأسعار- الأمر الذي يشير في التحليل الأخير إلى قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على التصرف باستقلالية داخل هذه السوق.
ومن ثم، ليس من المتوقع تراجع الأهمية النسبية لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي كمصدر رئيسي للطاقة بالنسبة للصين في المدى القريب. وتشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الصين ستعتمد على الأسواق الخارجية لتوفير نحو 80%من احتياجاتها النفطية بحلول عام 2030، الأمر الذي يخلق فرصة كبيرة لزيادة حجم صادرات دول المجلس من النفط إلى الصين.
إضافة إلى الدور الذي يؤديه النفط في تعميق مستوى العلاقات الاقتصادية، هناك احتمال كبير لتوصل دول المجلس إلى اتفاق بشأن مشروع منطقة التجارة الحرة مع الصين، وهو المشروع قيد التفاوض منذ عام 2004. وقد عُقدت جولات تفاوض عدة منذ ذلك التاريخ. وأعاد الجانبان، في أثناء زيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي للصين في يناير 2022، تأكيد أهمية استكمال هذه المفاوضات في أقرب وقت ممكن “وإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين في أسرع وقت ممكن”. لا شك أن توقيع مثل هذه الاتفاق سيُسهم في توسيع حجم التجارة بين الجانبين.
كذلك، نجح الطرفان في خلق مساحة تعاون جديدة في المجال المصرفي، أخذت وجوهاً عدة. من ذلك على سبيل المثال، إدراج “البنك الصناعي والتجاري الصيني” ICBC إصدارين في سندات بورصة “ناسداك دبي” بقيمة إجمالية 1.4 بليون دولار (700 مليون دولار لكل منهما)، لتزيد بذلك القيمة الإجمالية لإدراجات البنك في “ناسداك دبي” إلى 3.56 مليار دولار موزعة على سبعة إصدارات. تبع ذلك إدراج إصدارين آخرين في أكتوبر 2019 بقيمة مليار دولار (500 مليون دولار لكل منهما)، لتصل القيمة الإجمالية لمجموع السندات المدرجة من قبل البنك في “ناسداك دبي” إلى 4.56 مليارات دولار أميركي عبر تسعة إدراجات، لتعد بذلك أكبر قيمة لإدراجات السندات في البورصة من قبل جهة إصدار خارجية. أضف إلى ذلك عمل مصارف صينية عبر فروعها المباشرة في الصين، الأمر الذي أعطى المعاملات المالية بين الجانبين ثقة أكبر، كما أعطى العملة الصينية فرصة أكبر للتدويل.
وأخيراً، وليس آخراً، شهدت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تعميقاً مهماً مع التحاق دول مجلس التعاون الخليجي بمبادرة الحزام والطريق. برغم أن التصورات الصينية الأولى للمبادرة ركزت على ربط منطقة غرب آسيا بالمبادرة عبر الممر الاقتصادي “الصين-وسط آسيا-غرب آسيا”، والذي يبدأ من مدينة شينجيانغ الصينية في اتجاه إيران، مروراً بدول آسيا الوسطى، وصولاً إلى سواحل البحر المتوسط وأوروبا. لكن لاحقاً أصبحت علاقة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بالمبادرة أكثر وضوحاً من خلال مشاركة بعض دول المجلس في منتدى الحزام والطريق الأول (مايو 2017)، والثاني (إبريل 2019)، وانضمامها إلى “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية” AIIB، الذي يمثل إحدى الأذرع المالية المهمة للمبادرة. وقد تبع ذلك توسيع مجالات التعاون بين الجانبين في مجالات مهمة، خاصة في قطاع الموانئ البحرية. ومن المتوقع أن تلعب المبادرة دوراً كبيراً في تعميق علاقات التجارة بين الجانبين من خلال الدور الذي ستلعبه في تخفيض تكاليف التجارة (إمدادات الشحن وتكاليفه، وتكاليف التأمين)، خاصة مع استكمال تطوير ميناء جوادر الباكستاني وشبكات السكك الحديدية داخل باكستان والتي ستربط الميناء بمدينة قاشجر الصينية (شمال غرب).
ثانياً: الانتقال إلى التعاون الأمني
كما سبق القول، شهدت السنوات الأخيرة انتقال العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين من المجالات التقليدية التاريخية إلى مجال نوعي وهو العلاقات السياسية والأمنية. كان أبرز مؤشرات هذا التحول استحداث أطر لإدارة العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين، أبرزها الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس والصين، والذي عقدت منه ثلاث جولات، ومن المخطط عقد الجولة الرابعة في المملكة العربية السعودية. لم تصل هذه العلاقات الأمنية بين الجانبين إلى شكلها النهائي بعد، لكن التحولات الدولية والإقليمية تمنح هذا التحول زخماً مستمراً.
تطورات عدة، دفعت بهذه العلاقات إلى مزيد من التنوع لتتجاوز الطابع الاقتصادي في اتجاه إعطاء القضايا الأمنية وزناً متزايداً. نشير فيما يلي إلى أبرز هذه التطورات.
1. تطور العلاقات الصينية-الإيرانية
شهدت العلاقات الصينية-الإيرانية تطورات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، تُوجت بتوقيع الطرفين في مارس 2021 اتفاق “التعاون الشامل” لمدة 25 عاماً. وقد أثار الاتفاق جدلاً شديداً، وذهب بعضهم إلى وجود أبعاد سرية لهذا الاتفاق، تمثل تمهيداً لدور أمني صيني كبير في المنطقة. لكن بعيداً عمَّا إذا كانت هناك نقاط سرية من عدمه، فإن الاتفاق ببنوده المعلنة يمثل في حد ذاته تطوراً مهماً في علاقة الصين بالمنطقة. فمن ناحية، يمثل الاتفاق أساساً قوياً لنفاذ الصين إلى قطاع الطاقة الإيراني، ومزيداً من اعتماد الصين على إيران في هذا المجال المهم في علاقات دول المجلس مع الصين؛ فبموجب الاتفاق، ستحصل الصين على تسهيلات كبيرة في هذا القطاع، منها إمكانية الدفع الآجل، والدفع باليوان الصيني، إلى جانب نسبة الخصم المرتفعة على أسعار السوق والتي قُدرت بنحو 32%. من ناحية ثانية، فإن الاتفاق يمثل أساساً قوياً لنفاذ الصين إلى قطاعات البنية التحتية والموانئ الإيرانية، الأمر الذي يمنح إيران ميزة نسبية على مسارات الحزام والطريق من خلال “ممر الصين-غرب آسيا”. ومن المتوقع أن يزداد الثقل النسبي لإيران على هذا المستوى في حالة استئناف العمل بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” JCPOA (الاتفاق النووي). من ناحية ثالثة، فإن الاتفاق قد يمهد لزيادة حجم مبيعات السلاح الصينية لإيران؛ برغم أن واردات السلاح الإيرانية لا تزال محدودة بالمقارنة بمعظم دول الشرق الأوسط، لكنها تمثل سوقاً واعدة، خاصة مع فشل الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرارها داخل مجلس الأمن في أغسطس 2020 بتجديد حظر تجارة السلاح المفروض على إيران،حيث أصبح وقف الحظر سارياً منذ منتصف أكتوبر 2020. وفي إشارة واضحة لسعيها إلى زيادة حصتهما من سوق السلاح الإيراني، وقفت الصين وروسيا بقوة وراء إلغاء هذا الحظر داخل مجلس الأمن. وتجدر الإشارة هنا إلى أن روسيا جاءت في الترتيب الأول بين مصادر التسليح الإيرانية خلال المدة (2000-2020) تلتها الصين، ثم أوكرانيا، وكوريا الشمالية، وبيلاروس، حيث بلغت قيمة واردات السلاح من هذه الدول الخمس خلال هذه المدة: 2080، 781، 262، 257، 53 مليون دولار على الترتيب، بإجمالي 3433 مليون دولار.
فرض الملف الإيراني بشكل عام، وتداعيات الاتفاق الصيني-الإيراني، بشكل خاص، نفسه بقوة على علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع الصين، على نحو زاد من الأهمية النسبية للقضايا الأمنية في علاقات الجانبين. ووفقاً لتقارير عدة حول اجتماعات وزراء الخارجية التي جرت في يناير 2022، فقد فرض هذا الملف نفسه على المباحثات المشتركة.
ليس من المتوقع أن تتراجع الصين عن هذا الاتفاق، كما ليس من المتوقع أن تُحجِم من علاقاتها بإيران، لكن سيظل هذا الملف أحد الملفات الأساسية في علاقات الطرفين، لحين وضوح مستقبل الاتفاق النووي، وتداعياته على مسار العلاقات الإيرانية-الأمريكية، وما إذا كان سينعكس ذلك على مسار العلاقات الصينية-الإيرانية ومستواها.
2. المراجعة الأمريكية لحجم الالتزامات الأمنية والدفاعية تجاه الشرق الأوسط
هناك مراجعة أمريكية لحجم التزاماتها الدفاعية والأمنية في إقليم الشرق الأوسط، بما في ذلك عدم التورط في حروب إقليمية جديدة، وتحجيم مستوى وجودها العسكري المباشر في المنطقة، لمصلحة التركيز على “التهديد الصيني”. سيترتب على هذا التوجه الأمريكي الجديد تداعيات مهمة بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. أولها، مراجعة العلاقات الأمريكية-الإيرانية. وقد بدأ ذلك بالفعل مع سعي إدارة بايدن إلى استئناف العمل بالاتفاق النووي الموقع في 2015، وما انطوى على ذلك من تنازلات أمريكية واضحة، أبرزها عدم ربط المباحثات الجارية بالسياسات الإيرانية في الإقليم، أو القدرات العسكرية الإيرانية التقليدية، وعلى رأسها القدرات الصاروخية والطائرات المسيَّرة، أو الحرس الثوري الإيراني. ثانيها، تخفيض حجم الوجود العسكري الأمريكي داخل دول مجلس التعاون الخليجي؛ وقد بدأ هذا التوجه في الربع الأول من عام 2021، أشار إليه تقرير صادر عن Wall Street Journal في الأول من إبريل 2021، ذهب إلى أن إدارة بايدن قامت بسحب ثلاث بطاريات صواريخ على الأقل من منظومات “باتريوت” للدفاع الجوي من المنطقة، ووجود اتجاه إلى سحب منظومة “ثاد”. وقد تأكد هذا التوجه في يونيو 2021، عندما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في 18 يونيو 2021 سحب المزيد من القوات العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي من المنطقة، شملت -حسب صحيفة “وول ستريت جورنال”- ثماني بطاريات مضادة للصواريخ من العراق والكويت والأردن والسعودية، إضافة إلى درع “ثاد” المضاد للصواريخ الذي نُشِرَ في السعودية. ويعني سحب تلك البطاريات ضمنيًّا رحيل آلاف الجنود الأمريكيين من المنطقة المخصصين للعمل على هذه البطاريات. وبرغم تأكيد وزارة الدفاع الإبقاء على “وجود عسكري قوي في المنطقة، بما يتناسب مع التهديد”، لكن ذلك يعني أن تراجع مستوى التهديد حسب الرؤية الأمريكية سوف يستتبعه تخفيض هذا الوجود.
هذا التوجه الأمريكي سوف يستتبعه بالتأكيد اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز قدراتها الدفاعية اعتماداً على مصادر أخرى، خاصة في ظل وجود تباين واضح بينها وبين الولايات المتحدة حول مستوى التهديدات الأمنية في المنطقة وطبيعتها. وتمثل حالة إيران مثالاً مهماً على هذا التباين. ومن المتوقع اتساع هذا التباين في ظل تراجع الأهمية الاستراتيجية لنفط الخليج بالنسبة للولايات المتحدة حسب تحليلات عدة. فضلاً عن صعوبة الاعتماد على القدرات العسكرية للفاعلين المحليين، بالنظر إلى الحاجة الماسة إلى قدرات بحرية تتناسب مع طبيعة التهديدات المتزايدة المرتبطة بالبحار والمضايق البحرية الاستراتيجية.
3. اتجاه قوى دولية إلى محاولة ملء الفراغ الأمني والطلب المتوقع على دور أمني من خارج الإقليم
بالتوازي مع تصاعد السجال حول مستقبل الالتزامات الدفاعية والأمنية تجاه الإقليم، بدأت روسيا، ثم الصين، طرح مبادرات أمنية محددة تجاه الإقليم. فقد طرحت روسيا في يوليو 2019 إنشاء نظام أمني في منطقة الخليج، يقوم على تحسين شروط الاستقرار والأمن، وحل النزاعات، والتعامل مع مرحلة ما بعد الأزمات. وطرحت الرؤية الروسية مجموعة من المبادئ التي يجب أن تحكم عمل هذا النظام، تحددت في تسعة مبادئ، أهمها: العمومية والشمول، بمعنى أن يقوم النظام الأمني على احترام مصالح جميع الأطراف الإقليمية وغير الإقليمية المعنية، وأن يشمل جميع مجالات الأمن، بما في ذلك الأبعاد العسكرية والاقتصادية والطاقة، فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية للدول والمجتمعات المأزومة؛ والتزام مبدأ “تعددية الأطراف”، بمعنى دمج جميع الأطراف المعنية بأمن المنطقة، سواء في عمليات تقييم حالات التهديد القائمة، أو عملية صنع القرارات وتنفيذها، والتزام المنهج التدريجي للوصول إلى هدف بناء النظام الأمني، على أن يتم البدء بالمشكلات الملحة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتسوية الأزمات العراقية واليمنية والسورية، وتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ وشروع دول الخليج والمجتمع الدولي في تطبيق تدابير لبناء الثقة وتوفير ضمانات أمنية متبادلة في المنطقة، وأن يكون إنشاء نظام أمني في منطقة الخليج جزءاً من تحقيق الأمن في إقليم الشرق الأوسط ككل.
تلا ذلك طرح الصين في مارس 2021 مبادرتها لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. تضمنت خمسة عناصر رئيسية: الأول، هو “الاحترام المتبادل”؛ وركزت المبادرة هنا على ضرورة التعامل مع دول الإقليم باعتبارهم شركاء في التعاون والتنمية والسلام، بدلاً مما أسمته “المنافسة الجغرافية”، والتسوية السياسية للمشكلات الإقليمية. إلى جانب تعزيز الحوار والتبادلات بين مختلف الحضارات بالإقليم بهدف تحقيق التعايش السلمي بين جميع القوميات. وأكدت الصين أنها ستلعب “دوراً بناءً” لتحقيق هذه الغاية. الثاني، “دعم الإنصاف والعدالة”، وينصرف تحديداً إلى أهمية تسوية القضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. وأشارت المبادرة هنا إلى دعم ما وصفته بـ”الوساطة النشطة” للمجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف، وعقد مؤتمر دولي رسمي حول هذا الموضوع “عندما تكون الظروف مناسبة”. الثالث، عدم الانتشار النووي، حيث ركزت المبادرة على ضرورة العودة إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة” مع إيران، ودعم المجتمع الدولي لجهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. الرابع، تعزيز الأمن الجماعي المشترك؛ من خلال مراعاة ما وصفته المبادرة بـ”الشواغل المشروعة” لجميع الأطراف، وتشجيع الحوار والتشاور على أساس من المساواة والتفاهم المتبادل والتوافق بين دول الخليج العربي. واقترحت الصين هنا عقد مؤتمر متعدد الأطراف للأمن الإقليمي في منطقة الخليج، بهدف استكشاف فرص إنشاء “آلية لبناء الثقة في الشرق الأوسط”، على أن يتم البدء بمناقشة قضايا مثل ضمان سلامة المنشآت النفطية وممرات الشحن، ثم الانتقال في مرحلة تالية إلى بناء “إطار عمل لأمن جماعي شامل وتعاوني ومستدام في الشرق الأوسط”. الخامس، هو تسريع التعاون الإنمائي في الإقليم؛ وطرحت المبادرة مساعدة البلدان الخارجة من الصراع على إعادة البناء والإعمار، ودعم الدول المنتجة للنفط على تحقيق تنوع أكبر في مصادر النمو الاقتصادي. كما تضمنت المبادرة في السياق نفسه التزام الصين باستمرار عقد “المنتدى الصيني-العربي للإصلاح والتنمية”، والذي عُقدت دورته الأولى في 2018، و”منتدى الأمن في الشرق الأوسط”، بهدف زيادة تبادل الخبرات في مجال الحكم الرشيد مع دول الإقليم، وهي منتديات تجمع بين أكاديميين وسياسيين عرب وصينيين.
ثالثاً: تعقيدات التعاون الأمني الصيني-الخليجي
بصرف النظر عن طبيعة هذه المبادرات ومضمونها، ومدى توافقها مع رؤية دول مجلس التعاون الخليجي حول طبيعة مصادر التهديد في المنطقة، وطريقة التعامل مع هذه التهديدات، لكن هذه المبادرات تمثل في التحليل الأخير تعبيراً عن تفاعل هاتين القوتين الدوليتين المهمتين مع الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وتقديم نفسها باعتبارها “قوى أمنية”. صحيح أن أي من الصين أو روسيا لم تصل بعد إلى طرح نفسها -حسب المبادرتين السابقتين- كمصدر لمظلة أمنية بديلة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن النقطة المهمة التي تعكسها المبادرتان أنهما تقدمان أساساً للحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وهذه القوى حول أمن منطقة الخليج العربي.
إذا كان تأسيس حوار معمق بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا حول أي دور أمني لها في المنطقة سيظل مؤجلاً لأجل غير معلوم، وسيظل مرهوناً بالتداعيات الاستراتيجية النهائية للحرب الروسية-الأوكرانية، فإن ذلك قد لا ينطبق بالدرجة نفسها على المبادرة الصينية. فقد أبدت دول مجلس التعاون الخليجي درجة من المرونة في الانفتاح على الصين. وعلى العكس من مرحلة ما بعد إعلان المبادرة مباشرة، والتي اتسمت بغياب ردود فعل أو تفاعل واضح معها، فإن التحولات السابق الإشارة إليها، خاصة تزايد احتمالات العودة إلى الاتفاق النووي وتطبيع العلاقات الأمريكية مع إيران، وتخفيض حجم الوجود العسكري الأمريكي المباشر في المنطقة وإعادة توزيع الالتزامات والأعباء الدفاعية بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في الإقليم، تخلق فرصة كبيرة لحوار خليجي-صيني حول قضايا الأمن الإقليمي. يعدُّ الحوار الصيني مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير الماضي، والذي تضمنت أجندته، إلى جانب القضايا الاقتصادية التقليدية، قضايا أمنية أبرزها إيران، مؤشراً مهماً في هذا الاتجاه.
لقد بدت المبادرة الصينية بعناصرها السابقة بعيدة عن التصور الخليجي لمصادر التهديد في المنطقة، وعلى رأسها السياسات الإيرانية في الإقليم، لكن تحولات مهمة قد تسهم في تكسير الفجوة بين دول المجلس والصين بشأن بعض عناصر المبادرة. وأهم هذه التحولات هو بدء الحوار السعودي-الإيراني، الذي عُقدت منه خمس جولات حتى الآن (أربع جولات خلال عام 2021، وجولة خلال شهر إبريل 2022). نجاح هذا الحوار، قد يسهم بلا شك في تكسير الفجوة الخليجية-الإيرانية حول عدد من القضايا، على نحو قد يؤسس لتوافق خليجي-صيني مماثل بشأن موقع إيران ضمن المبادرة الصينية، خاصة أن المبادرة تقوم على فكرة دمج إيران في المنظومة الأمنية الإقليمية المقترحة.
من ناحية أخرى، فإن استئناف العمل بالاتفاق النووي مع إيران سيخلق بلا شك واقعاً سياسياً جديداً في الإقليم، قد يدفع دول المنطقة إلى تطبيق سياسات مختلفة مع إيران، بعيداً عن المواجهة معها، تتراوح بين الردع والدمج الأمني المحسوب في الإقليم المبني على حزمة من إجراءات بناء الثقة دون أن تصل بالضرورة إلى بناء إطار أمني إقليمي على الأقل في المدى المنظور.
ولا يعني ذلك أن التعاون الأمني بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لا يواجه تحديات ضخمة. أول تلك التحديات يتعلق بموقف الولايات المتحدة من هذا التعاون؛ فإذا افترضنا أن المراجعة الأمريكية الجارية لطبيعة التزاماتها العسكرية والأمنية ومستواها تجاه إقليم الشرق الأوسط هدفها الأساسي هو التفرغ للتهديد الصيني، فليس من المتوقع أن تقبل الولايات المتحدة في هذه الحالة ملء الصين لأي فراغ أمني محتمل في الإقليم نتيجة هذه المراجعة.
من ناحية ثانية، فإنه برغم حرص الصين على استغلال التحولات الجارية على مستوى النظام الدولي وإقليم الشرق الأوسط لتقديم نفسها كفاعل دولي بات يضطلع بدور متزايد في حماية الأمن العالمي، لكن هذا الدور لا يزال حتى الآن محكوم بالتوازنات الدولية، وبالمرحلة الراهنة في مسار العلاقات الصينية-الأمريكية؛ إذ لا تزال السياسة الصينية حريصة -حتى الآن- على تجنب الصدام المباشر مع الولايات المتحدة خارج مناطق تركز مصالحها الحيوية، والتي تتمثل في المنطقة الممتدة من بحر الصين الشرقي إلى بحر الصين الجنوبي، مروراً بتايوان. كما لا تزال هذه السياسة محكومة أيضاً باعتبار آخر وهو تجنب تحمل أعباء حماية الأمن العالمي بشكل لا يتناسب مع القدرات الصينية. وبرغم أن الصين اتخذت عدداً من الخطوات التي تمثل خروجاً عن هذه السياسة التاريخية، أبرزها بناء قواعد عسكرية خارج الأراضي الصينية (قاعدة جيبوتي التي افتُتحت في أغسطس 2018، والقاعدة المخطط بناؤها في غينيا الاستوائية على المحيط الأطلنطي حسب تقرير لمجلة The Wall Street Journal المنشور في 5 ديسمبر 2021، وتعديل “قانون الدفاع الوطني الصيني” في 26 ديسمبر 2020 ليسمح للصين بلعب دور أمني خارج حدودها)، لكن هذه التحولات لا تعني حتى الآن اتجاه الصين إلى الاضطلاع بدور أكبر في حماية الأمن العالمي أو الأمن الإقليمي خارج منطقة مصالحها الحيوية السابق الإشارة إليها. وحتى الآن لم تُخْتَبَرْ ردود الفعل الصينية في حالة تعرض مصالحها لتهديد مباشر خارج هذه المناطق.
خلاصة القول إذن، إن علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع الصين تشهد تحولات مهمة في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات الأمنية التي حظيت بأهمية متزايدة خلال العامين الأخيرين، لكن هذه التحولات تظل مرهونة بعدد من التطورات الجارية في هيكل النظام العالمي. وستعتمد الاستفادة من هذه التحولات على قدرة الصين ودول مجلس التعاون على قراءة دقيقة لهذه التحولات، وتعظيم المكاسب المشتركة من خلال وضع علاقات الجانبين في إطار غير صفري مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تنعكس التحولات المهمة في مجال العلاقات الأمنية بين الجانبين على “خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون والصين خلال المدة (2022-2025)” والتي ستُوقَّع قريباً حسب البيان الصادر عن اجتماع أمين عام مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الصيني في يناير 2022.