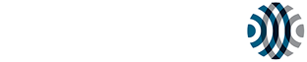خلفية تاريخية مختصرة
بعد النكبة عام 1948، ظلّ الفلسطينيون بلا إطار سياسي جامع لسنوات جرت محاولات مبكرة، أبرزها حكومة عموم فلسطين التي وُلدت بإرادة فلسطينية لكنها أُجهضت سريعًا بتقاطعات عربية ودولية.
وفي عام 1964، تأسست منظمة التحرير الفلسطينية بقرار من القمة العربية في القاهرة، برئاسة أحمد الشقيري، لتكون الإطار الجامع للشعب الفلسطيني، وتتولى مسؤولية النضال السياسي والعسكري من أجل التحرير.
مع الزمن، ومع دخول فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة فتح إلى المنظمة، اكتسبت شرعيتها الميدانية والشعبية، حتى جاء قرار قمة الرباط عام 1974 باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"،باقرارها البرنامج المرحلي العشر نقاط وبدء الدخول فى العملية السياسية ،وأيضا فى العام نفسه حصلت على بعثة مراقب فى الجمعية العامة.
لكن مع مرور الوقت، وُجدت تحولات في المواقف، ففي عام 1988 طلب من الرئيس عرفات إدانة العنف والإرهاب، وفي 1994 تم تبادل رسائل اعتراف مع إسرائيل، تضمنت الاعتراف بحقها في الوجود، مع موقف واضح ضد من يرفض أو يقاوم اتفاق أوسلو والاتفاق نفسه لم يشير لا تلميحا او تصريحا أن نهاية المفاوضات دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧.
وفي 1996، شُطبت البنود المتعلقة بالمقاومة وذكر إسرائيل كدولة عدو فى اجتماع عاجل للمجلس الفلسطيني بمن حضر فى غزة -مركز رشاد الشوا بحضور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بل كلنتون، هذه التحولات ليست مجرد تعديلات إدارية، بل تعكس تغيّرًا في جوهر المنظمة ومهمتها فهذه يفترض ان تكون من المحرمات التي لا يجوز المساس بها ، ويجب أن تُعمل دائمًا لتحقيقها، بعيدًا عن أي أجندات خارجية.
إعلان الدولة في الجزائر عام 1988 أعطى دفعة معنوية، لكنه ارتكز على قرارات دولية مثل 181 و242، ما قيد سقف التطلعات. ثم جاء اتفاق أوسلو عام 1993 ليحوّل المنظمة تدريجيًا إلى سلطة ذات صلاحيات محدودة تحت الاحتلال، مقابل التزامات أمنية واقتصادية واضحة، أبرزها التنسيق الأمني ونظام المقاصة.
من السيف إلى التحفة
حين مُنحت المنظمة لقب الممثل الشرعي، كان الأمل أن تبقى درعًا يحمي القضية وسيفًا يفتح طريق التحرير.
لكن السيف تحول إلى قطعة في متحف التاريخ، والدرع صار غطاءً هشًّا، يُستحضر في الخطب أكثر مما يُستخدم في الميدان.
اليوم، تعيش المنظمة حالة تحنيط سياسي ،مؤسسات شبه معطلة، اجتماعات شكلية، وقرارات إما مؤجلة أو موجّهة.
الإطار التمثيلي اندمج في سلطة تنفيذية محدودة الصلاحيات، تحكمها معادلة قاسية: الأمن مقابل المقاصة، والتنسيق مقابل البقاء.
ما حدث لم يكن تنازلاً عابرًا، بل إقرارًا رسميًا من منظمة التحرير نفسها، التي رضخت لتفريغ ميثاقها من جوهره النضالي، فالمنظمة لم تعد تمثل حاضنة وطنية جامعة، بل صارت مؤسساتها وأدبياتها رهينة لمصالح سياسية داخلية وخارجية.
وفي المقابل، يتعامل المجتمع الدولي مع هذه الكيانية ليس كمؤسسة وطنية ذات سيادة تمثل شعبًا، بل كهيئة شكلية تُستخدم في أدوات سياسية وتجارية، تُمارس فوقها أحياناً ضغوط دولية وإقليمية، فيما تُغنى أحزاب وفصائل ونخب على ألحان متباينة، تبرر كلٌ منها موقفه وتفسره حسب مصلحته.
اليوم، تحولت منظمة التحرير — التي كانت في يوم ما الإطار الجامع للشعب الفلسطيني — إلى ما يشبه رمزًا جامدًا يُستحضر للتاريخ أكثر مما يتحرك للواقع، حتى أن بعض المستفيدين من بقائها على هذا الشكل لا يرون في الأمر سوى تسليم كامل لمفاتيح القرار للمنظمة والسلطة، مهما صمتت عن أحداث جسيمة، مثل مأساة غزة التي امتدت لعامين.
كل فصائل العمل الوطني، بما فيها حماس التي فازت في أول انتخابات تشريعية حرة، بقيت خارج دائرة القرار الفعلي، طالما أن أبو مازن، الذي ورث عن ياسر عرفات ألقاباً ومناصب متعددة — رئيس دولة فلسطين، رئيس منظمة التحرير، رئيس السلطة الوطنية، القائد العام لقوات الثورة — جمع السلطات في يد واحدة، فاختلطت الأدوار وتداخلت المسؤوليات، حتى صار المشهد الفلسطيني يفتقد الفصل بين الرمزية التاريخية ومتطلبات الفعل السياسي الحاضر.
الطلسم المغلق:
-"الشرعية" صارت لقبًا تاريخيًا يُعامل كأنه لا يسقط بالتقادم.
-"الممثل الشرعي" لا يُنتخب من الشعب، بل يُجدد له في غرف مغلقة.
"الوحدة الوطنية" تُستحضر كشعار لإسكات أي دعوة للتغيير، حتى لو كانت سلمية وبنّاءة.
-مصطلح "السلطة الفلسطينية" يشير إلى كيان إداري محدود الصلاحيات، وهو ليس الدولة، بل سلطة فلسطينية مقيدة ضمن ظروف الاحتلال، وهذا التحديد مهم لفهم حدود شرعيتها القانونية والسياسية.
تفكيك الطلسم بهدوء
لا يحتاج الأمر إلى انقضاض أو عنف، بل إلى وعي وخطوات عملية:
١.إحياء مؤسسات التمثيل عبر انتخابات حقيقية وشاملة، في الداخل والخارج.
2. فصل السلطة التنفيذية عن الإطار التمثيلي حتى لا تتحول منظمة التحرير إلى دائرة خدمات.
3. إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال من "أمن مقابل مقاصة" إلى "كفاح مقابل حرية".
الخاتمة:
المنظمة هي رمز وطني كبير لقضية وطنية عظيمة، لكن إن وجدت كـ"بئر معطلة" أو قصر مشيد " لا تخدم تطلعات شعبها، فالمسؤولية تفرض علينا النظر بموضوعية نحو ضرورة التقييم والمراجعة.
التمسك بالاسم أو المؤسسة لا يجب أن يكون على حساب الروح والأهداف التي أنشئت من أجلها.
الشرعية الحقيقية تُقاس بإرادة شعب حي، وبالقدرة على النهوض بقضيته، لا بتجميد الواقع أو القبول بخطوط عريضة لا تعبر عن ما يريده الشعب.
من باب الوفاء للذاكرة النضالية ولأهداف التحرير، لا بد من فتح آفاق جديدة تُعيد بناء الشرعية الوطنية في ضوء التحديات الراهنة، وتحمي القضية من الانحرافات أو الاستغلال، مع احترام المؤسسة ومكانتها التاريخية.