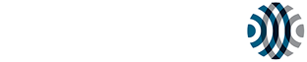لقد انتهى نظام التجارة العالمي كما عرفناه. لقد توقفت منظمة التجارة العالمية فعليًا عن العمل، إذ فشلت في التفاوض على التزامات أعضائها أو مراقبتها أو إنفاذها. وتُهمل مبادئ أساسية، مثل مبدأ "الدولة الأكثر رعاية"، الذي يُلزم أعضاء منظمة التجارة العالمية بمعاملة بعضهم البعض على قدم المساواة إلا في حال التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة، مع تهديد واشنطن أو فرضها تعريفات جمركية تتراوح بين 10في المئة وأكثر من 50 في المئة على عشرات الدول. وتعكس كلٌّ من استراتيجية "أميركا أولاً" التجارية، واستراتيجيتي "التداول المزدوج" و"صنع في الصين 2025" الصينيتين، تجاهلًا صارخًا لأي مظهر من مظاهر النظام القائم على القواعد، وتفضيلًا واضحًا لنظام قائم على القوة ليحل محله. وحتى لو نجحت أجزاء من النظام القديم في البقاء، فإن الضرر قد وقع: لا عودة إلى الوراء.
سيحتفل الكثيرون بنهاية حقبة. في الواقع، على الرغم من أن استخدام الرئيس دونالد ترامب العدواني للرسوم الجمركية وتجاهله للاتفاقيات السابقة قد دقّ المسمار الأخير في نعش النظام، إلا أن هذا التحول ضد التجارة العالمية لاقى ترحيبًا واسعًا من الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن على مدار السنوات القليلة الماضية. ولكن قبل أن يفرح المنتقدون بزوال نظام التجارة القائم على القواعد، عليهم أن يدرسوا التكاليف والتنازلات التي تصاحب تفكيكه، وأن يفكروا مليًا في العناصر التي ينبغي إعادة بنائها، حتى لو كانت بأشكال مختلفة، لتجنب عواقب أسوأ بكثير على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
إذا استمرت واشنطن في مسارها الحالي - الذي يتميز بالأحادية والمعاملاتية والنزعة التجارية - فستكون العواقب وخيمة، لاسيما مع استمرار بكين في مسارها المدمر المتمثل في دعم الطاقة الإنتاجية الفائضة، وسياسات التصدير الجشعة، والإكراه الاقتصادي. إن خطر لعب الولايات المتحدة والصين وفق قواعدهما الخاصة، حيث القوة هي القيد الحقيقي الوحيد، يكمن في العدوى: فإذا عمل أكبر اقتصادين في العالم خارج النظام القائم على القواعد، ستتبعه دول أخرى بشكل متزايد، مما يؤدي إلى تزايد حالة عدم اليقين، وتراجع الإنتاجية، وانخفاض النمو الإجمالي.
ومع ذلك، فإن التشبث بالنظام القديم والتطلع إلى استعادته سيكون ضربًا من الوهم والعبث. فالحنين إلى الماضي ليس استراتيجية، وكذلك الأمل. إن النظر إلى ما وراء الهياكل القائمة لا يعني مجرد قبول حالة الطبيعة الهوبزية. يكمن التحدي في خلق نظام قواعد خارج النظام القديم القائم على القواعد.
سيتطلب ذلك البدء من جديد. الخيار الأمثل للمضي قدمًا هو بناء نظام يتألف من تحالفات بين أصحاب الفكر المتشابه، تُشكل معًا شبكة علاقات متعددة الأطراف مفتوحة، أصغر حجمًا وأكثر مرونة من نظام التجارة المتعدد الأطراف. سيكون بعض هذه التحالفات آلياتٍ للتكامل التجاري وتحرير التجارة، بينما قد تُستخدم تحالفات أخرى لتأمين سلاسل التوريد أو حتى لتقييد التجارة خدمةً للأمن القومي. ستكون بعض الدول أعضاءً في تحالفات متعددة ذات أهداف متنوعة، ومن المرجح أن تتداخل عضويات هذه التحالفات وتتغير هندستها. من وجهة نظر اقتصادية بحتة، سيكون هذا النظام دون المستوى الأمثل وأقل كفاءةً من نظام التجارة العالمي. ولكنه قد يكون النتيجة الأكثر استدامةً سياسيًا، والتي يمكنها - والأهم من ذلك - منع الأحادية من الخروج عن السيطرة. باختصار، سيسمح هذا النظام باقتصاد عالمي تُشكله القواعد حتى في غياب نظام عالمي قائم على القواعد. حاضرٌ عند الدمار
تطور النظام التجاري العالمي كجزءٍ من البنية الاقتصادية المتعددة الأطراف التي قادت الولايات المتحدة بنائه، بدءًا من الحرب العالمية الثانية وحتى السنوات الأولى من هذا القرن. إلى جانب مؤسساتٍ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أسست واشنطن أولًا الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، التي وضعت مجموعةً من القواعد، مثل مبدأ الدولة الأكثر رعاية، وأنشأت آليةً تفاوضت الدول من خلالها على التزامات فتح الأسواق. ثم عام 1995، أسست منظمة التجارة العالمية. أدخلت اتفاقية جولة أوروغواي لعام 1994، التي أسست منظمة التجارة العالمية، مجموعةً من الضوابط التجارية الجديدة وإجراءً ملزمًا لتسوية النزاعات، مما مثّل خطوةً كبيرةً إلى الأمام في تعزيز النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد. عند تأسيسها، كانت منظمة التجارة العالمية تضم 76 دولةً عضوًا؛ واليوم، تضم أكثر من 169 دولةً عضوًا، تُمثل 98 في المئة من التجارة العالمية.
عقب الحرب الباردة، أمل صانعو السياسات الأميركيون أن يتوسع نظام التجارة القائم على القواعد الذي تبلور في معظم أنحاء العالم غير الشيوعي في العقود السابقة، ليشمل خصومًا سابقين للولايات المتحدة، مثل روسيا، وأسواقًا ناشئة، مثل الصين. ومن شأن هذه القواعد أن تعزز الاستقرار، وتشجع الانفتاح والتكامل، وتسهل الحل السلمي للنزاعات الاقتصادية، بما يعود بالنفع الاقتصادي والاستراتيجي على الولايات المتحدة. ومع ذلك، حتى قبل أن يكتمل تطبيق هذا النظام، ظهرت معارضة له، بدءًا من أوائل التسعينيات مع الجدل الحاد حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). وقد قوبل أول اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في الولايات المتحدة، في سياتل عام 1999، باحتجاجات حاشدة تصدرت عناوين الصحف.
نالت السياسة التجارية من الثناء واللوم ما لا تستحقه في المناقشات الاقتصادية التي شهدتها العقود الأخيرة. ويميل منتقدو النظام إلى الخلط بين آثار العولمة وآثار السياسة التجارية. لم تكن العولمة نفسها مرتبطة باتفاقيات التجارة بقدر ارتباطها بالتكنولوجيا - وخاصة اختراع حاوية الشحن وانتشار النطاق العريض. ومنذ ستينيات القرن الماضي، خفضت الحاويات بشكل كبير من تكلفة شحن البضائع بحراً وبراً، كما كانت هناك تحسينات في كفاءة الشحن الجوي. ووجدت ورقة عمل صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية عام 2023 من تأليف شارات غاناباتي وووان فونغ وونغ أنه في الفترة من 1970 إلى 2014، انخفضت كلفة نقل البضائع بالوزن بين 33 و39 في المئة، وانخفضت تكلفة نقل البضائع بالقيمة بين 48 و62 في المئة. كل هذا جعل تطوير سلاسل التوريد العالمية للسلع أكثر جاذبية. وينطبق الشيء نفسه على التجارة في الخدمات مع انتشار أجهزة الكمبيوتر والوصول إلى الإنترنت. يعني الاتصال السلس أنه يمكن القيام بكل شيء من معالجة العملاء والمكاتب الخلفية إلى الترميز وتحليلات البيانات في أي مكان تقريبًا على وجه الأرض.
كما أن انخفاض العمالة في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة - وهو أحد الأضرار الرئيسية في الولايات المتحدة المنسوبة إلى التجارة - نتج بشكل رئيسي عن التغير التكنولوجي. وقد حسب باحثون في جامعة بول ستيت أن "ما يقرب من 88في المئة من فقدان الوظائف في قطاع التصنيع [بين عامي 2000 و2010] يمكن أن يُعزى إلى نمو الإنتاجية، وأن التغييرات طويلة الأجل في العمالة في قطاع التصنيع ترتبط في الغالب بإنتاجية المصانع الأمريكية". ووجدوا أن التجارة لم تُمثل سوى 13.4في المئة من فقدان الوظائف.
في الواقع، بدأ هذا الانخفاض في العمالة في قطاع التصنيع، الذي حدث في كل أنحاء الدول الصناعية المتقدمة، قبل وقت طويل من توقيع واشنطن على أي اتفاقيات تجارية رئيسة. فقد تقلصت نسبة العمالة الأميركية في قطاع التصنيع بنحو نقطتين إلى خمس نقاط مئوية لكل عقد من سبعينيات القرن الماضي وحتى العقد الأول من هذا القرن، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. وشهدت ألماني، التي تُعتبر على نطاق واسع قوة صناعية، انخفاضًا مماثلًا. أدى ظهور الصين كأرضية صناعية للاقتصاد العالمي إلى تسريع هذا الاتجاه، ولكنه ليس السبب الوحيد. ففي الاقتصادات المتقدمة ذات القطاعات الصناعية القوية، فإن التراجع المزمن في العمالة الصناعية يسبق عصر ذروة العولمة بوقت طويل. ومع ذلك، فإن أحد العوامل الرئيسة وراء حذر التجارة اليوم هو أن قواعد النظام القائم على القواعد لم تتوقع بشكل كافٍ تحدي الصين. وقد أدى ظهور الصين كقوة اقتصادية مدفوعة بالتصدير إلى ما أصبح يُعرف باسم "صدمة الصين" - الإغلاق السريع للمصانع في مجتمعات معينة في الولايات المتحدة.
صحيح أن النظام التجاري المتعدد الأطراف عانى من عيوب في التصميم ثبت أنها بارزة بشكل خاص مع صعود الصين - وبالتالي زرعت بذور زوال النظام. وشملت هذه العيوب ضعف بعض القيود المفروضة على دعم الدولة والسلوك غير السوقي للشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن حماية حقوق الملكية الفكرية؛ وصعوبة تخريج الأعضاء من وضع الدول النامية، ما سمح بمعاملة أكثر تساهلاً؛ وعملية صنع القرار بالإجماع، مع حق النقض من دولة واحدة، جعلت الإصلاح شبه مستحيل. عند انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، كان هناك ما يدعو للاعتقاد بأن بكين تسير على طريق لا رجعة فيه نحو إصلاح السوق وتحريرها. لم تكن هذه الآمال مستندة فقط إلى خطاب قادة الصين آنذاك، بل أيضًا إلى الإجراءات المؤلمة التي اتخذوها لإعادة هيكلة قطاعات كبيرة من الاقتصاد. إلا أن الآمال تبددت مع توقف الإصلاح في عهد الرئيس هو جين تاو، ثم تراجعه في بعض النواحي في عهد الرئيس شي جين بينغ.
أثبتت قواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالملكية الفكرية، والدعم، والشركات المملوكة للدولة عدم كفايتها في مواجهة بروز وتكامل الصين التي أصلحت نهجها الاقتصادي بأقل من المتوقع. ولم يكن التحدي يكمن في التزام الصين بقواعدها فحسب؛ بل كان يكمن أيضًا في مشكلة الحجم. فائض الصين من السلع المصنعة - الذي اقترب من تريليون دولار العام الماضي - يفوق بكثير فائض عمالقة التصنيع السابقين، مثل ألمانيا واليابان. وبحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فإن الصين في طريقها إلى إنتاج 45في المئة من الناتج الصناعي العالمي بحلول نهاية العقد الحالي.
تتحمل هذه الطاقة الصناعية الفائضة، المدعومة بالتفضيلات المحلية، والدعم الحكومي، وحماية السوق، قسطًا كبيرًا من اللوم في الوضع الحالي. فمع تزايد تحدي الاستراتيجية الاقتصادية الصينية لسلامة نظام تجاري مصمم لتعزيز التكامل والاعتماد المتبادل، ازدادت شكوك واشنطن في النظام نفسه. عام 2015، انسحبت إدارة أوباما من جولة الدوحة لمفاوضات التجارة العالمية، قلقةً من أن الاتفاق الناتج كان سيُرسي معاملة تفضيلية للصين على حساب الولايات المتحدة وبقية العالم. في ولايته الأولى، أبدى ترامب تجاهلًا واسعًا للنظام المتعدد الأطراف، مفضلًا العودة إلى فترة ما قبل منظمة التجارة العالمية التي مارست فيها الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، سلطتها من جانب واحد. ولم تفعل إدارة بايدن شيئًا ذا معنى لإصلاح منظمة التجارة العالمية.
اليوم، توقفت وظائف منظمة التجارة العالمية تمامًا. فبصفتها منتدى تفاوضيًا، لم تنجح المنظمة في السنوات الأخيرة إلا في إبرام اتفاقيات متعددة الأطراف هامشية، مثل اتفاقية تيسير التجارة التي تُسرّع دخول البضائع إلى الجمارك. وبصفتها هيئةً لرصد الممارسات التجارية للأعضاء، لم يكن لديها أي سبيل للانتصاف عندما تتجاهل الاقتصادات الكبرى التزاماتها بالإبلاغ عن السياسات. وبصفتها منظمةً لتسوية النزاعات، فقد أعاقتها الخلافات حول ولاية هيئة الاستئناف التابعة لها وطريقة عملها. وردًا على هذه الخلافات، اعترضت واشنطن، عبر عدة إدارات، أولًا على إعادة تعيين بعض أعضاء الهيئة، ثم على تعيين أي أعضاء جدد في نهاية المطاف، مما حال فعليًا دون بذل أي جهد جاد لتسوية النزاعات.
الخسائر والمكاسب
أصبح جلد الذات بشأن إخفاقات النظام التجاري عمليًا ثمنًا للدخول في مناقشات حول مستقبل الاقتصاد العالمي. وأصبح السرد المعتاد لتلك الإخفاقات نقطة انطلاق لما يُفترض أنه "إجماع واشنطن جديد". ومع ذلك، ينبغي موازنة تلك الإخفاقات بالفوائد، فمن السهل جدًا اعتبار النظام الاقتصادي الدولي والمؤسسات التي تدعمه أمرًا مسلمًا به.
من ناحية، لعب النظام التجاري العالمي دورًا محوريًا في انتشال ما يصل إلى مليار شخص من براثن الفقر. وقد خلص البنك الدولي إلى أن "التجارة كانت محركًا قويًا للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر". بين عامي 1990 و2017، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي ثلاث مرات تقريبًا، وارتفعت حصة البلدان النامية من الصادرات من 16في المئة إلى 30في المئة، وانخفض معدل الفقر العالمي من 36في المئة إلى 9في المئة.
من المغالطات الشائعة في نقاشات اليوم حول التجارة الاعتقاد بأنها لم تستفد منها إلا دول أخرى، وليس الولايات المتحدة. وقد تجلى أوضح فائدة للمستهلكين الأميركيين، إذ أتاحت لهم الوصول إلى سلع أكثر تنوعًا وبأسعار أقل. وقد وجدت دراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أن خفض تكاليف الاستيراد الأمريكية بنسبة 10في المئة يُحقق مكاسب في الرفاه الاجتماعي للأسر ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء. إلا أن أكبر الفوائد تعود على الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تبلغ مكاسب الرفاه الاجتماعي للأسر الأفقر 4.5 أضعاف مكاسب الأسر الأغنى. وأشار الخبير الاقتصادي مايكل وو، الذي أعد التقرير، إلى أنه "بمعنى أبسط، فإن خفض سعر الدولار له قيمة أكبر للفقراء منه للأغنياء".
كما سهّلت اتفاقيات التجارة تصدير المنتجات والخدمات الأميركية الصنع من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية في الأسواق الأخرى التي، كما أشار ترامب نفسه، كانت عمومًا أعلى من الحواجز في السوق الأميركية. وبذلك، قلّلوا من دافع نقل الإنتاج إلى الخارج لخدمة تلك الأسواق، حيث يعيش جميع المستهلكين العالميين تقريبًا، ودعموا وظائف ذات أجور أعلى في المتوسط من الوظائف غير المرتبطة بالتصدير في الولايات المتحدة. منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، نمت صادرات السلع بأكثر من 150في المئة، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، وفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي.
نمت الواردات بأكثر من 250في المئة بعد تعديلها وفقًا للتضخم خلال هذه الفترة). وخلص تقرير لمكتب الإحصاء الأيمركي، استنادًا إلى بيانات من العام 1992 إلى العام 2019، إلى أن الشركات العاملة في التجارة "تُظهر معدلات صافية أعلى لخلق فرص العمل مقارنةً بالشركات غير التجارية، مع مراعاة حجم الشركة وعمرها والقطاع الذي تعمل فيه".
في تحليل لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، حسب غاري هوفباور وميغان هوغان أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2022 كان سينخفض بمقدار 2.6 تريليون دولار لولا مكاسب التجارة بعد الحرب العالمية الثانية، بمتوسط مكاسب قدره 19,500 دولار للأسرة.
ساهمت السياسة التجارية أيضًا في تحقيق تكافؤ الفرص للعمال الأميركيين من خلال الضغط على الدول الأخرى لتبني ممارسات أفضل في مجالات البيئة والعمالة والملكية الفكرية والتنظيم ومكافحة الفساد. على سبيل المثال، لم تكن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ لتفتح أسواقًا مغلقة منذ زمن طويل أمام المنتجات الأمريكية، مثل اليابان، فحسب، بل كانت ستُدخل أيضًا معايير قابلة للتنفيذ بشأن حقوق العمال وحماية البيئة ودعم الشركات المملوكة للدولة في الأسواق الناشئة، مثل ماليزيا وفيتنام - وهي مكونات أساسية لـ "التجارة العادلة".
في الواقع، عرضت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ تخفيضًا للتعريفات الجمركية الأميركية المنخفضة أصلًا كحافز لحث الدول الأخرى على تبني سياسات تتوافق مع المصالح والقيم الأميركية، مع خلق بديل تقوده الولايات المتحدة للقوة الاقتصادية الصينية. قبل إدارة ترامب الأولى، كانت التعريفات الجمركية الأميركية منخفضة نسبيا، حيث بلغ متوسط التعريفة الجمركية المطبقة نحو ثلاثة في المائة، وكانت هناك قيود كبيرة مفروضة على عدد قليل من القطاعات، مثل الأحذية والملابس والسكر ومنتجات الألبان والشاحنات.
مع ذلك، لطالما كانت هذه الحجج صعبة التصديق سياسيًا، نظرًا لتقاسم فوائد تحرير التجارة على نطاق واسع، لكنها في معظمها غير مرئية. لا أحد يخرج من متجر وول مارت ويصيح: "الحمد لله على وجود منظمة التجارة العالمية!". في الوقت نفسه، يشعر عدد قليل من العمال في صناعات محددة بتكاليف التجارة بشكل حاد. يمكن إلقاء اللوم على العولمة لإدخالها منافسة من دول أخرى ذات تكاليف عمالة أقل، مما وضع ضغوطًا نزولية على أجور قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، وخلق حوافز لنقل الإنتاج إلى الخارج.
كانت صدمة الصين مثالًا واضحًا على هذه الديناميكية - ليس بسبب نطاقها الإجمالي، بل بسبب مدى تركيز خسائرها في مجتمعات محددة. خلص الاقتصاديون ديفيد أوتور، وديفيد دورن، وغوردون هانسون إلى أنه عامي 1999 و2011، أدت الواردات الصينية إلى فقدان نحو مليوني وظيفة، بما في ذلك مليون وظيفة في قطاع التصنيع. هذه الخسارة متواضعة نسبيًا في سياق الاقتصاد الأمريكي ككل: ففي كل عام، يعاني نحو 50 مليون عامل أميركي من "فصل وظيفي"، بما في ذلك الاستقالات والتسريح. ومع ذلك، تركزت هذه الخسائر جغرافيًا، ما أدى إلى دمار مجتمعات فردية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على صناعات لم تستطع تحمل تدفق الواردات الصينية، مع امتداد آثار الإغلاق إلى بقية الاقتصاد المحلي.
ورغم أن "التدمير الخلاق" ربما كان ليُجدي نفعًا في مجمله، إلا أنه لم يُجدِ نفعًا يُذكر بالنسبة لبلدات أو مدن محددة لم يكن لديها سبيل لاستبدال الصناعات المُدمَّرة بأخرى جديدة وفق جدول زمني مناسب. ولم يكن هناك فهم يُذكر للحاجة إلى سياسات محلية، مثل المساعدة الفعّالة في انتقال العمال، وبرامج التعلم مدى الحياة وتطوير المهارات، واستراتيجيات التنمية الاقتصادية القائمة على المكان، التي تعالج بفعالية الآثار المحلية للعولمة - وهي فجوة لم تُعالج بشكل كافٍ بعد.
كيف تنتهي الحروب التجارية
لسنوات، كان رد فعل واشنطن على عيوب النظام التجاري العالمي مرتجلًا في أحسن الأحوال. فرضت إدارة ترامب الأولى تعريفات جمركية واسعة النطاق على الصين، وأخرى مُستهدفة على الحلفاء والشركاء. كما تفاوضت مع الصين على اتفاقية بيع وشراء، لا اتفاقية تجارية، تُلزمها بشراء المزيد من السلع والمنتجات الأخرى من الولايات المتحدة التي لم تُنفذها الصين في النهاية.
أبقت إدارة بايدن على معظم تعريفات ترامب، وأضافت إليها بعض التعريفات الإضافية. ورغم التشكيك في القيمة الاقتصادية والأمنية للتعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية، مثل الأحذية والملابس، إلا أنها لم تُرِد "مكافأة" بكين بتخفيضها. كما ابتكرت ضوابط التصدير، وقيود الاستثمار الأجنبي، والسياسة الصناعية. ورغم تركيز هذه التدابير على الصناعات الاستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية، إلا أن مسؤولي الإدارة لم يُطوروا إطارًا واضحًا، يتضمن حواجز ومبادئ مُقيّدة، لمنع قائمة المنتجات والتقنيات الأساسية للأمن القومي من النمو إلى ما لا نهاية، وتطورها بمرور الوقت إلى سياسة حمائية مُبسّطة. هدفت مبادرات مثل الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل الرخاء وشراكة الأميركيتين من أجل الرخاء الاقتصادي إلى تقريب الدول وسلاسل التوريد الخاصة بها من الولايات المتحدة، ولكن دون إمكانية الوصول إلى الأسواق - التي اعتُبرت حساسة سياسياً للغاية - كان التأثير هامشياً.
ومع ذلك، دعت إدارة بايدن إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية بدل تدميرها، وتصرفت في معظم النواحي وفقاً لمبادئ النظام القائم على القواعد. يبدو أن إدارة ترامب الثانية لديها هدف مختلف في الاعتبار: لا شيء أقل من تفكيك نظام التجارة العالمي، المتجذر في تفضيل الرئيس القوي للعمل الأحادي الجانب واعتقاده بأن العجز التجاري الثنائي يمثل تهديداً وجودياً. في 2 أبريل، ما يسمى بيوم التحرير، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية وأعلن عن تعريفات جمركية "متبادلة" تصل إلى 50في المئة على عشرات الدول. منذ ذلك الحين، دأب على تغيير مسار الاتفاقيات، مهددًا بفرض رسوم جمركية كسلاح في قضايا غير تجارية، كالهجرة والفنتانيل والحرب في أوكرانيا، وحتى النظام القضائي في البرازيل. وسعى إلى فرض "صفقات" من جانب واحد عندما تتعثر المفاوضات.
بغض النظر عن مستوى الرسوم الجمركية، فمن شبه المؤكد أن تنتهي الحروب التجارية الحالية بحواجز تجارية أعلى بكثير. سيفرض هذا تكاليف على المستهلكين الأمريكيين وتحديات على الشركات الأميركية. أكثر من نصف واردات الولايات المتحدة اليوم هي سلع وسيطة - مدخلات في إنتاج السلع النهائية. وبالتالي، فإن ارتفاع كلفة المدخلات أو صعوبة الحصول عليها سيجعل المنتجات الأميركية أقل تنافسية، كما هو موثق جيدًا بعد فترة ترامب الأولى. في عام 2018، فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25في المئة على الصلب و10في المئة على الألومنيوم.
وخلص الاقتصاديان كادي روس وليديا كوكس لاحقًا إلى أن "الرسوم الجمركية على الصلب ربما أدت إلى زيادة بنحو 1000 وظيفة في إنتاج الصلب". "ومع ذلك، فإن زيادة تكاليف المدخلات التي تواجه الشركات الأمريكية مقارنة بالمنافسين الأجانب بسبب رسوم المادة 232 على الصلب والألومنيوم قد أدت على الأرجح إلى انخفاض قدره 75000 وظيفة تصنيع في الشركات التي يكون فيها الصلب أو الألومنيوم مدخلات في الإنتاج". حسب بن ستيل وإليزابيث هاردينغ، من مجلس العلاقات الخارجية، أن الإنتاجية، أو الناتج في الساعة، في صناعة الصلب قد انخفضت بنسبة 32في المئة منذ العام 2017. إذا كان هدف إدارة ترامب هو خلق المزيد من فرص العمل في قطاع التصنيع، فمن المرجح أن يكون لنهجها تأثير معاكس تمامًا.
ثم هناك كلفة الانتقام والتقليد، حيث تستجيب الحكومات الأخرى وتحذو حذو الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية وقيود خاصة بها. إذا ردت الدول، فسيضر ذلك بالصادرات الأميركية، بما في ذلك الزراعة. قد ينطوي التقليد أيضًا على توسيع جذري لاستخدام مبررات الطوارئ والأمن القومي لتسليح التجارة، كما فعلت الولايات المتحدة. لطالما كان موقف الولايات المتحدة هو أنه لا يمكن لأحد آخر أن يملي عليها ما هو ضروري لأمنها القومي.
ولكن حتى وقت قريب، نادرًا ما استندت واشنطن إلى مبرر الأمن القومي. وقد وسّع ترامب نطاق استخدام هذه الأداة لفرض قيود على الصلب والألمنيوم والسيارات، بما في ذلك من حلفائه المقربين. وقد حذت دول أخرى حذوه منذ ذلك الحين. عام 2024، استشهدت 95 لائحة قياسية من "الحواجز الفنية أمام التجارة" في منظمة التجارة العالمية بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وهي تُطبق على كل شيء من حبوب الكاكاو إلى المشروبات الكحولية ووصولاً إلى أعلاف الحيوانات.
وما يُفاقم كل هذه التكاليف حالة عدم اليقين الناتجة عن نهج ترامب. يميل المستهلكون والشركات والمستثمرون إلى التنحي جانباً عندما يشعرون بعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العامة والتعريفات الجمركية المحددة أو غيرها من التدابير التجارية التي قد يواجهونها. وقد يصبح التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية على خفض النمو، بل وحتى التسبب في ركود اقتصادي، نبوءة ذاتية التحقق. وهكذا، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام تجربة كبرى تُشكك فيها الافتراضات الراسخة حول الاقتصاد والتجارة العالمية، مع تكاليف باهظة على المدى القريب وفوائد غير مؤكدة على المدى الطويل.
لقد قلبت إدارة ترامب، في الواقع، الاقتصاد السياسي للتجارة رأساً على عقب. ومن المرجح أن تكون تكاليف سياساتها واضحة للغاية، وأن يشعر بها معظم الأميركيين فوراً، بينما من المرجح أن يتمتع عدد قليل نسبياً من العمال بالفوائد الموعودة، بقدر ما تأتي، بعد عدة سنوات في المستقبل. سيتضح قريبًا ما إذا كان الجمهور مستعدًا لقبول تضحيات على المدى القريب من أجل رؤية ترامب لإعادة التصنيع في الاقتصاد الأمريكي. ولكن مهما كانت شراسة رد الفعل السياسي في نهاية المطاف، فلا عودة إلى النظام التجاري الذي كان قائمًا من قبل.
قوى الطرد المركزي
بالنظر إلى تجربة النصف الأول من القرن العشرين في التجارة وما بعدها، يبدو جليًا أن التعاون الدولي يحقق نتائج أفضل من الممارسة الجامحة للقوة المطلقة. إلا أن سياسة التجارة الحالية تُمثل عودةً إلى شكل من أشكال سياسات القوة حيث القوة تصنع الحق. تتصرف الولايات المتحدة بشكل أحادي لأنها، بصفتها أكبر اقتصاد وسوق استهلاكية في العالم، قادرة على ذلك. والصين، على الرغم من تظاهرها بالولاء للتعددية، تتصرف بالمثل بشكل متزايد.
قد يتبع ذلك انتشار العدوى، مُحفِّزًا دورات من الأحادية والمعاملاتية التي قد تخرج عن نطاق السيطرة بسهولة. قد تحذو بعض الدول حذو الولايات المتحدة الحالية وترفض صراحةً النظام القائم على القواعد. وقد تحذو دول أخرى حذو الصين وتحتفل بالنظام قولًا بينما تُقوِّضه بالفعل. في كلتا الحالتين، ستُقلِّل الحواجز المتزايدة أمام التجارة من النمو وتُضر بالإنتاجية. ستُولِّد القواعد المُنهكة حالة من عدم اليقين والاحتكاك، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار والصراع.
مع مرور الوقت، قد يُصبح الاقتصاد العالمي شبيهًا بنظام ما قبل الحرب العالمية الثانية، الذي اتسم بالاستخدام المتكرر للتجارة كسلاح. بالنسبة للاقتصادات المهيمنة، قد تبدو الفوائد قصيرة الأجل لهذا الاستخدام الفج للقوة وتجاهل القيود وكأنها تُعادل التكاليف، ولكن على المدى الأبعد، من المرجح أن تكون هناك عواقب غير مقصودة. في غضون ذلك، ستجد الدول الأصغر والأفقر نفسها عاجزة عن استخدام التعريفات الجمركية وغيرها من القيود التجارية بالطريقة نفسها.
قد تسعى حكومات أخرى في البداية إلى الحفاظ على النظام القديم، بغض النظر عما تفعله الولايات المتحدة والصين، مُدركةً تمامًا أن التخلي عن النظام كليًا يعني العودة إلى عالم إفقار الجار. بالنسبة لبعض الدول، يعكس هذا الجهد التزامًا أيديولوجيًا بالنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد. فالمشروع الأوروبي بأكمله، على سبيل المثال، متجذر في مفهوم التكامل القائم على القواعد واللوائح، مما يُصعّب على الاتحاد الأوروبي اتباع استراتيجية أحادية الجانب تمامًا. في غضون ذلك، تفتقر الدول النامية إلى القوة والنفوذ اللازمين للتأثير على شركائها التجاريين الرئيسيين، ولذلك اعتمدت على منظمة التجارة العالمية ونظام فض النزاعات لتحقيق تكافؤ الفرص.
ومن المرجح أن يتشكل تكتل من الدول التي تواصل الإشادة بمزايا النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد، على أمل أن تعود الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى هذا النظام وأن تُعدّل الصين استراتيجيتها الاقتصادية للامتثال له. وسيُسفر هذا الجهد عن نتائج مماثلة لما حدث في نظام تغير المناخ، حيث تتحد بعض الدول حول مجموعة من القواعد، بينما تختار العديد من أهم الجهات الفاعلة مساراتها الخاصة. وكما هو الحال في تغير المناخ، من المرجح أن يُحبط هذا التكتل من الدول.
تحالفات الراغبين
إذا كان نظام التجارة الفوضوي غير مرغوب فيه، ولكن العودة إلى الوضع الراهن مستحيلة، فإن ذلك يترك مهمة واحدة واضحة: تطوير نظام جديد للقواعد حتى مع ابتعاد الاقتصاد العالمي عن نظام متعدد الأطراف قائم على القواعد بالكامل. الخيار الأكثر جدوى هو بناء نظام جديد قائم على التعددية المفتوحة: تحالفات من الدول التي تتشارك مصالح في مجالات محددة وتجتمع لاعتماد معايير عالية بشأن قضايا معينة، ثم تبقى منفتحة على الدول الأخرى التي تتشارك مصالح مماثلة ومستعدة لتطبيق تلك المعايير.
بالنسبة لبعض الدول، يمكن أن تركز هذه التحالفات على تحرير التجارة، بناءً على رغبة مشتركة في توفير إمكانية الوصول إلى الأسواق لبعضها البعض، كليًا أو جزئيًا، من أجل تعزيز التكامل والكفاءة الاقتصادية. بالنسبة لدول أخرى، يمكن أن تكون التحالفات سبلًا لتحقيق التناغم التنظيمي أو تناول قضايا جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، حتى لو كان ذلك بطريقة غير رسمية وغير ملزمة، على غرار دور مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية تشكلت بعد الأزمة المالية عام 2008 وتنسق التوصيات المتعلقة بالتنظيم المالي. ومع أي من هذه التحالفات، يمكن لأي حكومة ببساطة أن تختار عدم الانضمام إذا رأت أن تكاليف التنازلات بشأن القضايا ذات الصلة أكبر من فوائدها.
في بعض الحالات، يُمكن لتحالف من الدول ذات المصالح الأمنية القومية المتشابهة أن يُنسّق جهوده في مجال نقل التكنولوجيا والسياسات الصناعية، أي حول نهج مشترك لتقييد التجارة بدلاً من تسهيلها. على سبيل المثال، يُمكن للتحالف أن يُثني أعضائه عن استيراد منتجات وخدمات مُعينة، مثل البنية التحتية للاتصالات، من دول تُشكّل تهديدًا للأمن القومي، مع تشجيع تطوير سلاسل توريد آمنة بين أعضائه. أو يُمكنه مواءمة ضوابط التصدير ووضع قواعد مُشتركة لاستخدام الدعم الحكومي. يُمكن للولايات المتحدة أن تُشكّل تحالفًا يهدف إلى بناء قاعدة صناعية جماعية تنافسية لمواجهة التحدي الذي يُشكّله حجم الصين، كما أوصى نائب وزير الخارجية السابق كورت كامبل وراش دوشي من مجلس العلاقات الخارجية مؤخرًا في هذه الصفحات.
كيف يُمكن للولايات المتحدة أن تُحفّز الدول على الانضمام إلى مثل هذه التحالفات؟ يبدو أن التفاوض على اتفاقيات تحرير التجارة التقليدية قد أصبح غير مطروح سياسيًا، على الأقل في الوقت الحالي. قد يُؤمّن التهديد بفرض رسوم جمركية - أي استخدام أسلوب الترغيب بدلًا من الترغيب - اتفاقًا على المدى القصير، ولكن لضمان ديمومته، يجب على الأعضاء الآخرين في التحالف أن يروا أن من مصلحتهم التحالف مع الولايات المتحدة بدلًا من المراهنة على الصين أو البقاء على الحياد تمامًا.
أحد الخيارات المتاحة للولايات المتحدة هو الاستفادة من منظومة الابتكار لديها - ذلك المزيج الفريد من الجامعات العالمية المرموقة، والاستثمار في البحث والتطوير، وسيادة القانون، وأسواق رأس المال الواعدة، والوصول إلى رأس المال المخاطر، وثقافة ريادة الأعمال. العديد من هذه الأصول مُهددة حاليًا بسياسات إدارة ترامب، ولكن على المدى البعيد، ينبغي أن تكون قيمة الحفاظ على الريادة العلمية والتكنولوجية الأميركية بديهية، لاسيما في سياق التنافس بين القوى العظمى.
قد يتطور نظام الابتكار الأميركي ولكنه سيصمد. يمكن لمجموعة من الدول أن تضمن وصولًا تفضيليًا إلى هذه الفرص وتلك التي يُقدمها أعضاء آخرون في النادي، مقابل التوافق على مجموعة أوسع من المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي. ستكون هذه التحالفات مفتوحة، أي أن الدول القادرة والراغبة في الالتزام بالمعايير مؤهلة للانضمام. قد يكون بعضها صغيرًا جدًا، يركز على تأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات، على سبيل المثال، مثل اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وتايوان. وقد تمثل تحالفات أخرى مجموعات أكبر من الدول الراغبة في الموافقة على مجموعة أوسع من القواعد التي تحكم علاقات التجارة والاستثمار بشكل عام، مثل الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، التي أُبرمت دون مشاركة الولايات المتحدة. يمكن أن تنمو عضوية التحالفات بمرور الوقت، وقد يكون هناك تداخل في العضوية بين التحالفات المختلفة.
في ظل غياب أي تغيير جوهري في استراتيجية بكين الاقتصادية، وما إلى ذلك، يصعب تصور الصين كمرشحة لعضوية تحالف من هذا النوع يضم الولايات المتحدة في أي وقت قريب (مع أنه قد يكون هناك مجال لتحالفات تتعاون في مجال المنافع العامة العالمية، مثل التأهب للأوبئة). من الممكن، مع مرور الوقت، أن يغير صانعو السياسات الصينيون استراتيجيتهم بناءً على تقديراتهم الخاصة، مدفوعةً بضغوط ديموغرافية ومالية وغيرها. قد يُعجّل هيكل التعددية المفتوحة، المبني على الحلفاء والشركاء، من هذا القرار. ولكن بعد سنوات من المحاولات، ينبغي أن يكون صانعو السياسات الأمريكيون الآن متواضعين للغاية بشأن قدرتهم على إقناع بكين مباشرةً بتغيير نهجها والتركيز بدلاً من ذلك على استخدام التحالفات لتشكيل البيئة الخارجية للصين.
في هذا العالم، قد تذوي منظمة التجارة العالمية تمامًا، أو قد تبقى على حالها كبقايا للدول التي لا تملك تحالفات أكثر جاذبية للانضمام إليها. يمكن أن تكون أيضًا مستودعًا للأعمال الفنية وساحة لتسوية النزاعات للدول التي تختار الانضمام. ستظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة قائمة، ويمكن أن تُصبح أساسًا لتحالفات أوسع، مثل الاتحاد الأوروبي الذي قد يحذو حذو المملكة المتحدة في الانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ والتقدمية الشاملة.
من أهم فوائد التعددية المفتوحة المرونة التي توفرها. فنظرًا لعدم خضوعها للمعارضين في نظام يتمتع فيه كل بلد بحق النقض، يُتيح هذا النهج فرصًا للمضي قدمًا في القضايا بين أصحاب الرأي المشترك والقدرة على تناول القضايا الجديدة عند ظهورها، والأعضاء الجدد عند استيفائهم للمعايير. من حيث الكفاءة الاقتصادية، يُعد هذا الحل ثاني أفضل الحلول. فبحكم التعريف، ستُتقاسم الفوائد فقط بين الأعضاء. وستُرمى مبادئ مثل مبدأ الدولة الأولى بالرعاية إلى مزبلة التاريخ. وقد تكون الهندسة المتغيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف المصممة خصيصًا فوضوية وغير فعالة، مثل طبق معكرونة من اتفاقيات التجارة الثنائية. ولكن على الرغم من أن هذه الشبكة ستكون أكثر تعقيدًا من نظام التجارة متعدد الأطراف، إلا أنها قد تثبت أيضًا أنها أكثر استدامة من الناحية السياسية. إنها استجابة عملية للتحدي الحالي: الحفاظ على بعض القواعد على الأقل دون نظام متعدد الأطراف قائم على القواعد.
عواصف قادمة
مهما كانت فوائد نظام التجارة العالمي لما بعد الحرب - من حيث النمو، وتخفيف حدة الفقر، ورفاهية المستهلك، وغيرها - فقد كان هناك، في نهاية المطاف، خاسرون ورابحون. لم تُوزّع التكاليف ولا الفوائد بالتساوي، ونادرًا ما حظيت قضايا التوزيع باهتمام كافٍ من صانعي السياسات. ستبقى هذه الجوانب السلبية حتى في أفضل الأنظمة تصميمًا، وسيكون من الضروري إيجاد حلول أفضل للأضرار. يجب أن يأتي أي نظام جديد مصحوبًا بمجموعة من السياسات المحلية المصممة لضمان ازدهار العمال والمجتمعات الأمريكية في اقتصاد سريع التغير، سواء أكان هذا التغيير ناتجًا عن التجارة أو التكنولوجيا أو الهجرة. بذلت الإدارات السابقة محاولات متواضعة للتنمية الاقتصادية المحلية وإعادة تدريب العمال، ولكنها لم تكن أبدًا بالجدية المطلوبة أو درجة الأولوية اللازمة.
قد تكون هناك حاجة ماسة إلى مثل هذه السياسات في أعقاب حروب ترامب التجارية. من المرجح أن تقع تكاليف النهج الحالي - من حيث النمو والتضخم والإنتاجية - على عاتق من يدّعي ترامب دعمهم. ينفق الأمريكيون ذوو الدخل المحدود حصة غير متناسبة من دخلهم على السلع المستوردة. تعتمد الصناعات التي توظف العمال ذوي الياقات الزرقاء على المدخلات المستوردة. كما أن دخل المزارعين ومربي الماشية حساس للغاية لأي إجراءات انتقامية من الدول الأخرى.
في الوقت نفسه، وبينما تُصارع الولايات المتحدة هذه العواقب، قد يُقزّم التأثير المُرتقب للذكاء الاصطناعي على العمال تأثير العولمة. ساهمت صدمة الصين في القضاء على ما يُقدّر بمليوني وظيفة بين عامي 1999 و2011؛ ويمكن أن يُؤدي التطبيق الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي إلى القضاء على عشرات الملايين من الوظائف خلال فترة مماثلة. لذا، بينما يُركّز الاهتمام على التعريفات الجمركية، ينبغي على صانعي السياسات تكريس جهد مماثل على الأقل للتحضير لإعادة هيكلة القوى العاملة الأمريكية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وكما هو الحال مع التجارة، قد تُوزّع الفوائد على نطاق واسع. ولكن في هذه الحالة، قد تُوزّع التكاليف أيضًا.