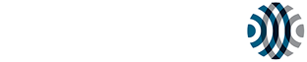عندما أعلنت واشنطن عن "اتفاق إطاري" مع الصين في يونيو، كان ذلك بمثابة تحول صامت في مسار الاقتصاد السياسي العالمي. لم تكن هذه بداية عهد "التحرر" الذي تخيله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ظل العظمة الأميركية الأحادية، ولا عودةً إلى حلم إدارة بايدن بالتنافس المُدار بين القوى العظمى. بل كانت البداية الحقيقية لعصر الترابط المُسلّح، حيث تكتشف الولايات المتحدة معنى أن يفعل بها الآخرون ما فعلته بهم بشغف.
ستُشكّل هذه الحقبة الجديدة بأسلحة الإكراه الاقتصادي والتكنولوجي - العقوبات، وهجمات سلاسل التوريد، وتدابير التصدير - التي تُعيد توظيف نقاط التحكم العديدة في البنية التحتية التي تُشكّل أساس الاقتصاد العالمي المُترابط. لأكثر من عقدين، سخّرت الولايات المتحدة هذه النقاط الضيقة، في مجالات التمويل وتدفق المعلومات والتكنولوجيا، لتحقيق مكاسب استراتيجية. لكن التبادل السوقي أصبح مُتشابكًا بشكل مُيؤوس منه مع الأمن القومي، وعلى الولايات المتحدة الآن الدفاع عن مصالحها في عالم يُمكن فيه للقوى الأخرى استغلال نقاط الاختناق الخاصة بها.
لهذا السبب اضطرت إدارة ترامب إلى عقد صفقة مع الصين. يُقرّ مسؤولو الإدارة الأميركية الآن بتقديم تنازلات بشأن ضوابط تصدير أشباه الموصلات، مقابل تخفيف الصين للقيود المفروضة على المعادن الأرضية النادرة التي كانت تُعيق صناعة السيارات الأميركية. ويُمكن للشركات الأميركية المُزوّدة ببرامج تصميم الرقائق، مثل سينوبسيس وكادنس، أن تبيع تقنياتها مُجددًا في الصين. وسيُساعد هذا التنازل صناعة أشباه الموصلات الصينية على التملص من المأزق الذي وجدت نفسها فيه عندما بدأت إدارة بايدن في الحد من قدرة الصين على تصنيع أشباه موصلات مُتقدمة. كما يُمكن لشركة إنفيديا الأميركية أن تبيع مُجددًا رقائق الماء (H2O) لتدريب الذكاء الاصطناعي للعملاء الصينيين.
في خطابٍ لم يُلاحظه الكثيرون في يونيو/حزيران، ألمح وزير الخارجية ماركو روبيو إلى منطق الإدارة. وقال إن الصين "احتكرت سوق" المعادن الأرضية النادرة، مما وضع الولايات المتحدة والعالم في "أزمة". أدركت الإدارة الأميركية "أن قدراتنا الصناعية تعتمد بشكل كبير على عدد من الدول القومية المعادية المحتملة، بما في ذلك الصين، التي تستطيع السيطرة عليها"، مما غيّر "طبيعة الجغرافيا السياسية" في "أحد التحديات الكبرى للقرن الجديد".
على الرغم من تأكيد روبيو على الاعتماد على الذات كحل، إلا أن اندفاع الإدارة الأميركية لإبرام صفقة يُظهر حدود العمل منفردًا. تُخفف الولايات المتحدة من تهديداتها لإقناع خصومها بعدم شل قطاعات حيوية من الاقتصاد الأميركي. كما تُكافح قوى أخرى لإيجاد سبل لتعزيز مصالحها في عالم تتداخل فيه القوة الاقتصادية والأمن القومي، ويتحول فيه التكامل الاقتصادي والتكنولوجي من وعد إلى تهديد.
اضطرت واشنطن إلى إعادة بناء دولتها الأمنية الوطنية بعد أن طورت دول أخرى القنبلة الذرية؛ وبالمثل، سيتعين عليها إعادة بناء دولتها الأمنية الاقتصادية لعالمٍ يُمكن فيه للخصوم والحلفاء تسليح الترابط فيما بينهم. باختصار، تنتشر الأسلحة الاقتصادية كما حدث مع الأسلحة النووية، مما يُسبب معضلات جديدة للولايات المتحدة والقوى الأخرى. لقد تكيفت الصين مع هذا العالم الجديد بسرعة ملحوظة؛ بينما واجهت قوى أخرى، مثل الدول الأوروبية، صعوبات. سيتعين على الجميع تحديث تفكيرهم الاستراتيجي حول كيفية تقاطع مبادئهم وقدراتهم مع مبادئ وقدرات القوى الأخرى، وكيفية استجابة الشركات، التي لها مصالحها وقدراتها الخاصة.
تكمن مشكلة الولايات المتحدة في أن إدارة ترامب تُستنزف الموارد التي تحتاجها لتعزيز مصالحها وحماية نفسها من أي تحركات مضادة. في العصر النووي، استثمرت الولايات المتحدة استثمارات تاريخية في المؤسسات والبنية التحتية وأنظمة الأسلحة التي كانت ستدفعها نحو تحقيق مكاسب طويلة الأجل. أما الآن، فيبدو أن إدارة ترامب تعمل بنشاط على تقويض مصادر القوة هذه. فبينما تُواجه الإدارة الصينية بضراوة، فإنها تُدمر أنظمة الخبرة اللازمة للتعامل مع المفاضلات المعقدة التي تواجهها. كل إدارة مُجبرة على بناء الطائرة أثناء طيرانها، لكن هذه هي أول إدارة تُزيل أجزاءً عشوائية من المحرك على ارتفاع 30 ألف قدم.
مع تكيف الصين السريع مع الواقع الجديد للترابط المُسلح، فإنها تُنشئ "مجموعة" بديلة خاصة بها من الصناعات التكنولوجية المتقدمة المُعززة بشكل مُتبادل، والتي تُركز على اقتصاد الطاقة. أوروبا تتخبط حاليًا، ولكن مع مرور الوقت، قد تُنشئ أيضًا مجموعة تقنياتها البديلة الخاصة. الولايات المتحدة، على نحوٍ فريد، تُلقي بمزاياها المؤسسية والتكنولوجية بعيدًا. إن فشل واشنطن في مواكبة التغيرات في النظام الدولي لن يضرّ بالمصالح الوطنية الأميركية فحسب، بل سيهدد أيضًا سلامة الشركات الأميركية وسبل عيش المواطنين الأميركيين على المدى الطويل.
العولمة العالمية المُصنّعة
يُعدّ الترابط المُسلّح نتيجةً ثانويةً غير متوقعة لعصر العولمة العظيم الذي يُوشك على الانتهاء. بعد انتهاء الحرب الباردة، بنت الشركات اقتصادًا عالميًا مترابطًا مرتكزًا على بنية تحتية متمركزة حول الولايات المتحدة. ونسجت المنصات التكنولوجية الأميركية - الإنترنت والتجارة الإلكترونية، ولاحقًا وسائل التواصل الاجتماعي - أنظمة الاتصالات العالمية معًا. كما تضافرت الأنظمة المالية العالمية بفضل مقاصة الدولار، حيث تستخدم الشركات الدولار الأميركي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصفقات الدولية؛ والبنوك المراسلة التي تُنفّذ هذه المعاملات؛ وشبكة سويفت للمراسلة المالية.
تحوّل تصنيع أشباه الموصلات المتمركز في الولايات المتحدة إلى عدد لا يُحصى من العمليات المتخصصة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، إلا أن الملكية الفكرية الرئيسة، مثل تصميم برمجيات أشباه الموصلات، ظلت في أيدي عدد قليل من الشركات الأميركية. يمكن فهم كل نظام من هذه الأنظمة على أنه "مجموعة" مستقلة، أي مجمعات مترابطة من التقنيات والخدمات ذات الصلة التي أصبحت تُعزز بعضها البعض، بحيث أصبح الاشتراك في الإنترنت المفتوح يعني بشكل متزايد الاشتراك في منصات وأنظمة التجارة الإلكترونية الأميركية أيضًا. في وقت بدت فيه الجغرافيا السياسية مجرد مادة لأفلام الإثارة القديمة من حقبة الحرب الباردة، لم يقلق الكثيرون بشأن الاعتماد على البنية التحتية الاقتصادية التي توفرها دول أخرى.
كان ذلك خطأً فادحًا لخصوم واشنطن، وفي النهاية لحلفائها أيضًا. بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، بدأت الولايات المتحدة في استخدام هذه الأنظمة لملاحقة الإرهابيين وداعميهم. على مدى عقدين من التجارب المتراكمة، وسّعت السلطات الأميركية طموحاتها ونطاقها. انتقلت الولايات المتحدة من استغلال المعابر المالية ضد الإرهابيين إلى فرض عقوبات تستهدف البنوك، ومع مرور الوقت، إلى عزل دول بأكملها، مثل إيران، عن النظام المالي العالمي. تحوّل الإنترنت إلى جهاز مراقبة عالمي، مما سمح للولايات المتحدة بمطالبة المنصات وشركات البحث، الخاضعة لرقابة السلطات الأميركية، بتسليم معلومات استراتيجية بالغة الأهمية عن مستخدميها حول العالم.
انقلبت بنية الترابط الاقتصادي ضد أعداء الولايات المتحدة وأصدقائها على حد سواء. عندما انسحبت إدارة ترامب الأولى من خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تفاوضت عليها الولايات المتحدة ودول كبرى أخرى، بما في ذلك أوروبا، مع إيران عام 2015 للحد من برنامجها النووي، هددت الولايات المتحدة بمعاقبة الأوروبيين الذين استمروا في التعامل مع الجمهورية الإسلامية. وجدت الحكومات الأوروبية نفسها عاجزة إلى حد كبير عن حماية شركاتها من النفوذ الأميركي.
كان هذا هو السياق الذي كتبنا فيه لأول مرة عن الترابط المُسلّح في عام 2019. بحلول ذلك الوقت، أصبحت العديد من أهم الشبكات الاقتصادية التي تدعم العولمة - الاتصالات والتمويل والإنتاج - شديدة المركزية لدرجة أن عددًا صغيرًا من الشركات الرئيسية والجهات الفاعلة الاقتصادية سيطرت عليها فعليًا. يمكن للحكومات التي يمكنها فرض سلطتها على هذه الشركات، وأبرزها حكومة الولايات المتحدة، استغلالها للحصول على معلومات عن خصومها أو استبعاد المنافسين من الوصول إلى هذه النقاط الحيوية في الاقتصاد العالمي. على مدى عقدين من الزمن، بنت الولايات المتحدة مؤسسات لفرض هذه السلطة وتوجيهها استجابةً لسلسلة من الأزمات المحددة.
صادف بعض كبار مسؤولي ترامب بحثنا الأكاديمي، ولدهشتنا أعجبهم ما رأوه. ووفقًا لكتاب المؤرخ كريس ميلر الصادر عام 2022 بعنوان "حرب الرقائق"، عندما أرادت الإدارة الضغط على شركة هواوي الصينية لتصنيع الاتصالات، استغل أحد كبار المسؤولين فكرة الترابط المُسلّح كدليل لتعزيز ضوابط التصدير ضد أشباه الموصلات، واصفًا المفهوم بأنه "شيء جميل". لكن هدفنا الأساسي كان كشف الجانب القبيح لهذا التسليح. لم يكن العالم الذي صنعته العولمة مشهدًا مسطحًا للمنافسة السوقية السلمية كما وعد دعاتها. بل كان مليئًا بالتسلسل الهرمي، وعلاقات القوة، ونقاط الضعف الاستراتيجية.
علاوة على ذلك، كان غير مستقر في جوهره. ستؤدي الإجراءات الأميركية إلى ردود فعل من جانب الأهداف ورد فعل من الولايات المتحدة. يمكن للقوى الكبرى أن تتخذ موقفًا هجوميًا، باحثةً عن نقاط ضعف يمكنها هي الأخرى استغلالها. قد تسعى القوى الأصغر إلى استخدام قنوات تبادل أقل مساءلة أو شفافية، مما يُنشئ فعليًا مساحات مظلمة في الاقتصاد العالمي. كلما وظّفت الولايات المتحدة الترابطات ضد خصومها، زاد احتمال انقطاع اتصال هؤلاء الخصوم - وحتى حلفائهم - أو اختفائهم أو ردّهم. ومع قيام الآخرين بتسليح الترابط، سيُعاد نسج النسيج المترابط للاقتصاد العالمي وفقًا لمنطق جديد، مما يخلق عالمًا قائمًا على الهجوم والدفاع أكثر من المصالح التجارية المشتركة.
كما استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن التسليح كأداة يومية من أدوات الحكم. ارتقت إدارته بضوابط ترامب على تصدير أشباه الموصلات إلى مستوى جديد، حيث نشرتها أولًا ضد روسيا، بهدف إضعاف برنامج موسكو للأسلحة، ثم ضد الصين، مانعةً بكين من الوصول إلى أشباه الموصلات المتطورة التي تحتاجها لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بكفاءة. ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن وثيقة صاغها مسؤولو إدارة بايدن، بهدف قصر استخدام العقوبات على مشاكل الأمن القومي العاجلة، تقلصت حتمًا من 40 صفحة إلى ثماني صفحات من التوصيات عديمة الجدوى. اشتكى مسؤول سابق من "نظامٍ قاسٍ لا هوادة فيه، لا نهاية له، يُلزم الجميع بمعاقبة الآخرين..." نظامٌ "خارجٌ عن السيطرة".
وامتدت مخاوف مماثلة إلى ضوابط التصدير. حذّر خبراء السياسة من أن القيود التكنولوجية تُشجّع الصين على الإفلات من قبضة الولايات المتحدة وتطوير منظومتها الخاصة من التقنيات المتقدمة. لكن ذلك لم يُوقف إدارة بايدن، التي أعلنت في أسابيعها الأخيرة عن خطة طموحة للغاية لتقسيم العالم بأسره إلى ثلاثة أجزاء: الولايات المتحدة وبعض أقرب أصدقائها كنخبة مُختارة، والغالبية العظمى من الدول في الوسط، وعدد قليل من الخصوم اللدودين في أسفل الهرم. من خلال ضوابط التصدير، ستحتفظ الولايات المتحدة وشركاؤها المقربون بإمكانية الوصول إلى كلٍّ من أشباه الموصلات المُستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي القوي وأحدث "الأوزان" - المحركات الرياضية التي تُحرّك نماذج الابتكار - مع حرمان خصوم الولايات المتحدة منها وإجبار معظم الدول على الالتزام بقيود عامة. إذا نجح هذا، فسيضمن تفوقًا أمريكيًا طويل الأمد في مجال الذكاء الاصطناعي.
مع أن إدارة ترامب تخلت عن هذه الخطة التكنوقراطية الكبرى، إلا أنها لم تتخلَّ بالتأكيد عن هدف الهيمنة الأميركية والسيطرة على المعابر. تكمن مشكلة الولايات المتحدة في أن الآخرين لا يقفون مكتوفي الأيدي، بل يعملون على بناء الوسائل الاقتصادية والمؤسسية للمقاومة.
تنتشر أسلحة الترابط المتبادل منذ سنوات عديدة، وتُستخدم الآن لمواجهة النفوذ الأميركي. ومع بدء الصين والاتحاد الأوروبي في إدراك مخاطرهما، حاولا هما الآخران تعزيز نقاط ضعفهما، وربما استغلال نقاط ضعف الآخرين. بالنسبة لهذه القوى العظمى، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة، فإن مجرد تحديد نقاط الاختناق الاقتصادية الرئيسية ليس كافيًا. من الضروري أيضًا بناء جهاز الدولة القادر على جمع معلومات كافية لفهم الفوائد والمخاطر المباشرة، ثم توظيف هذه المعلومات. يؤتي نهج الصين ثماره، إذ تضغط على نقاط ضعف الولايات المتحدة لإجبارها على الجلوس على طاولة المفاوضات. في المقابل، تُجبر نقاط الضعف المؤسسية الداخلية في أوروبا على التذبذب، ما يضعها في موقف خطير تجاه الولايات المتحدة والصين.
بالنسبة للصين، أظهر كشف إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية، لممارسات المراقبة الأميركية عام 2013، مدى نفوذ الولايات المتحدة وآليات العصر الجديد. في السابق، كانت بكين تعتبر الاستقلال التكنولوجي هدفًا مهمًا على المدى الطويل. بعد سنودن، رأت في الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية تهديدًا عاجلًا على المدى القصير. وكما أظهر عملنا مع عالمَي السياسة يلينغ تان ومارك دالاس، بدأت مقالات في وسائل الإعلام الحكومية الصينية تُروّج للدور الحاسم لـ"أمن المعلومات" و"سيادة البيانات" في الأمن القومي للصين.
جاءت صيحة الاستيقاظ الحقيقية عندما هددت إدارة ترامب الأولى بمنع شركة ZTE، وهي شركة اتصالات صينية كبرى، من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية، ثم استخدمت ضوابط التصدير كسلاح ضد شركة هواوي، التي اعتبرتها الإدارة تهديدًا ملحًا لهيمنة التكنولوجيا الأميركية والأمن القومي. بدأت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بالتركيز على المخاطر التي تُشكلها "نقاط الاختناق" والحاجة إلى "الاعتماد على الذات".
تُرجمت هذه المخاوف إلى إجراءات سياسية، حيث طوّر الحزب الشيوعي الصيني "نظامًا وطنيًا شاملًا" لضمان استقلال الصين التكنولوجي، داعيًا إلى "إحراز تقدم كبير في التقنيات والمنتجات الرئيسية ذات الصلة". كما بدأت الصين في التفكير في كيفية استغلال مزاياها في تعدين ومعالجة المعادن النادرة بشكل أفضل، حيث سيطرت عليها بشدة مع خروج الشركات الأميركية وغيرها من السوق. لا تنبع قوة الصين في هذا القطاع من مجرد احتكارها للمعادن، التي لا تمتلكها البلاد بالكامل، بل من سيطرتها على النظام البيئي الاقتصادي والتكنولوجي اللازم لاستخراجها ومعالجتها. والجدير بالذكر أن هذه المعادن الحيوية تُستخدم في مجموعة متنوعة من الأغراض الصناعية عالية التقنية، بما في ذلك إنتاج المغناطيسات المتخصصة الضرورية للسيارات والطائرات وغيرها من التقنيات المتطورة.
كانت الصين قد هددت بالفعل بخفض إمداداتها من المعادن النادرة إلى اليابان خلال نزاع إقليمي عام 2010، لكنها افتقرت إلى الوسائل اللازمة لاستغلال هذه النقطة الخانقة بشكل منهجي. وبعد أن استيقظت على خطر استغلال الولايات المتحدة لنقاط الاختناق، سرقت الصين صفحة من كتاب اللعب الأميركي. ففي عام 2020، وضعت بكين قانونًا لمراقبة الصادرات أعاد صياغة العناصر الأساسية للنظام الأميركي. وأعقب ذلك عام 2024 لوائح جديدة تقيد تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج.
في وقت قصير، بنت الصين جهازًا بيروقراطيًا لتحويل نقاط الاختناق إلى نفوذ عملي. كما أدركت الصين أنه في عالم من الترابط المسلح، لا تأتي القوة من امتلاك سلع قابلة للاستبدال ولكن من التحكم في المجموعة التكنولوجية. ومثلما قيدت الولايات المتحدة تصدير معدات وبرامج تصنيع الرقائق، حظرت الصين تصدير المعدات اللازمة لمعالجة المعادن النادرة. إن هذه الأنظمة التنظيمية المعقدة لا توفر للصين سيطرة أكبر فحسب، بل وتوفر لها أيضا معلومات حاسمة حول من يشتري ماذا، مما يسمح لها باستهداف نقاط الضعف في البلدان الأخرى بقدر أعظم من البراعة.
لهذا السبب وجد المصنعون الأميركيون والأوروبيون أنفسهم في مأزق في يونيو/حزيران الماضي. لم تستخدم الصين نظامها الجديد لمراقبة الصادرات للرد على ترامب فحسب، بل للضغط على أوروبا وثنيها عن الانحياز إلى الولايات المتحدة. كان مصنعو السيارات الألمان، مثل مرسيدس وبي إم دبليو، قلقين بقدر قلق منافسيهم الأميركيين من توقف خطوط إنتاجهم في غياب المغناطيسات المتخصصة.
عندما توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مؤقت، أعلن ترامب على قناة "تروث سوشيال" أن "الصين ستوفر المغناطيسات الكاملة، وأي معادن أرضية نادرة ضرورية، مقدمًا"، مُدركًا خطورة التهديد الذي يواجه الاقتصاد الأميركي. تكمن مشكلة الصين على المدى الطويل في أن دولتها قوية جدًا ومستعدة جدًا للتدخل في الاقتصاد المحلي لأغراض سياسية بحتة، مما يعيق الاستثمار وربما يُخنق الابتكار. ومع ذلك، على المدى القصير، فقد بنت الصين القدرة الحاسمة لإعادة فرض الضوابط حسبما تراه ضروريًا لمقاومة أي مطالب أميركية أخرى.
يبقى السؤال مطروحًا حول قدرة أوروبا على الصمود أمام ضغوط بكين، وواشنطن أيضًا. تمتلك أوروبا العديد من قدرات قوة عظمى جيواقتصادية، لكنها تفتقر إلى الآلية المؤسسية اللازمة للاستفادة منها. فنظام سويفت، في نهاية المطاف، يقع في بلجيكا، وكذلك يوروكلير، البنية التحتية لتسوية العديد من الأصول القائمة على اليورو. وتشغل الشركات الأوروبية، بما في ذلك عملاق الطباعة الحجرية لأشباه الموصلات الهولندي ASML، وشركة برمجيات المؤسسات الألمانية SAP، وشركة إريكسون السويدية لتكنولوجيا الجيل الخامس، نقاط اختناق رئيسية في سلاسل التكنولوجيا. وتُعدّ السوق الأوروبية الموحدة، وفقًا لبعض المقاييس، ثاني أكبر سوق في العالم، مما قد يسمح لها بالضغط على الشركات التي ترغب في بيع سلعها للشركات والمستهلكين الأوروبيين.
لكن هذا يتطلب من أوروبا بناء مجموعتها الشاملة من المؤسسات ومجموعة مستقلة من التقنيات. ومن غير المرجح أن يحدث ذلك على المدى القصير إلى المتوسط، ما لم ينطلق مشروع "يورو ستاك" الناشئ، الذي يهدف إلى حماية أوروبا من التدخل الأجنبي من خلال بناء قاعدة مستقلة لتكنولوجيا المعلومات، انطلاقًا حقيقيًا. رغم أن أوروبا انتبهت لخطر الترابط المُسلّح خلال إدارة ترامب الأولى، إلا أنها سرعان ما عادت إلى غفوتها.
تعكس نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي أيضًا ظروفه الفريدة: فهو يعتمد على راعٍ عسكري خارجي. فقد زاد الغزو الروسي لأوكرانيا من اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة على المدى القصير، حتى في الوقت الذي تُكافح فيه الدول الأوروبية لتعزيز قدراتها الدفاعية. وأضفت إدارة بايدن لمسة ودية على الإكراه الاقتصادي، بالتنسيق مع حكومات أوروبية مثل هولندا للحد من صادرات معدات ASML إلى الصين. في الوقت نفسه، زودت الولايات المتحدة أوروبا بالمعلومات الاستخباراتية التفصيلية التي تحتاجها لفرض عقوبات مالية وضوابط تصديرية على روسيا، مما يُغني أوروبا عن الحاجة إلى تطوير قدراتها الخاصة.
يزداد تراخي أوروبا بسبب الانقسامات الداخلية. فعندما فرضت الصين سلسلة من قيود التصدير على ليتوانيا لمعاقبتها على دعمها السياسي لتايوان عام 2021، ضغطت الشركات الألمانية على الحكومة الليتوانية لتهدئة الموقف. مرارًا وتكرارًا، تعرقل الشركات الأوروبية، التي تسعى جاهدةً للحفاظ على وصولها إلى الأسواق الصينية، ردّ أوروبا على تهديد القمع الاقتصادي الصيني. في الوقت نفسه، تُخفّف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا من وطأة التدابير الرامية إلى تعزيز الأمن الاقتصادي، أو تُقيّدها البعثات التجارية إلى بكين، المليئة بكبار المسؤولين الراغبين في عقد الصفقات.
يؤدي هذا إلى رد فعل عنيف من الحلفاء، ومن المحاكم الأميركية أيضًا. حذّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مؤخرًا من أن "الولايات المتحدة بدأت تُحوّل هيمنتها إلى مصدر دخل". ربما تُعيد المحاكم الفيدرالية الأميركية، التي لطالما أبدت تحفظًا مفرطًا تجاه السلطة التنفيذية فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي، النظر في قرارها. في مايو/أيار، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأميركية قرارًا لافتًا، قضت فيه بأن الولايات المتحدة تجاوزت سلطتها عندما استندت إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية - وهو الأساس القانوني لكثير من السلطة القسرية الأميركية - لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك. وقد طُعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية، لكن من المرجح أن يكون هذا الحكم مجرد بداية لسلسلة طعون. والجدير بالذكر أن قضية التجارة نتجت عن شكوى رفعها محامون محافظون وليبراليون.
إن هجوم إدارة ترامب على مؤسسات الدولة يُضعف المصادر المادية للقوة الأميركية. ففي القطاعات الأساسية - المالية والتكنولوجيا والطاقة - تُقلل الإدارة من مركزية الولايات المتحدة عما كانت عليه في السابق. يُشجع ترامب وحلفاؤه بقوة العملات المشفرة، التي تُعتبر أكثر غموضًا وأقل خضوعًا للمساءلة من الدولار الأميركي التقليدي، ويتخلون عن إجراءات الإنفاذ ضد منصات العملات المشفرة التي تُمكّن من التهرب من العقوبات وغسل الأموال. في أبريل، رفعت الحكومة الأميركية العقوبات المفروضة على "تورنادو كاش"، وهي خدمة غسلت مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة المسروقة لصالح كوريا الشمالية، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية. كما أن الشغف الأميركي الحزبي بالعملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة، يدفع الصين وأوروبا إلى تسريع جهودهما لتطوير أنظمة دفع بديلة.
انقلب الترابط الاقتصادي ضد الولايات المتحدة
في بعض الحالات، عكست إدارة ترامب سياسات بايدن وعززت نشر التكنولوجيا التي كانت خاضعة للرقابة سابقًا. في صفقة لافتة مع الإمارات وافقت إدارة ترامب على تسهيل التوسع الهائل لمراكز البيانات في المنطقة باستخدام أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة، على الرغم من استمرار العلاقات بين الإمارات والصين وتحذيرات خبراء السياسة من أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تعتمد على الشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومؤخرًا، يُسلم مشروع قانون الإنفاق الذي أقره ترامب وحلفاؤه في الكونغرس في وقت سابق من هذا الصيف السيطرة على تكنولوجيا الطاقة من الجيل التالي للصين من خلال مضاعفة جهودها في اقتصاد الكربون. وبينما تعمل واشنطن على مواجهة النفوذ الصيني على المعادن الأساسية، فإنها تُلغي التدابير الرامية إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الصينية في المجالات الحيوية للطاقة المتجددة وتطوير البطاريات، وتُقلص تمويل استثماراتها في العلوم بشكل جذري. والنتيجة هي أن الولايات المتحدة ستواجه خيارًا صعبًا بين الاعتماد على تكنولوجيا الطاقة الصينية أو بذل قصارى جهدها للاكتفاء بتقنيات عصور سابقة.
ربما كان من المتوقع أن تستجيب الولايات المتحدة لعصر الترابط المُسلّح كما استجابت لعصر الانتشار النووي السابق: بإعادة ضبط استراتيجيتها طويلة المدى، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لوضع سياسات فعّالة، وتعزيز مكانتها العالمية. لكنها بدل ذلك تُراهن على إبرام صفقات قصيرة الأجل، وتُقوّض القدرة المؤسسية على تحليل المعلومات وتنسيق السياسات، وتُسمّم المراكز الاقتصادية والتكنولوجية التي لا تزال تسيطر عليها. وهذا لا يؤثر فقط على قدرة واشنطن على إكراه الآخرين؛ بل يُقوّض أيضاً جاذبية المنصات الاقتصادية الأميركية الرئيسة. لطالما استغلّ استخدام الترابط المُسلّح مزايا "المنظومة الأميركية": مجموعة العلاقات المؤسسية والتكنولوجية المُعزّزة بعضها لبعض والتي جذبت الآخرين إلى فلك الولايات المتحدة. عند استخدامها بحكمة، تطوّر التسليح ببطء وضمن حدود يُمكن للآخرين تحمّلها.
أما الآن، فالولايات المتحدة تتجه نحو استنزاف سريع وغير مُتحكّم فيه لأصولها، سعياً وراء أهداف قصيرة المدى على حساب الأهداف طويلة المدى. إنها تستخدم أدواتها بشكل متزايد بطريقة عشوائية تُفضي إلى سوء تقدير وعواقب غير متوقعة. وهي تفعل ذلك في عالم لا تُطوّر فيه الدول الأخرى قدراتها الخاصة لمعاقبة الولايات المتحدة فحسب، بل تُطوّر أيضًا مجموعات تكنولوجية قد تكون أكثر جاذبية للعالم من تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة. إذا قفزت الصين إلى الأمام في تكنولوجيا الطاقة، وهو ما يبدو مرجحًا، فستُجرّ دول أخرى إلى فلكها. ستبدو التحذيرات الأميركية المُبهمة بشأن مخاطر الاعتماد على الصين جوفاءً للدول التي تُدرك تمام الإدراك مدى استعداد الولايات المتحدة لتسليح الترابط فيما بينها لأغراضها الأنانية.
حان وقت إعادة البناء
في العقود الأولى من العصر النووي، واجه صانعو السياسات الأميركيون حالةً من عدم اليقين الهائل بشأن كيفية تحقيق الاستقرار والسلام. دفعهم ذلك إلى القيام باستثمارات كبيرة في المؤسسات والمبادئ الاستراتيجية التي يمكن أن تمنع سيناريوهات الكابوس. واشنطن، التي تدخل الآن لحظةً مماثلة في عصر الترابط المُسلّح، تجد نفسها في وضعٍ حرجٍ للغاية.
تُدرك الإدارة الأميركية الحالية أن الولايات المتحدة ليست قادرةً فقط على استغلال نقاط الضعف الاقتصادية للآخرين، بل هي نفسها أيضًا ضعيفةٌ للغاية. ومع ذلك، فإن معالجة هذه المشاكل تتطلب من الإدارة التصرف عكس غرائز ترامب العميقة.
المشكلة الرئيسة هي أنه مع اندماج الأمن القومي والسياسة الاقتصادية، يتعين على الحكومات التعامل مع ظواهر معقدة للغاية خارجة عن سيطرتها: سلاسل التوريد العالمية، والتدفقات المالية الدولية، والأنظمة التكنولوجية الناشئة. ركزت المبادئ النووية على التنبؤ بردود فعل خصمٍ واحد؛ اليوم، حيث تُشكّل الجغرافيا السياسية إلى حد كبير من خلال الترابط المُسلّح، يتعين على الحكومات خوض غمار بيئة تضم عددًا أكبر من اللاعبين، وإيجاد سبل لإعادة توجيه سلاسل توريد القطاع الخاص في اتجاهات لا تُلحق الضرر بها، مع توقع ردود فعل العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
إن تمكين الولايات المتحدة من الحفاظ على مكانتها في عصر الترابط المُسلّح يتطلب أكثر من مجرد وقف التفكك السريع وغير المُجدول للهياكل البيروقراطية التي تُقيد صنع السياسات العشوائية والتصرفات الذاتية. تتطلب الاستراتيجية الناجحة في عصر الترابط المُسلّح بناء هذه المؤسسات ذاتها لجعلها أكثر مرونة وقدرة على تطوير الخبرة العميقة اللازمة لفهم عالم بالغ التعقيد، حيث يُسيطر خصوم واشنطن الآن على العديد من أوراق اللعبة. قد يكون هذا أمرًا صعبًا على نظام سياسي أصبح ينظر إلى الخبرة على أنها كلمة بذيئة، ولكنه ضروري للغاية للحفاظ على المصلحة الوطنية.
بنت الصين جهازًا بيروقراطيًا لتحويل نقاط الاختناق إلى نفوذ عملي. ركزت واشنطن على التفكير في أفضل السبل لاستخدام هذه الأسلحة أكثر من التركيز على متى يجب عدم استخدامها. أبدت دول أخرى استعدادها للاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية والمالية الأميركية على الرغم من المخاطر، لأنها اعتبرت الولايات المتحدة حكومةً مقيدة بمصالحها الذاتية، إلى حد ما على الأقل، بسيادة القانون واستعدادها لمراعاة مصالح حلفائها. لقد تغيرت هذه الحسابات، على الأرجح بشكل لا رجعة فيه، حيث أوضحت إدارة ترامب الثانية أنها تنظر إلى الدول التي كانت الولايات المتحدة الأقرب إليها تاريخيًا على أنها دول تابعة أكثر منها حليفة.
بدون حدود واضحة وقابلة للتنفيذ على الإكراه الأميركي، ستجد الشركات متعددة الجنسيات الأكثر هيمنة ومقرها الولايات المتحدة، مثل جوجل وجيه بي مورغان، نفسها محاصرة في أرض حرام في منطقة حرب جديدة، وتتلقى نيرانًا قادمة من جميع الجهات. بينما تعمل الدول على عزل نفسها عن الإكراه الأميركي (والبنية التحتية الأميركية)، تشهد الأسواق العالمية تشرذمًا وتصدعًا عميقين. وقد حذّر وزير الخزانة السابق لاري سمرز من "قبول متزايد للتشرذم" في الاقتصاد العالمي، و"ربما الأمر الأكثر إثارة للقلق هو شعور متزايد بأن اقتصادنا قد لا يكون أفضل اقتصاد يمكن الارتباط به".
وهذا بدوره يوحي بدرس أعمق. لقد استفادت الولايات المتحدة من قدرتها على استغلال الترابط كسلاح على مدى ربع القرن الماضي. وتمتعت بمزايا اقتصاد دولي قائم على مؤسسات متعددة الأطراف ونظام تكنولوجي مبني على صورتها الذاتية كقوة ليبرالية، حتى مع تصرفها بطرق أحادية الجانب، وأحيانًا غير ليبرالية، لتأمين مصالحها كما تراه مناسبًا. قبل عام واحد فقط، كان بعض المثقفين وصانعي السياسات الأميركيين يأملون في أن يستمر هذا النظام إلى أجل غير مسمى، بحيث تستمر القوة القسرية الأميركية الأحادية الجانب والقيم الليبرالية جنبًا إلى جنب.
يبدو هذا الآن مستبعدًا للغاية. تواجه الولايات المتحدة خيارًا: عالم يعزز فيه الإكراه الأميركي العدواني وتراجع الهيمنة الأميركية بعضهما البعض أو عالم تعيد فيه واشنطن تنظيم نفسها مع الدول الأخرى ذات العقلية الليبرالية من خلال التخلي عن إساءة استخدام سلطاتها الأحادية. منذ وقت ليس ببعيد، كان المسؤولون الأميركيون والعديد من المثقفين ينظرون إلى عصر الترابط المسلح وعصر الهيمنة الأميركية على أنهما شيء واحد. تبدو هذه الافتراضات الآن بالية، حيث تحصل دول أخرى على هذه الأسلحة أيضًا. وكما كان الحال في العصر النووي، تحتاج الولايات المتحدة إلى الابتعاد عن الأحادية، نحو الانفراج والحد من التسلح، وربما على المدى الطويل جدًا، نحو إعادة بناء اقتصاد عالمي مترابط على أسس أكثر متانة. إن الفشل في القيام بذلك سيعرض كل من الأمن الأميركي والازدهار الأميركي للخطر.