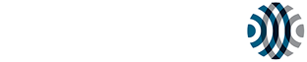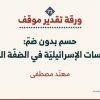تسعى هذه الورقة إلى إجراء تقييم لواقع الانتخابات العراقية، ودلالاتها بالنسبة إلى مستقبل الأوضاع السياسية في العراق، والسيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. ولكنها ستعرض قبل ذلك لطبيعة الظروف التي ألت اليها الأمور قبل الانتخابات. وتشمل السياق السياسي، الفاعلين الرئيسيين، التحديات، والمعطيات التي ربما تؤثّر في النتائج. مع تحليل تفصيليّ بحسب كلّ إقليم (شيعة، سُنّة، كرد).
يقف العراق اليوم على عتبة الانتخابات التاسعة عموما منذ تغيير نظامه في 2003، وهي أيضا تمثل الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخه، في شهر تشرين الثاني من العام الجاري 2025.
ان أولى المواقف التي نستطيع ان نثبتها هنا هي ان التغيرات السياسية والأمنية ومستوى وعي المواطن العراقي المتصاعد بالنظام السياسي والانتخابات بشكل خاص انعكس على نتائج الانتخابات ونسب المشاركة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية إلا أن الكتل السياسية الكبيرة استطاعت المحافظة على قاعدة انتخابية تمكنها من الوصول إلى صناعة القرار في الحكومة العراقية مما زاد الوسط السياسي تعقيدا ورفع مستوى المنافسة بين الأحزاب السياسية. ومن المؤسف أن القوانين المتعلقة بالانتخابات في العراق لا تطبق بكل حذافيرها او انها تعدل في كل مرة مما لا يضمن استقرارا عمليا على المستوى الطويل، لأن في العراق دائما الاتفاقيات السياسية هي أعلى من القانون ومن الدستور، وهذه معضلة كبيرة تواجه الديموقراطية في العراق. وفي هذا المجال لدينا مواد مهمة في قانون الانتخابات الجديد يجب ان نعالجها بتفصيل أكثر، وهي المواد المتعلقة بالأحزاب السياسية الذي يحتوي على فقرات غير مطبقة الآن، حيث تطرقت هذه الفقرات إلى مواضيع مثل إئتلاف الأحزاب واندماجها بشكل بسيط ومبهم وغير واضح. وهو ما يعطي المفوضية الامكانية لإصدار أنظمة جديدة حول تسجيل الكيانات وتسجيل الناخبين والمرشحين وشكاوى الطعون الانتخابية لأن قانون الانتخابات لا يفصلها بالشكل المطلوب. وعندما نذهب للفصل السابع في قانون الانتخابات الجديد نرى أنه لا يجوز استخدام أموال ومؤسسات وسيارات الدولة والأوقاف الدينية في الدعاية الانتخابية، ولكن هذا يحصل في كل انتخابات بدون عقوبات وبدون تحميل المسؤولية لأي طرف. لذلك لا يجب ان تجلس الهيئة التشريعية لوحدها لصياغة القانون، ويجب على جمع الشركاء معاً عند صياغة القوانين، السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين وحتى وسائل الإعلام.
طيب ما حيثيات القانون الجديد؟
صوت مجلس النواب العراقي على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، بعد جدل استمر أسابيع بين الكتل والأحزاب السياسية.
وجاء التعديل الجديد معتمدا على تعديل قانون انتخابات عام 2018، بما يعني إلغاء جميع مواد قانون رقم 9 لعام 2020، والعودة لاعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة عراقية، مع اعتماد صيغة سانت ليغو النسبية بمعيار 1.7 وعودة انتخاب مهجري الخارج، فضلا عن اعتماد التعديل الجديد ليكون ساريا على انتخابات مجلس النواب والانتخابات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وأقر التعديل الجديد الاعتماد على نظام القائمة المفتوحة -وليس الترشيح الفردي- وهو ما يراه مراقبون ونواب برلمانيون مستقلون أنه يمثل تكريسا لهيمنة زعماء القوائم ورؤساء الكتل على مخرجات ونتائج هذه الانتخابات، فضلا عن أن العودة لصيغة سانت ليغو بمعيار 1.7 في توزيع المقاعد على القوائم يعني إغلاق الطريق أمام صعود الأحزاب الناشئة والشخصيات المستقلة الفردية، بما يعني إعادة إنتاج الأحزاب والقوى المهيمنة على المشهد السياسي ذاتها، وفق مراقبين.
في حين يرى المؤيدون للتعديل الجديد أنه يضمن توزيعا عادلا للأصوات الانتخابية، فضلا عن الحفاظ على أصوات الناخبين ومنع التلاعب بها من خلال الاعتماد على الفرز اليدوي للنتائج، وعدم تكرار ما حصل في انتخابات عام 2021 التي اتهمتها عديد من الأحزاب بالتزوير.
الخلفية والمجريات الأساسية:
تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من 310 حزباً وجماعة سياسية مسجّلة للمشاركة، ما يعكس درجة عالية من التعدّدية السياسية لكن هذا يدلل أيضاً على ان فُرَص الانقسام أكبر. فالمشهد يدور في ظل نظام تقاسم طائفي/عرقي، فيه الشيعة، والسنة، والكرد كلٌّ له موقعه، لكن أيضاً فيه تغيّرات ملحوظة في التحالفات.
الفاعلون الرئيسيون والتحالفات:
أولا: على الجانب الشيعي: هناك تحالف الإطار التنسيق الشيعي (Coordination Framework) الذي يضمّ عدة قوى، لكنّ هناك انقسامات داخلية وتحركات لإعادة تشكيل التحالفات ولكن وفق تصورات جديدة وما تفرزه حصيلة الانتخابات القادمة.
ثانيا: أيضاً هناك محمد شياع السوداني (رئيس الوزراء) حيث يقود تحالفاً يُعرف بـ ائتلاف reconstruction and development (إعادة الإعمار والتنمية) سعياً لتثبيت موقعه السياسي.
ثالثا: على الجانب الكردي: القوتان الرئيسيتان هما الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) وهما يركّزان على الواقع الكردي لكن تأثيرهما يمتدّ أيضاً إلى بغداد عبر مقاعد يتم تحصيلها.
رابعا: على الجانب السُنّي: هناك تحركات جديدة وتحالفات تحاول كسب أرضية في المناطق الغربية والوسطى.
خامسا: الحركات المدنية/الإصلاحية: رغم الوعود، لا تزال تكافح لتشكيل تحالف موحّد يُعدّ خصماً جدياً للنّخب التقليدية.
التحديات والمعيقات البارزة:
1-الإقبال الانتخابي المنخفض: هناك توقعات بأن نسبة المشاركة قد تنخفض تحت 35٪ نتيجة شعور واسع بالخيبة من النظام السياسي وهذا الامر صرحت به بعض مراكز استطلاعات الراي وكذلك بناء على موقف التيار الصدري المقاطع للانتخابات وهو المعروف بثقله الجماهيري.
2-التمويل والمال السياسي: فالحملات الانتخابية تشهد إنفاقاً ضخماً، واستغلال المال والموارد يؤدي إلى تهمّ بالفساد والتأثير غير العادل وهذه الأمور أصبحت واضحة للعلن من دون وقفة جادة لإيقافها.
3-التحالفات ما بعد الانتخابات: وهذه واحدة من المعضلات التي تواجه الانتخابات قبلها وبعدها حتى من يفوز بالحصول على عدد كبير من المقاعد، غالباً ما يتطلب الأمر مفاوضات وتحالفات لتشكيل حكومة الأمر الذي يقلّل من الربط المباشر بين الأصوات والسلطة التنفيذية.
4-اقتصاد هشّ وأزمات خدمية: العراق يعاني من اعتماد كبير على النفط، ضعف في المؤسسات، وتأخير في تنفيذ الميزانية، مما قد يزيد من غضب الناخبين أو يعقّد الاستقرار بعد الانتخابات.
5-الطائفية والهيمنة الحزبية: رغم بعض التغيّرات، ما زالت السلطة موزّعة طبقاً للطائفة ، والتحالفات قد تتغيّر، لكن البنية الأساسية متماسكة نسبياً.
6-الدور الكبير والفاعل والمؤثر على الانتخابات هو التأثير الخارجي والمتثل بالدرجة الأساس في سيطرة أمريكا على القرار السياسي والاقتصادي العراقي ناهيك عن قوى دولية اخرى.
ما الذي نتابعه عن كثب؟
ا- ما هي نسبة المشاركة الفعلية؟ إقبال منخفض سيزيد من شرعية النخب التقليدية ويقلّل من قدر تغيّر النظام.
ب-إلى أيّ مدى ستتمكّن القوى المدنية والإصلاحية من كسب مقاعد أو دفع النظام باتجاه تغيير فعلي؟
ج- كيف ستكون حركة الكرد والتحالفات الخاصة بهم: هل سيدخلون الحكومة أو في المعارضة؟
د- ما سيحصل عليه تحالف السوداني /أو الإطار الشيعي من مقاعد ومن ثم: من سيشكّل الحكومة؟
ه- هل ستكون هناك مفاجآت من حيث التحالفات أو التحوّلات بعد الانتخابات؟
ز- كيف ستتعامل الحكومة المقبلة مع التحديات الاقتصادية والخدمية وهل ستطرح إصلاحات حقيقية أم استمرار للأوضاع الحالية؟
سيناريوهات محتملة (مختصرة)
سيناريو الاستقرار النسبي: فوز حليف/ائتلاف يدعم السوداني أو يسعى لاستقرار تقنيّ؛ حكومة تمرّ بإصلاحات جزئية وتركّز على الخدمات.
سيناريو الانقسام والتحالفات الصعبة: تشتت المقاعد يؤدي لحكومة ضعيفة أو مفاوضات مطوّلة؛ فترة انتقالية يعقبها توتر سياسي.
سيناريو مفاجأة مدنية: اختراق محدود للحركات المدنية في محافظات حضرية تأثير رمزي لكن غير كافٍ لتغيير نظام التحالفات.
ولكن ماذا يعني هذا للمشهد الإعلامي والقنوات السياسية كتوصيف عملي:
1. فرص للرقابة والمساءلة: فترات الحملة تُعدّ فرصة للبرامج التحقيقية والمتابعات الخدمية لاستهداف موضوعات الفساد والخدمات. استغلال هذه الفرصة يتطلب وسائل اعلام ممنهجة ومستقلة.
2. تصاعد خطاب الهجوم والـ"Smear": تزايد التسريبات والتشهير الإلكتروني سيجبر القنوات على التعامل مع الأخبار المضللة والتحقق أمام الجمهور. يجب تعزيز وحدات التحقق داخل المحطات.
3. التغطية الإقليمية والموضوعات الخارجية: بدون شك سيكون التركيز على قضايا التوازن الإقليمي، وجود الحشد الشعبي والعلاقات مع إيران ومع تركيا والعلاقات الخارجية ستبقى محوريّة في النقاش التلفزيوني. على المحطات تحديد خطوط تحريرية واضحة لتفادي التضخيم.
4. مخاطر الاستقطاب الطائفي: المحتوى الإعلامي الذي يعيد إنتاج الخطاب الطائفي قد يزيد الانقسام؛ على الإعلام العملي تبني محتوى يبني الثقة ويعرض حلولاً خدمية.
5.
وأخيرا فان أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق يمكن ايجازها بالتالي:
1. ضعف الثقة العامة والمشاركة المنخفضة
وفقاً لاستطلاع حديث، فقط حوالي 31% من الناخبين المؤهلين قالوا إنهم ينوون المشاركة في الانتخابات.
الكثير من العراقيين يرون أن الانتخابات السابقة لم تُحدث تغيّراً جوهرياً، ما يزيد الإحساس بأن التصويت ليس له تأثير حقيقي.
ضعف الحماس قد يؤدي إلى إقبال منخفض، وهذا يقوّض شرعية العملية الانتخابية ويُضعف المراقبة الشعبية.
2. القوانين الانتخابية وتركيبة الدوائر ونظام التمثيل
النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية محلّ جدل: مثلاً، إعادة اعتماد نظام “كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة” يُنظر إليه على أنه يقلّل تمثيل بعض المناطق مثل إقليم كردستان العراق.
استخدام طريقة حساب المقاعد (مثل طريقة سانت‐ليجو المعدّلة) يُنظر إليه من بعض المحلّلين على أنه يُعقّد دخول القوائم الصغيرة والمستقلّين.
هذه التحديات القانونية تؤثّر على الشفافية والعدالة في التمثيل، وتفتح الباب أمام مزاعم بأن النظام مُصمَّم لخدمة القوى القائمة.
3. التأثير الأمني والمخاطر اللوجستية
رغم تحسّن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، لكن لا تزال هناك تهديدات أمنية أو لوجستية قد تعرقل سير الانتخابات أو تؤثر على مشاركة الناخبين.
من المسائل اللوجستية: تحديث سجلات الناخبين، تجهيز المراكز، الطباعة الآمنة للأوراق، وجود تقنيات تحقق موثوقة كلها عوامل تشكّل ضغطاً على هيئة الانتخابات.
4. التداخل بين القوى السياسية – الطائفية – الإقليمية
النظام السياسي العراقي ما زال يتأثر بالانقسامات الطائفية/المذهبية والإثنية، مما يخلق أجواء منافسة مبنية على الهوية أكثر من البرامج والسياسات.
كذلك توجد تأثيرات إقليمية سلطات داخلية وخارجية قد تُدخل الانتخابات ضمن سياقات صراعية أكبر، ما يضعف التركيز على القضايا التنموية الجوهرية.
5. ضعف الإصلاحات والمطالب الشعبية المتراكمة
مطالب الإصلاح متراكمة: البطالة، ضعف الخدمات، الفساد. عدم معالجة هذه القضايا يجعل الانتخابات تبدو “مظهرية”.
عندما لا يرى المواطنون أن التمثيل يُترجَم إلى تحسين فعلي، فإن ذلك يزيد من السخط ويضعف الدافع للمشاركة.
6. المعلومات المضلّلة والإعلام والدعاية
الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب ضعف قدرات التحقق الإعلامي، يعني أن المعلومات الخاطئة أو الدعائية قد تكون واسعة الانتشار.
هذا الأمر يُضعف من شفافية العملية الانتخابية ويجعل الناخب في موقف شكّ أو التباس، ما قد يؤثّر على نَزاهة التصويت.
7. التمثيل الجماعي للمناطق والأقليات
مناطق مثل إقليم كردستان تشكو من أن النظام الانتخابي لا يعكس تمثيلاً عادلاً لهم في البرلمان.
هذا التحدي يستهدف ليس فقط الاحساس بعدم المساواة بل أيضاً الشرعية الكاملة للعملية الانتخابية على مستوى كلّ الوطن.
8-الدور الأمريكي والقوى الدولية الأخرى التي تعد من ابرز القضايا التي سيكون لها الأثر البالغ في الانتخابات القادمة.